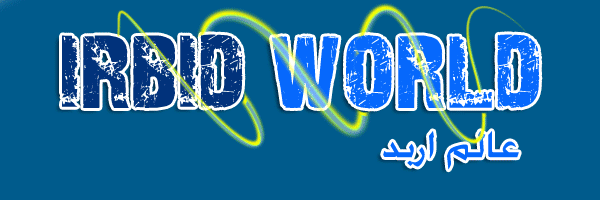الصحافة البريطانية تصدر مؤخرا نبأ مفاده أنّ السلطة التعليمية في بريطانيا ستعلن في الإبان عن إجراءات لوضع حدّ لهيمنة البيروقراطية على التعليم في هذا البلد ولتصحيح المعادلة بين "الإلهام" (لدى المعلم) و "التفقد" (1). وبعد أسبوع من إذاعة الخبر تمّ نشر فحوى الفكرة الجديدة، وهي ما صار يُعرف الآن بـ"بادرة المدرسة (الحكومية) الحرّة"، والتي سيقع الشروع في تنفيذها في العام المقبل (2011-2012).
وتتميز بادرة المدرسة الحرة بعنصرين هامين على الأقل: مستوى معياري رفيع ونظام تأديبي حازم. لكن الملفت للانتباه أنّ مناهضي البادرة من البريطانيين يتعللون بأنّ ما هي إلاّ نقلٌ عن مبادرة نجحت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أنجزها بتفوق باهر المربي جوفري كندا في حي "هارلم" الشهير(بالفقر والحرمان والجريمة) بمدينة نيويورك (2).
لقد انشرح صدري مرتين، واحدة في البدء لمّا سُررتُ بالخبر المزدوج وتمنيتُ لو وقع اتخاذ خطوة مماثلة في بلدي وفي البلاد العربية والإسلامية قاطبة، وذلك لأنّ مدرستنا في أمسّ الحاجة إلى رجّة مماثلة أو أقوى منها. ولم يكن سبب الغبطة التي داهمتني أنّ بريطانيا أو أمريكا تتفوقان علينا في كل الميادين أو لأنّ كليهما تعدّ من الطلائع في التجديد التربوي والتعليمي. طبعا لم يعُد ذلك أبدا مدعاة للدهشة والانبهار.
ولكن يبدو أنّ ذلك الاعتياد على الانبهار بالغرب وبإنجازاته قد بلغ بنا الذروة إلى حدّ أنه بعث فينا نوعا من الاستشعار بأنّ الانبهار قد يكون ناتجا عن تفخيم وتضخيم النجاح الغربي بالتناسب مع فشلنا، أكثر من أن يكون ناتجا عن صواب القرار لديهم . وبالتالي كان سبب انشراح صدري ثانية، وتفتح عقلي معه، إحساس جميل، مشفوع بإدراك عميق بأنّ ساعة استعادة الثقة في أنفسنا قد آن أوانها.
وأعتقد فعلا أنّ فكرة المدرسة الحرة، المكوّنة للشخصية المستنيرة والمنضبطة، والمُعدّة لرجال ونساء المستقبل قد تلقى حظوة في التنفيذ في ربوعنا أكثر ممّا لاقته في "هارلم" أو ما ستلقاه قريبا في بريطانيا. لماذا، لأنّ الفكرة ولدت في حقبة تعرف فيها المدرسة في العالم بأسره تراجعا مُخيفا. ولأنّ السبب الرئيس في تدهور التعليم عالميا مردّه انتهاك حرمة الركيزة رقم واحد في أية منظومة تعليمية يزعم أصحابها أنها ناجحة: المعلّم. وأخيرا لأنّ انحطاط وضع المعلم في ربوعنا بلغ شوطا من الرداءة سيجيء بعده إمّا الانحطاط الاجتماعي الشامل (وهذا ما ليس من شيمنا أن لا نبالي به) وإمّا الاستفاقة والخلاص، وهو الذي يؤمن به كل عربي ومسلم بالفطرة بالرغم من أننا معوزون في مجال التدريب عليه.
تلك مفارقة قد يكمن السر في تشكلها في ما يلي: إنّ الدولة في البلاد المتقدمة ذات الديانات أحادية البُعد (الروحي) على غرار المسيحية ( وأغلبية الشعوب المتقدمة هُم من المسيحيين) قد استوفت صلاحياتها كمُعلم للشعب. علما وأنّ الدولة في الغرب عموما وفي البلدان التابعة لها فلسفيا وإيديولوجيا بما فيها البلاد العربية والإسلامية، قد شرعت في الاضطلاع بتلك المهمة بدلا عن المعلّم (الذي صار مُنفذا لسياستها لا غير) منذ إقرار مبدأ تفريق الدين والدولة.
إنّ تفريق الدين والدولة لاءم المجتمع الغربي وأتباعه من ذوي الديانات أحادية البُعد دون سواها من المجتمعات الإسلامية، لأنّ لم يكن لدى تلك الفئة الأولى ما تخسره من الدين طالما أنّ دينها بطبيعته لا يهتمّ بالدنيا وبالتالي بالسياسة وبالدولة. كانت هي الرابحة من الفصل بين الكنيسة والدولة وما صاحبه من رد اعتبار للعقل والعقلانية بفعل التنوير.
بينما لعب تفريق الدين والدولة عند المسلمين دورا غير مرتقب. ويتمثل هذا الدور التعيس في تحويل الفصل، من فصل بين الدين والدولة، إلى فصل بين الدين والمجتمع؛ وهذا مرض والعياذ بالله.
وقد لعب هذا الخلط الناجم عن التبعية السياسية والفكرية والثقافية إلى مزج بين المشكلة والحل. فعوضا عن انكباب النخب المثقفة عندنا على كيفية استرداد المعاني الأصلية للوظائف والأدوار باعتبار الفروق بين أصول الفكر هنا(الفكر الديني الإنساني عند المسلمين) وأصول التفكير هناك ( العقل المجرّد عند الغرب) لكي يفهم أولئك وهؤلاء أنّ الفصل بين الدين والدولة إنما هو قاسم مشترك بين كل الثقافات المعاصرة، راحت نخبنا تمارس فصلا هجينا وخطيرا، لا بين الدين والدولة (السياسة) لكن بين الدين والمجتمع، كما أشرنا، ظنا منها أنها تضمن بهذه الطريقة للمجتمع المسلم سبلا للتحصيل على العلوم والمعارف تضاهي السبل ("العقلانية") التي كانت أوصلت المجتمعات الأوروبية إلى أوج التقدم والارتقاء. بينما لم تكن تدري أنها بتلك الطريقة قد فصلت مجتمعاتها عن أصول العقل لديهم، و هي أصول مجبولة على الاختلاط بالدين، دين العقل: الإسلام.
وبالرغم من أنّ الدولة والمجتمع عندنا ما زالا يعانيان من تداعيات هذا الصنف من الجهل التاريخي، إلاّ أنّ الدولة والمجتمع في الغرب قد يكونا شرعا فيالنكوصالعقلاني. وهذا يعني أنهم قد يكونوا ذهبوا ضحية عقلانيتهم. علما وأنّ الغرب المتقدم لم يعد يُخفي انتماءه الديني كما كان يفعل بكل أريَحية في بداية استنارته. والدليل أنهم صاروا يعلنون الحروب باسم الدين (في أفغانستان و في العراق وفي ربوع أخرى). وهذه بحد ذاتها حجة على انحسار العقل مقابل تنامي النزعة الدينية لديهم. والنتيجة أنهم اليوم فقط يتمتعون ببقايا "العقل الكلي" الذي تنبأ بفوزه الساحق وبتماهيه مع الدولة الفيلسوف الألماني هيجل . وهو فوز تمّ الإعلان عنه في بداية التسعينات من القرن الماضي على لسان المفكر الأمريكي فرنسيس فوكوياما في تقريره الشهير عن "نهاية التاريخ"، والذي تجسد على أرض الواقع بما يسمى بالتحولات الديمقراطية في أوروبا الشرقية أنذاك.
هكذا يمكن أن ندرك أنّ إقرار الفلسفة الغربية بمقولات مثل العقل الكلي وبلوغ الدولة أوج عطائها وما أسفر عن ذلك من "إنهاء" للتاريخ ومن تحولات عميقة، لم يكن إيمانا اعتباطيا أو وليد الصدفة أو من باب الكيد للمسلمين أو التآمر عليهم. بل كان تواصلا منطقيا لفكرة "موت الرب" للفيلسوف الألماني نيتشه. لقد "مات الرب" عندهم فكانت الدولة هي البديل المستحدث لذلك الرب.
وقد استمرّ "موت الرب" إلى بداية التسعينات من القرن الماضي حين أعلن الرئيس بوش الأب – باسم الرب - حرب بلاده الأولى على العراق (في سنة 1991). ونخلص بالقول إنّ الرب أبى إلاّ أن يستفيق وينبعث من جديد. وهذه حجة مضادة للفيلسوف نيتشه ولكل من يقتل الرب؛ إذ ثبت أنّ الرب لا يُقتل.
والسؤال إذن في ضوء ما تقدم ليس أن نعرف مَن أو ماذا سيكون البديل عن "الرب" عند الغرب أو ماذا عساهم فاعلون بالرب القائم (قيامة فلسفية طبعا). فنحن لا نفكر في مكان الكيان الآخر. لكن في المقابل، من مسئوليات المسلمين اليوم أن يدركوا في مرحلة أولى، بكل علم ومنهجية وبمنأى عن الإسلاموية، أنّ موت الرب عند الغرب وتعويضه بالدولة إنما هو الشرك عندنا. ثمّ تأتي في مرحلة تالية مسئولية التفكير في إنقاذ العالم من براثن بدلاء "الرب" وكذلك، وبالخصوص، إنقاذه ممّا نحن شاهدون عليه اليوم من عمل هدام ("فوضى خلاقة" تحولت إلى "فوضى هدامة") باسم الرب القائم.
وأوّل ما يتبادر للذهن في هذا المضمار إحياء دور المُعلّم، لا إحياء الربّ. فالربّ عندنا هو الله عز وعلا وهو الحي الذي لا يموت سبحانه. أمّا المعلم فهو واسطة خير، لا بين الله والعباد (لا نداوي الشرك بالشرك) وإنما بين المجتمع والدولة. والغرض من توسّط المُعلم و وسطيته رتق البون الحاصل بين الدين والمجتمع، من أجل تسريح قنوات التواصل بين ضفتي الوعي (الديني والمجتمعي) و تسهيل مرور الأحاسيس والأفكار بينهما حتى يصير للسياسة، في نهاية المطاف، معنى لا يؤاخذ لا على أنه لاديني، ولا على أنه ديني.
ففي وقت نعاينُ فيه موت الحياة المجموعاتية في العالم العربي (والإسلامي ربما) علما وأنها الأس والإطار الملائم لنموّ السلوك الديمقراطي كمقدمة لإرساء النظام السياسي الديمقراطي، لم يعُد للصداقة معنى ولا للأخوة ( الأسرية وفي الدين) إلاّ ما يسمح به الرصيد التواصلي الهزيل والمذبذب الذي تبقى لدينا. إذن فالحل الجذري لإعادة ترتيب البيت لا بدّ أن يوضع بيد المعلّم، رسول التواصل.
لكن ما يحز في النفس ويشكل واحدة من مبطلات هذا العمل اللازم أنّ النخب المثقفة في مجتمعنا الكبير ممّن هم منبهرون من دون روية بالسلوك الكلي للغرب لم يتفطنوا للمغالطة (السيكولوجية والتواصلية) الكبرى: بالرغم من أنّ النصارى قد استحدثوا، كما أسلفتُ، "ربّا" أعلى من الرب في المجال "العقلاني" - وهو الدولة – إلاّ أنهم كانوا وما زالوا، في القرار كما في السلوك، يناجون الرب الحقيقي، كما تبيّن لنا من خلال لجوئهم (بمقتضى النكوص الفلسفي) إلى إحياء الرب وخوض الحروب التي ذكرتُ البعض منها والتي أعلنوها من جهة واحدة ضد المسلمين كما ضد غير المسلمين. لقد كانت هذه الأخيرة حروبا يحركها الإيمان بالرب (الأصلي) وتنفذها أيادي الرب (البديل؛ الدولة). فمتى ستتعظ نخبنا وتدرك أنّ الغرب، بهذه الكيفية، هو الذي يمزج بين الدين والدولة، ولم ينفك أبدا عن هذا الصنيع؟ بل متى ستدرك أنه لا مناص من المزج، وبما أنّ ذلك كذلك، فالأجدر إنجاز المزج بطريقة علمية، أي بمراجعة التصورات المنقولة عن الغرب في ميادين البحث العلمي والبناء المعرفي، وذلك من خلال المنظور التوحيدي للعقيدة الإسلامية.
إنّ تصريف عقيدة التوحيد في العلم وفي المعرفة هو الضامن لإنجاز خلط غير مباشر وتدريجي بين الدين والسياسة، الأمر الذي سينعكس لاحقا بالإيجاب على العلاقة (المحطمة) بين الدين والمجتمع باتجاه الرتق والتوحيد.أمّا ما يقوم به الإسلامويون من إقحام مباشر للعقيدة السمحاء، بوجهها التعبّدي والنسكي تارة وبوجهها الفقهي طورا وبوجهها العاطفي أو حتى الطوبوي والهلامي طورا آخر، فلن يساهم في تلطيف الخلط الصحي والطبيعي بين الدين والسياسة، بل سيفضي إلى تدعيم الموقف الإيديولوجي القاضي بالفصل لدى العلمانيين كما سنرى.
ولئن لم يهتدِ مثقفونا إلى مثل هذا التشخيص فذلك لأنهم كانوا وما زالوا مستلبين لِمثل تلك المغالطات التاريخية والعقدية، ممّا حدا بهم إلى الانقسام في الفكر كما في السياسة إلى إسلاموي رافض للتعصب "الدَّولي" المسيحي (بالأساس) لكنه غير قادر على تكريس مشيئة الله بالوسائل الحياتية الطبيعية (المزج التواصلي والعلمي دين/سياسة ودين/ دولة)، وعلماني رافض لتكريس حياة يكون فيها العباد راضين بربهم الله ومُرْضين له، وفي نفس الوقت مُضيعٍ لِوقته في المجادلة مع الإسلاموي.
إنّ اعتزام إحياء دور المعلم لا يبدأ إذن في المدرسة وإنما في العقول والذهنيات. لماذا، لأنّ العهد الذهبي لـ"الدولة المُعلم" في الغرب كاد يشكك (إن لم نقل شكك)، مثلما شرحتُ أنفا، المسلمين في ربهم. إذ نتجت عن الإقتداء بالدولة "المعلم" من جهة المغالاة بالإيمان (الإسلاموية)، ومن الجهة المقابلة زحزحة الإيمان لدى من يدّعون أنّ العلمانية سبيل النجاة متعللين خطأ بكونها صمام الأمان للإسلام.
ومخاطر العلمانية أشدّ على المسلمين من مخاطر الإلحاد أو الكفر. فبينما الإلحاد والكفر واضحان ولا يشوبهما لبس فضلا عن كونهما ضروريان لاستمرار الإيمان والإسلام، تتبوأ العلمانية أعلى مراتب النفاق. والسبب في ذلك واضح: فهي وليدة النفاق في الخلط بين الأنماط والسلوكيات الذي فسرتُه أعلاه؛ وليدة الفصل بين الدين والمجتمع؛ وليدة الرغبة المصطنعة في الفصل القسري بين ما كانا ممزوجين في الإسلام (الدين والدولة)، عوضا عن مساهمة هذه النخب في بلورة السبل التواصلية والعلمية الرامية إلى إرضاء ضمير المؤمن الراغب في استساغة عقلانية دينية إسلامية تختلف عن العقلانية اللادينية في كونها مكرسة للتوازن بين الروح والمادة، وبالتالي في كونها الحارس الأمين للوسطية.
أمّا مخاطر الإسلاموية فهي زائلة لا محالة بزوال العلمانية. وزوال العلمانية متصل بالتشبث بمنابع الموقف الصحيح، ألا وهو الإيمان بالله ربّا لا يُقهر من طرف دولة تنافسه الربوبية. كما أنّ الإيمان بوحدانية الله تجسيد لاستدامة الدولة في المجتمع العربي الإسلامي كسند دائم للمجتمع. والدولة لا تفنى بل تبقى ذخرا للمجتمع طالما أنها تستقي من معين المُعلّم؛ وهو الذي بدوره يجدد إلهامه من معين المجتمع، الذي يحدد صعود ونزول درجات الإيمان لديه وبالتالي يحدد الرغبة في صياغة الطرق والنماذج العلمية والتواصلية المُرضية لضميره. وهذا هو الرهان الديمقراطي مستقبلا.
أحَوصِلُ وأقول إنّ الديمقراطية الغربية كانت مبنيّة حول نواة "الدولة المعلم" كبديل للرب. لكن ها هو البديل ينسلخ عن هويته الاجتماعية الرئيسة كمُربٍّ وينسحب من ساحة الكفاح التعليمي، ويستوفى شروط النجاح. ولهذا السبب الأساس لم يكن ممكنا أن يأخذ المجتمع المسلم ما بُني على الشرك (الديمقراطية بمقتضى أحكام "الدولة المعلم") كمنوال في شموليته، أعني ببُعد الشرك فيه.
فالديمقراطية لم تسترعِ انتباه و جهود كافة الشرائح في المجتمع المسلم اليوم، وذلك رغم الحماس الفياض الذي اتصفت به النخب فيه. ناهيك أنّ سجية المجتمع بقيت متعلقة من دون رجعة (على ما أعتقد) بالعقلية الأبوية (3)،الأمر الذي شكل المبطلات الأولية للمسار الديمقراطي، لمّا كان هذا المسار مستنسخا عن نموذج "الدولة المعلّم".
وفي المقابل فإنّ أبوية المجتمع المسلم هي واحد من العوامل الإيجابية التي ستساعد هذا الأخير على استساغة الديمقراطية. أولا لأنّ بمجرد أن ندرك أنّ هذه الأخيرة تبقى صالحة لأمة التوحيد شريطة أن يُمحى جانب الشرك فيها، أي لمّا تتخلص الدولة في مجتمعاتنا من لاهوت "الدولة المُعلم" الذي لم يكن في أي وقت من الأوقات متّسقا مع الإرادة الجماعية للأمة، سيرتاح المجتمع لاستعادة الثقة في الأبوية. ومن هنا ينبغي التفكير في تصحيح التصور الديمقراطي في الإسلام (أعني في المجتمع المسلم) وذلك بَدءا ببناء هذا التصور حول نواة المعلّم الأب. لذا أضحى استبدال المعلم الهجين بالمعلم الأصلي، ذاك الذي يقول عنه الأثر إنه كاد أن يكون رسولا، بات ضرورة حياتية.
في نهاية المطاف إنّ المعلم الذي نرغب أن يكون مُنفذا لمناهج التواصل والتربية والتعليم، بصفة تضاهي أو تفوق بكثير أداء مبادرة جوفري كندا بحي "هارلم" و بادرة "المدرسة الحرة" ببريطانيا، هو ذلك المؤمن بالرسالة الجماعية. لهذا السبب ستسمح وضعيته بأن تكون درجات الإيمان الديني لديه متفاوتة، في الكمّ وفي الجودة، من شخص لآخر ومن مجتمع مسلم لآخر.
ولهذا السبب أيضا ليس لإيمان المُعلم الرسول قابلية التقولِب بنموذج سياسي أو إيديولوجي. وذلك مردّه الوحدة المنهجية، إذ إنّ إيمان المعلم برسالة جماعية، على عكس إيمان السياسي، إيمان ناطق باللغة التي يفهمها كل الناس حسب القاعدة المتعارفة "خاطب القوم بِما يفهمون"؛ لغة لا تروم التحجر، لا باسم الدنيا ولا باسم الدين، طالما أنّ لغة المعلم كلام وأنّ الكلام حياة و إسلام.
ولأنّ إيمان السياسي الذي اعتدنا على التعامل معه في ظل "الدولة المعلّم" ناطقٌ بلغة، مع أنها أبوية، لكنها لا تروق لا للمعلم الأب ولا للتلميذ الراغب في النور الأبوي، كم كان بودّ الشباب العربي والمسلم أن لا ينطق السياسي عن الهوى، بل أن يتأكد من اتساق كلامه مع كلام المُعلّم، صاقل العقول الذواقة ومُزوّدِ النفوس التواقة إلى الاختلاف البنّاء، الساند الأساس للتعددية الفكرية والسياسية وللديمقراطية الفعلية.