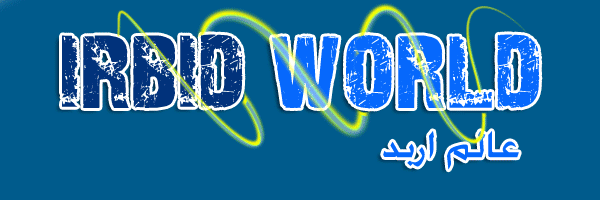عروة الصعاليك.. وأبوهم!: عروة بن الورد
يقسم جسمه في جسوم كثيرة يؤثرها على نفسه، فيوزع نفسه من خلالها، لكنه يحتفظ بقصيدته له وحده، ليصير أبًا للصعاليك كلهم من دون أن تفرط القصيدة في أمومتها الرءوم له.
يمضي في ظمأ الشعر ليحسو قراح الماء والماء بارد، فتنبت على أطراف صوته المجلجل في رهبة الصحراء القوافي، وتتبرعم مع كل غزوة يغزوها أو غنم يغنمه.
يعود، بعد كل غزوة بصحبة سيفه ورمحه فقط، أو بصحبة رفاقه من الصعاليك المحترفين، إلى صعاليكه الهواة، المرضى، الضعفاء، المسنين، الصغار، ليقيم أودهم بما غنم، ويهيئهم لمجدهم المرسوم سلفا في براري الحرية والوحشة والمساواة.
إنه ابن الورد، عروة الصعاليك، وبطلهم الذي عاملهم بأبوة تليق بكرم روحه.. فعاملوه كما يليق بهم.. كل على حدة. فتارة وجد من بينهم من بادله الإحسان بالوفاء، وتارة وجدهم «كما الناس لما أخصبوا وتمولوا». لكنه دائما بقي هو نفسه الكريم الذي نافس حاتم الطائي في مجده المخلد رمزًا لكرم العرب منذ ما قبل الإسلام وحتى الآن.
ومع أنه اكتسب لقبه الخالد عروةً للصعاليك منهم وإليهم، إلا أن البعض لم يكن ليعتبره صعلوكًا حقيقيًا. فلم تنتبذه قبيلته كما فعلت قبائل الصعاليك مع أبنائها المارقين، لكنه اختار الصعلكة بمحض إرادته الحرة، توكيدًا لهذه الإرادة، وترسيخًا لهذه الحرية، فتوحد مع بقية الصعاليك في تحديهم لقيم قبائلهم الظالمة، كما يرونها، وثورتهم على سلطاتها القاسية، وفقا لتقييمهم، ورفضهم لأوامرها أيّا كانت. فكانوا يغيرون على الأغنياء ويوزعون ما يغنمونه منهم على الفقراء، وكان ابن الورد يمعن في ذلك حتى لا يبقى له شيء يوزعه فلا يتورع عن توزيع جسمه.. لو استطاع.
إنه إذن الصعلوك المختلف عن بقية الصعاليك، والذي تشظت سيرته بين سيرهم، وتوزع جسمه عليهم، وبقى اسمه علمًا بينهم يميزه بتلك الصفات التي أعادت الكثير من الاعتبار المفقود لصعاليك العرب بين أقرانهم من الشعراء. حتى أنه وجد من من خلفاء الدولة الإسلامية من يتحدث بسيرته وينقل أخباره معجبا به وبها. فهذا معاوية بن أبي سفيان يتمنى أن عروة بن الورد نسيبه، وهذا عبد الملك بن مروان يتمناه أباه، وهذا خلفهما المنصور يحدث مجلسه بحكايات ابن الورد الغريبة معجبًا به فيها، ومصدقا لكل خرافاتها، وغيرهم كثيرون ممن اتخذوا من ابن الورد أسطورة شعرية وإنسانية موغلة في نبلها كأنها شخصية مرسومة في لوحة المستحيل.
لا تذكر كتب التاريخ سنة ميلاد عروة بن الورد بن زيد العبسي الغطفاني على وجه الدقة، مع أنها تشير إلى أنه توفي قبل الهجرة النبوية بنحو ثلاثين عامًا، تزيد أو تقل، لكنها على أية حال تشير إلى الزمن الذي عاش فيه هذا الشاعر متنكبًا عصا الترحال، والجهاد في سبيل قيمه التي تشارك فيها مع مجموعة من الصعاليك الذين نسبوا إليه فعرف بعروة الصعاليك، ومن غيره لهؤلاء المنبوذين في قلب الجاهلية العربية يحنو على مريضهم، ويرحم مسنهم، ويساعد ضعيفهم، ويعيد تأهيل الجميع، ويؤهله لمهمته الخالدة في الغزو والإغارة على ما يملك الكثير فيما يجوع الآخرون. فيأخذ من هذا ليقيم أود ذاك. ويرفع لواء اشتراكيته الفطرية بسيفه وقصيدته، فهما سلاحه الأمضى ليحقق العدالة البشرية وفقا لمنظوره الإنساني الخاص، والذي حاول تعميمه شعرا وحكايات تدخل بعضها في باب الملح والطرائف، ويغور بعضها الآخر بعيدا في مجاهل الأساطير والخيالات البعيدة عن منطق التاريخ.
ويبدو أن ما ساهم في انتشار أسطورته الخاصة أنه كان شاعرًا سهلاً بسيطًا، على الرغم من موهبته العالية، فلا نجد في قصائده ما ألفناه في قصائد شعراء ما قبل الإسلام من وقوف على الأطلال وبكاء على الدمن ووصف للرواحل، ومديح وهجاء، بل تجاوز كل هذا نحو معناه الإنساني الذي كان يكرره في كل قصيدته تقريبًا بطلاوة رائقة، وشعرية مرهفة، وعاطفة متأججة، وسهولة في اللفظ والإيقاع. وبقي ذلك المعنى الإنساني النبيل يتردد في جنبات شعره انتقادًا لقيم مجتمعه الطبقي والمتناقض في تعامله مع الأغنياء والفقراء.
وعلى الرغم من قلة ما وصل إلينا من شعر عروة بن الورد، إلا أنه يكفي ليكون تلك الصورة شبه المتكاملة عن شاعر مختلف في زمن لم يكن ليحتفي كثيرًا بالمختلفين.. إلا إن كان من طراز عروة بن الورد.