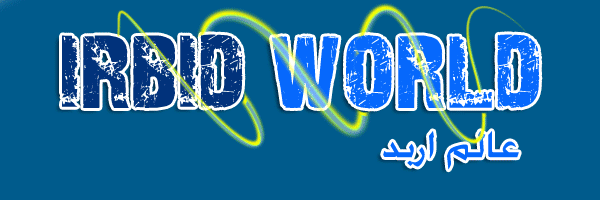كلما قرأت مجموعة شعرية أو قصصية أو رواية أو نصوصاً أدبية نثرية لكتاب إماراتيين توقفني تلك العزلة الفائضة في النصوص، حتى وإن جاءت مواربة تتوارى خلف ثيمات أخرى تقود إليها تلميحاً لا تصريحاً، ومن يراقب المشهد النشري المحلي بعين فاحصة تقع عينه على كم كبير ومتنوع السمات والأشكال من تلك العزلة التي تعلن عن نفسها في تمظهرات شتى... تلك مسألة لافتة في الحقيقة تحتاج إلى دراسة نقدية بأدوات باحث متفرغ لمهمة النقد، وفي ظني أنه سيعثر على نتائج كثيرة ومهمة.
وهي أيضاً واحدة من الملاحظات الكثيرة التي يخرج بها قارئ الكتاب الجديد للشاعر عبدالله السبب “جنازة، حب، وأشياء أخرى”، وإذا كانت ثيمة العزلة هذه تسلكه في سلك ناظم مع غيره من الشعراء والكتاب والمبدعين العزلوين فإن هناك ما يميز تجربته ويمنحها نوعاً من الخصوصية، قد يكون موضعاً للاختلاف النقدي الذي يثير في العادة مشكلات تقنوية لها علاقة بجنس المكتوب وهل يتسق مع سماته وشروطه الفنية، وهو سؤال مشروع تثيره هذه النصوص التي بين أيدينا معيدة البحث إلى المربع الأول: هل هذه النصوص تنتسب للشعر أم للقصة أم أنها نصوص مفتوحة على الأدب في بعده النثري الذي لا يقل أهمية في بعض الأحيان عن الشعر؟
سنترك هذا السؤال للمعنيين به، ولمن يرغبون في تتبع النسب وتجنيس المكتوب، ونقرأ النصوص بوصفها نصوصاً إبداعية خرجت عن روح شقية، بل ذهب بها الشقاء الوجودي كل مذهب. واقفاً على قبر يفتتح السبب نصوصه الجديدة، وقوفاً لا ترسمه الكلمات فقط بل تقوله صورة فوتوغرافية للكاتب يقف عند شاهدة قبر، لتعضد اللغة البصرية اللغة المكتوبة ويقترن الواقع بالمجاز. هكذا، ومنذ النص البصري الأول يجد القارئ نفسه أمام عتبة من عتبات المجموعة، عتبة أولى تأخذه إلى أجواء الكاتب الغرائبية التي ستزداد عجائبية كلما تقدم في القراءة. صورة دالة تضعنا أمام ثنائية الغياب/ الحضور التي ستتكرر تالياً في نصوص المجموعة.
أما العتبة الثانية التي تقود إلى المعنى نفسه فهي العناوين التي حملتها النصوص وما جاءت به من حمولات تؤشر على حالة من التشظي النفسي والقلق الروحي الذي يضاهي في بعض حالاته الموت الحقيقي (مرثية في مئذنة الشتاء، جنازة، حب، صلاة، أمسية، حوار، موسيقى الأنفاس الضارية، بوادر، طين). وأما العتبة الثالثة فهي الإهداءات التي أضاءت قليلاً عتمة النصوص خاصة تلك التي ذهبت إلى أصدقاء الشاعر الذين فقدهم سواء بسبب الموت أو البعد الجغرافي فيما ظلت القرابة الروحية بينه وبينهم متصلة وفي ديمومة.
ويأتي إخراج الكتاب، الصادر عن مركز الدراسات والوثائق في رأس الخيمة، ليقول عبر البياض ما يصعب أحياناً على الكلمات البوح به، سواء البياض الحاضر بين النصوص وتقطيعاتها أو الصفحة البيضاء التي تلي كل نص تاركة لمخيال القارئ أن يستقرئ فيها غائبات الأمور... بيد أن من الضروري الإشارة إلى أن كل هذه العتبات لم تجعل غموض النصوص بشكل عام، على تفاوت فيما بينها، من ذلك الغموض الذي يمكن للعلامات الدالة أن تفك مغاليقه، إذ بقيت نصوصاً شديدة الغموض حدَّ الاستغلاق ما يتطلب قراءتها أكثر من مرة لفهم مدلولاتها وفك رموزها.
هل هذه الرمزية الشديدة التعقيد هي الوسيلة التي اتخذها السبب لكي يجعل كتابه “جديراً بالقراءة وبالتالي جديراً بأن يقتنى” كما قال في الاقتباس المأخوذ عن “دجون راسكن” الذي قدم به “أشياء حضوره”؟
ربما... لكن ثمة ما يشير إلى أن هذا الاقتباس يمارس نوعاً من الإيحاء الذكي، لأنه يقدم للقارئ وعداً بأن الكتاب الذي بين يديه يستحق القراءة.
على كل حال، نحن هنا أمام نصوص/ مقذوفات جوّانية أشبه بتلك الحمم الجحيمية التي تقذفها البراكين لحظة ثورتها، تشي بما يعتمل في الروح المعذبة من قلق وحزن وألم وغربة وحنين واغتراب يصل الى مدياته الأقصى حيث تجد الروح نفسها في وحدة هائلة، مثل ذرة تائهة في فضاءات واسعة، بل تنشطر شطرين متباعدين كل منهما على ضفة والسبل إلى لقائهما مقطوعة إلا بالاتحاد في الموت أو إعلان موقف ما يفضي بدوره الى الموت.
الحضور/ الغياب
تتجلى في الكتاب ثنائية أساسية هي ثنائية (الحضور/ الغياب) التي ستجد تمظهراتها الأخرى في ثنائيات فرعية مثل (الحاضر/ الماضي أو الذاكرة) و (الحياة/ الموت). في ضوء هذه الثنائيات وعلى هديها نورها الشحيح الآتي من أواخر النصوص ودهاليزها المعتمة يمكن العثور على مغزى هذه النصوص وحكمتها، كما يمكن فهم حالة التشظي اللغوي التي تنتظم النصوص، لغة خارجة عن مدلولاتها باتجاه إنجاز مدلولات أخرى، أو تحقيق انزياحات لغوية يرى الكاتب فيها ما يعبر عن تجربته الروحية الخاصة، كما يمكن قراءة الصورة التي يظهر فيها السبب واقفاً بشحمه ولحمه أمام الموت. فمشهد الموت ووقوف الكاتب عند القبر هو الحضور وهو الفعل الحاضر على المستوى الزمني، أما المتواري من أحبته داخل القبر فهو الغياب وهو الفعل الماضي على المستوى الزمني، والحاضر الذي يمثله السبب سواء في وقفته أو نصوصه ما يزال وفياً للماضي رغم الموت، وها هو يقدم لإخوته (الحاضرين الأحياء) كتابه (حضوره على المستوى الإبداعي وليس الجسدي فقط) كدليل على أن حزنه الذهبي المتراكم على الراحلين الموتى (أمه وجده وأبوه وخاله) ما يزال حاضراً. والسبب الذي يجعله يدخلهم في مشهده هذا أن الإخوة هم “رفاق حضوري، وغيم مسيري” أما الموتى فهم “نبراس صبري، ومهد حكايتي”.
في الإهداء كما في الصورة تتجلى جدلية الحضور/ الغياب أمام الموت بكل شراسته، وربما (يسمع) القارئ إيقاعها الرتيب في العنوان مصحوباً بعد تنازلي مهيب يشير إلى حدوث أمر جلل: “جنازة، حب، وأشياء أخرى... في ليلة ما، في مكان ما، حدث شيء ما: ثلاثة، اثنان، واحد، صفر...!!”... وهو الانزلاق او السقوط التنازلي الذي سيظهر تالياً في حالات التشظي التي عرفها الكاتب طوال الرحلة التي قطعتها النصوص (اقدم النصوص يعود الى العام 1989 وأحدثها يعود إلى العام 2009 وجاءت غير مرتبة زمنياً).
على باب الوفاء يقف عبد الله السبب ثلاث مرات: الأولى في نص “مرثية، في مئذنة الشتاء” التي وهبها إلى صديقه الراحل جمعة الفيروز مع تذييل قال فيه: “كل رحيل وأنت صديقي”، والثانية في نص “صلاة” الموهوب الى فنان الرمس التشكيلي الأول عبد الله يعقوب الشامسي والحامل تذييلاً يغني عن الشرح: حيث وجهه المسافر، والرمس، عروس الحزن الأبيض المتوسط..!!”، والثالثة في نص “موسيقى الأنفاس الضارية” التي يهبها إلى “الـ”صديق”، الـ”أديب”، “فريد رمضان” البحرين: بمثل هذا تشيخ العاطفة.. وبمثلك أنت، تستعيد “عذاري” عذريتها..!!”... وفي النصوص الثلاثة تحضر ثنائية الحضور/ الغياب سواء عبر البنية الزمنية للنص (يتأسس نص مرثية في مئذنة الشتاء على حالتين من السرد: واحدة في الماضـي (كان، ذات ليلـة، في ليلة اخرى، كان، وكان... وكان..،) والثانية في الحاضر (في عينيه الآن: دمعة وأمنية وتعب واختناق، في عينيه حلم، وفي صندوقه الأسود: قلب وقلم ووصية، وفي المئذنة: مرثية منه ومرثية عليه، وورقة شتائية ممطرة.. تنتظر القطف..!!”. في نص “صلاة” يحضر الغياب بالتفصيل، يصعد سلم الانتفاء درجة درجة، حيث القائل في المقطع الأول والثاني يمارس فعل القول، أو بالأحرى يسرد الكاتب عنه بما يشي بحضوره فيقول “قال فيما قال: مكرراً هذه الجملة في المقطع الأول والثاني، ثم يغيب القائل لتصبح الجملة “مضى القائل”، ثم يزداد الغياب أكثر لتصبح الجملة “مضى القائل، واستدار القول يقول” مسلماً فعل القول الى الكلام نفسه مغيباً شخص المتكلم، وفي النهاية يحدث الغياب الكامل “صمت القول” ليسند الكاتب الحديث الى الصمت “طفق الصمت يقول: الصلاة”، وغياب الصوت هنا هو رمز الغياب عن الفعل أي الموت المجازي، أما الصلاة ها هنا، في حضور الجنازة فلا تعني سوى الغياب في تحققه المادي المباشر/ الموت.
كذلك يتأسس نص “موسقى الأنفاس الضارية” بكامله على الماضي البعيد/ الذاكرة المستعادة عبر ملفوظ (هناك) الذي يتكرر في بداية كل فقرة في تكرارية أقرب إلى الترنيمة أو السَّرنمة التي تؤدى بخشوع، والتي يفتتح بها الكاتب فيوضات روحه ونفسه المؤرقة بوجع الموت، الهاربة الى ملكوت شاسع من الغرائبية المتبدية في الصور الشعرية حيث النص اقرب الى الشعر منه الى النثر وفي الاستعارات وفي الكائنات الطبيعية التي تجترح أفعالاً مختلفة عن أحوالها العادية.. فيما يشبه هذيان روح في قاع الجحيم ينجز السبب نصاً تختلط فيه السخرية بالعبث بالهذيان، وتتواشج عرى الضمائر المستخدمة فلا يعود من السهل التفرقة متى يتحدث الكاتب بأناه هو ومتى يستعير أنا فريد رمضان الذي يهدي إليه نصه. لكن العلامة الأوضح في النص هي أن الكاتب كان في ذلك الحفل الغرائبي وحده، مختلفاً عن جميع الحاضرين الذين اجتمعوا لتأبينه أو لتأبين صديقه... لا فرق هنا بين الموتَيـْن.
كذلك تحضر ثيمة (الحضور/ الغياب) في لعبة الضمائر، التي تتناوب العمل فيما بينها، تارة ظاهرة وأخرى مستترة، وإن كانت الضمائر المبنية على المعنى المضمر لا تغيّب ضمير الكاتب الذي يستصرخ أحياناً ضمائرنا غير الحية، لينفخ فيها شيئاً من الحياة عبر ضمير الغائب، والشواهد التي تتوفر عليها النصوص كثيرة منها نص “حوار” الذي يجسد حالة من الافتراق الكامل والحوار المقطوع بين شخصين كل منهما: “في ضفتين كانا.. دون مرآة يطلان منها، أو دابة تقلهما إليهما، أو رؤى يتوكآن عليها”، ونص “بوادر” الذي يمكن القول إنه نص هذياني بامتياز لروح مشروخة، مقسومة على نفسها، تغلي بالخطايا والأحزان والأسئلة وتمور بأوجاع اليتم وتحمل الأنا والآخر وتعيش المتناقضات كلها بحيث يمكن إكمال اسم النص ليصبح “بوادر جنون” حيث يتأسس النص على حديث بين الكاتب وذاته أو آخَرَه الذي يراه أمامه في المرآة، ثم تختلط عليه الأمور فلا يعود يميز قسمي ذاته المنشطرة إلى شطرين، وتستمر في النصوص الأخرى إلى أن تحضر في آخر الكتاب في صيغة مستقبلية حملت عنوان: “أفق القصة القادمة” مع تذييل: في ليلة ما، في مكان ما، سيحدث شيء ما... في إشارة رمزية إلى استمرارية الحياة وأحداثها والى انفتاح القول ولانهائيته...
بقيت الإشارة إلى أن الكتاب حمل إلى جانب نصوصه الأحد عشر سبع شهادات نقدية كتبها كل من: إبراهيم مبارك، جعفر الجمري، عياش يحياوي، د. أسامة سماعنة، د. عبدالفتاح صبري، د. هيثم يحيى الخواجة، وسامح كعوش. وتمثل هذه الشهادات أو الآراء النقدية في تقديري نوعاً من (الدفاع المسبق) عن تجربة أعتقد أن عبدالله السبب أقدم عليها وهو يعلم يقيناً بأنها ستثير لغطاً.
وهي (الشهادات النقدية) تمثل موجهات نقدية تأخذ القارئ إلى الوجهة التي يريدها الكاتب... وهنا ثمة أمران: الأول أن تتأطر القراءة بالجو العام لهذه الشهادات والآراء فتأتي شبيهة لها أو تدور في فلكها، وبالتالي لن يستفيد الكاتب شيئاً على المستوى النقدي، والثاني أن يقرأ المرء النصوص بعين بصيرته هو وهذا ما أحبذه وما فعلته شخصياً، من دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية الآراء المنشورة التي قد تكون بالنسبة إلى الناقد سراجاً يضيء له طريق النصوص ويفيده في فهم الدوافع التي حدت بالقاص إلى إدراجها في الكتاب.