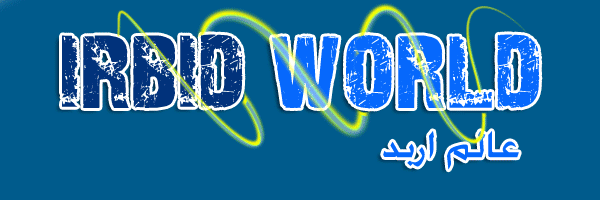كيف للواحد أن يكتب عن الحب وهو في حالة حب، وعن الخوف وهو في حالة خوف، وعن الشجاعة وهو في حالة قتال...!.
إنّ كلّ الروايات التي تحدّثت عن أهوال البحار مثلاً، قد خطّها أصحابها فوق اليابسة وعلى الشواطئ الآمنة، أمّا أبطالها الحقيقيون فلم يجدوا الوقت الكافي لكتابتها... فمنهم من لا تهمّه الكتابة أصلاً، ومنهم من أودع روايته للمجاديف المتكسّرة والأشرعة المتمزّقة لتحدّث عنه وتعيد إحياءه على الورق بعد أن صار وليمة للأسماك التي خرج لصيدها.
وحدها المسافة بينك وبين الأشياء تقوّي البصر والبصيرة، وتجعلك أوسع إدراكاً وأكثر فطنة وأوفر قدرة على التمييز، ومن ثمّ المقارنة والمقاربة.
قليلون هم أولئك المبدعون الذين يتمتّعون بـ (عين ثالثة) ولم يغادروا قراهم أو مدنهم إلاّ نادراً، كنجيب محفوظ الذي يمتلك قدرة هائلة على الانسلاخ عن (قاهرته) ثمّ يعود إليها بنفس الألق والزخم، وكأنّ روايته يتناوب عليها قلمان: قلم سائح وآخر من أبناء البلد.
لذلك، ولأجل كلّ ما تقدّم، جاءت نعمة السفر لتجعلنا ننظر إلى أمكنة غيرنا وينظر غيرنا إلى أمكنتنا، فيخبرنا عمّا لم نره وننتبه إليه.. ونخبره عمّا كان يسبح في فضائه ولا يعرفه.... لأنّه-ببساطة- لم يفارقه.
مازال الكثير منّا يحسب أدب الرحلات مجرّد كتب تجمع بين الطرافة والغرابة –وفي أحسن حالاتها- لا تزيد عن مصادر يستأنس بقراءتها، وقد يفيد بعضها في التاريخ والجغرافيا بعد تنقيتها من الشوائب والمبالغات.
لعلّ بعضنا يجهل أنّ هذا الصنف الأدبي أصبح يدرّس في أرقى جامعات العالم، ويتناول بالدراسة والبحث أصغر ما دوّنه الرحّالة والمسافرون على دفاترهم من ماركو باولو ومستعملي طريق الحرير، إلى مؤلّفات ابن بطوطة وياقوت الحموي ورحلات التيجاني وابن خلدون وحتى المتنبّي وغيره من الذين اقتلعوا من أمكنتهم متقصّدين أو مكرهين.
كان حوار الحضارات في العصور القديمة يأتي عبر تصادمها أثناء الحروب والغزوات، فلا تسود إلاّ ثقافة الغالب والمنتصر بسلاحه، بينما كانت رحلات الحجّ والتجارة والاستكشاف هي الوسيلة السلميّة الوحيدة لمعرفة الآخر والاطّلاع على حضارته قبل وسائل الاتصال الحديثة.
لكنّ المؤسف والغريب والمحيّر أنّ عصرنا الحديث قد جعل المسافات تتقارب والثقافات تتباعد، وكأنّ كلّ واحد يسير عكس الآخر، فهذه أسوار الحدود تزيد سماكة وارتفاعاً، وتزيد معها حواجز الفصل العرقي والديني والطبقي والثقافي.
أصبح قارب السفر الوحيد هو شاشة التلفاز أو الكومبيوتر، فترى شبابنا العربي الحائر يسافر كلّ ليلة عبر كبسة زرّ على الريموت كونترول أو (الماوس) ثمّ يعود صبيحة اليوم التالي إلى بلده: موطن أحلام اليقظة بامتلاك مصباح سحريّ اسمه: (الفيزا) أو الهجرة (غير الشرعيّة) عبر مراكب ضيّقة ومتهالكة كواقعهم الحزين... وغالباً ما ينتهي بهم الأمر جثثاً ترثيها طيور البحر وتدفع بها الأمواج نحو شاطئ الوصول الأخير.
أمّا من امتلك القدرة على السفر والتنقّل من أولئك الذين اكتنزت جيوبهم وخفّت رؤوسهم، فإنّك ترى الواحد منهم يحلّ في مدينة فيقصد مرابعها الليليّة قبل متاحفها الفنيّة، ينزل أفخم الفنادق، يتسوّق من أغلى الماركات، وقد يكتفي بصور يلتقطها أمام معالم شهيرة كي يوثّق لسفره أمام معارفه، ثمّ يعود بنفس الطائرة التي تشبه كلّ الطائرات بعد أن زار المحلّات التي تشبه كلّ المحلاّت في مختلف أنحاء العالم..!.
أما كان الأجدر بهذا المسافر(دون خيال) أن يتسوّق في إحدى (مولات) بلده ويقتني ما شاء له من مظاهر العولمة ثمّ يعود إلى بيته دون عناء.
الترحال عقليّة وسلوك تغذّيه ثقافة، وفضول دائم نحو المعرفة لدى المجتمعات المتحضّرة، إنه السفر في الإنسان والزمان قبل المكان. ألم يقل الإمام الشافعي يوماً:
سافر تجد عوضاً عمّن تفارقه وانصب فإنّ لذيذ العيش في النصب
إنّي رأيت ركود الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب
السهم إن لم يفارق القوس لم يصب والعود في أرضه نوع من الخشب.