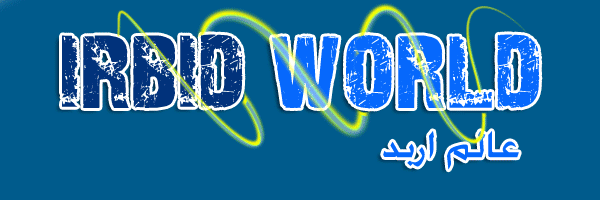صبح من الواضح تركيز البرامج التدريبية والمناهج التربوية على مبدأ الثقة بالنّفس، وانجرف مع هذا كثير من المدربين الشرعيين، وأصبحت عبارة (الثقة بالنّفس) دندنة تتكرر على لسان كثيرٍ ممّن يهدف إلى بثّ الحماسة والتحفيز فيمن يتعامل معه، سواء كانوا من المحبطين أو المرضى النفسيين أو غيرهم.
وهذا الأمر مخالف وبشكل صريح للمنهج الإسلامي الشرعي.
فرقٌ كبير بين معرفة النّفس وبين الثقة بها.
الثقة في المنهج الشرعي لا يستحقّها إلاّ الله تعالى.
المؤمن الحقّ هو من يفرد الله وحده بالثّقة، وذلك لأنّه المتفرّد بالكمال المطلق في القدرة والحكمة والعلم والرحمة وغير ذلك من الكمالات.
أمّا النّفس فإنّ منهج الإسلام يوصي بمعرفتها ومعرفة الهبات الّتي وهبها الله تعالى لتوظيفها كسائر الأسباب الّتي يتوصّل بها العبد إلى مراده ومطلوبه من حاجات الدين أو الدّنيا.
ومعرفة نقائصها وعيوبها حتّى يستكملها أو يتّقي آثارها..
كيف يثق المرء بنفس وُصفت بكلّ صفات النّقص من الضعف، والنسيان، والاغترار، والجهل، والعجلة، والهلع، والطمع، والشّح، والتلوّم، والأمر بالسّوء، والنزعة للشر!
ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلّم في خطبة الحاجة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»..
من أسوأ ما تسمعه من بعض الشّرعيين - للأسف - هو التركيز على الثقة بالنّفس في جانب الهدى والضلال والإيمان والكفر والمعصية، ونحو ذلك ممّا نصّ القرآن والسنّة على أنّه بيد الله تعالى لا بيد الإنسان، وإنّما غاية ما بيد العبد هو النزوع إلى ذلك، والرغبة فيه، والعمل لأجله، ثمّ التحصيل والتوفيق أمر ربّاني محض، (مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا)، (وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُون * وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون).
كان أحمد بن محمد الجمال الصوفي يقول: «لا يمكن الخروج من النفس بالنفس، وإنما يمكن الخروج من النفس بالله وبصحة الإرادة لله».
وكان يقول: «النفس كالنار إذا أطفئ من موضع تأجّج من موضع، كذلك النفس إذا هدأت من جانب ثارت من جانب».
وقال إسحاق الحنظلي: «للخَلْقِ في يوسف -عليه السلام- آيات، وليوسف في نفسه آية وهي أعظم الآيات: معرفته بمكر النفس وخدعها حين قال: (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)».
ودخل شابٌّ على سهل بن عبد الله وقال: يا أستاذ، أي شيء القُوت؟ قال: الذِّكْر الدائم، قال الرجل: لم أسألك عن هذا، إنما سألتك عن قوام النفس، فقال: «يا رجل لا تقوم الأشياء إلاّ بالله»، فقال الرجل: لم أعنِ هذا، سألتك عما لا بدّ منه، فقال: « يا فتى لا بدّ من الله».
وقال منصور: «سلامة النفس في مخالفاتها وبلاؤها في متابعاتها».
ومنهج الإسلام في هذا الباب لخّصه قوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: «المؤمن القويّ خيرٌ و أحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، و في كلٍّ خير، احرِصْ على ما ينفعك، و استعِن بالله و لا تعجَز، و إن أصابك شيء فلا تقلْ: لو أني فعلت كان كذا و كذا، و لكن قلْ: قدّر الله و ما شاء فعل فإنّ لوْ تفتح عمل الشيطان».
لكن ما معنى الثقة بالله؟
الثقة بالله ليست سيرَ التقدير الإلهي وفق مُرادِ الإنسان وتطلّعاته كما يظنّ البعض.. إذا يدعو الله في شيء مثلًا أو يتسبّب إلى شيء ثمّ يجعل ثقته في الله أن يتحقّق له ما أراد، هذا رجاء في الله وهو حسن جميل، لكن الثقة أدقّ وأخصّ من هذا.
بل الثقة بالله في أنّ كل ما يقدّره الله تعالى للعبد ويدبّره له فهو خير مما يريد العبد ويدبره لنفسه، فهي بالرّضا عن الله وبالله أليق، وليست هي، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلّم: «رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد -صلى الله عليه وسلّم- نبيًّا» وقوله تعالى عن المؤمنين: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ).
وها يعني أنّ للثقة بالله وجوهًا عدة:
منها: الثقة في مراده الشرعي، وهي ثقة في علمه وحكمته، فإذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فإنّ علينا الثّقة في أنّ ذلك هو الأصلح والأنفع، وهذا مقام أهل التسليم والاتباع للشريعة، وإليه يشير قوله تعالى: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون). وقوله تعالى في شأن المطلقات: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون).
ومنها: الثقة في مراده الكوني، وهو ما يعبر عنه بالإيمان بالقدر خيره وشره، ومنه الرّضا عنه وعن أقداره خيرها وشرّها، والخير والشرّ هنا بالنسبة للعبد، وإلاّ فليس في أفعاله شرّ محض تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلّم في دعائه: «والشرّ ليس إليك»، قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون).
ومنها: الثقة في وعده، ونصر الله تعالى لدينه ولعباده الصالحين، والانتصار للمظلوم من الظالم، فهذا أيضًا نوع من الثقة التي أمر الله بها، وهكذا كان حال النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- طيلة أيّامه الشريفة، في السرّاء وفي الضرّاء كان في منتهى الثقة بالله تعالى، وقد كان في أشدّ العذاب والتنكيل بأصحابه يقول: «والله لُيتمنّ الله هذا الأمر»، وفي شدّة معاناة المسلمين في غزوة الأحزاب كان يضرب الصخرة ويبشّر المسلمين بكنوز فارس والروم، وخلاف ذلك سوء ظنّ بالله تعالى، لا يكون إلاّ من منافق محض أو من فيه شعبة من النفاق، وهذا ما حكاه الله عنهم في الأحزاب: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا)، وقال تعالى في سياق آخر: (بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا)، وقال في شأن غزوة أحد: (وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور).
ومنها: الثقة في رحمته، وأنّه مهما قدّر الله على العبد وأراده له فإنّه رحمة وإن بانت للعبد خلاف ذلك، وهذا من خصائص أهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلّم: «عجبًا لأمر المؤمن إنّ أمره كلّه له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له».
عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: رأيت في يد محمد بن واسع قُرحة فكأنّه رأى ما قد شقّ عليّ منها فقال لي: تدري ما على في هذه القرحة من نعمة؟ قال: فسكتُّ، قال: حيث لم يجعلها على حدقتي، ولا على طرف لساني، ولا على طرف ذَكَري، قال: فهانت عليّ قرحته.
ومنها: الثقة في عدله، وأنّ كلّ ما شرعه وقسمه لعباده هو منتهى العدل، وأنّ ما يصيب العبد من بلاء وعقوبة هو مقتضى عدله سبحانه معه، ولهذا فإنّ من سوء الظنّ بالله تعالى القدح في بعض الأحكام الشرعيّة خاصة في باب العقوبات أو الأحكام المتعلقة بالمرأة، كما نسمع هذه الأيّام دندنة المنافقين حولها، ولهذا – كذلك - ليس من الصواب قول البعض حين يقدر الله على عبد نراه صالحًا أو ضعيفًا بلاء أو يعطي فاسقًا أو غنيًّا فضلاً: «والله ما يستاهل»؛ لأنّ هذا اتّهام لله تعالى أنّه وضع عقوبته أو ابتلاءه أو نعمته في غير محلّها، وهو قدح في علمه وحكمته، فالله أعلم بعباده وهو أعلم أين يضع عقوبته وأين يضع فضله ونعمته، وله في كل ذلك حكمة.
ومنها: الثقة في غناه المطلق، وجوده وكرمه الواسع، ومن مقتضى ذلك قوله تعالى: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، حتى جاء عنه صلى الله عليه وسلّم في صحيح البخاري: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له» ولمسلم: «وليعظم الرغبة، فإنّ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»، فإذا سأل العبد ربّه ولم يجد إجابة فليُسئ الظنّ بنفسه لا بربّه.
ومنها: الثقة في وعيده وأنّه قادر عليه، ولهذا قال تعالى: (وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا).[النساء:30]، (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقا * إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا)، وهذا يلزم منه الخوف وملازمة الرهبة منه تعالى، من وعيده المُعجّل أو المؤجّل، ولهذا كانت عائشة تقول عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: «كان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية!فقال: «يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا».
ومنها: الثقة في أخباره التي أخبرنا بها في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلّم- فكل ما أخبرنا به القرآن من حقائق الغيب أو المستقبل أو الماضي السحيق والأمم الغابرة أو الحقائق العلمية الواضحة، فالثقة بالله فيه واجبة مهما حاول البعض التشكيك فيها، وهذا الأمر داخل في حقيقة الإيمان بالله وكتبه ورسله، ولهذا لم يستطع أحد خلال القرون الماضية وحتى الآن- على الرغم من محاولاتهم المضنية- أن يثبتوا خطأ خبر واحد من أخبار القرآن والسنة الصحيحة، بل ما زالت العلوم الماديّة تتسابق لإثبات صدق ما أخبرنا به الكتاب والسنة، وهذا جزء ممّا يشير إليه قوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ).
أخيرًا فإنّ الثقة بالله تعالى عملٌ قلبي محض، فلا تعارض بينه وبين اتخاذ الأسباب المادية والمعنوية في تحقيق أهدافنا المشروعة. فالمطلوب من العبد أمران:
بذل السبب المشروع، والثقة بالله في أنّ كل ما يقدّره خير.
فليس من الثقة بالله ترك الأسباب، بل ترك السبب مخالفٌ للثقة بالله في أكثر معانيها أهمية وهي الثقة بوعيده الكوني، وأنّ من أهمل السبب فقد النتيجة، والثقة في شريعته الّتي أمرت بالسعي كما في قوله: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا).
الآن ما هو تصورك للثقة بالله؟ أليست هي لُباب الإيمان بالله تعالى؟
لهذا لا عجب أن تكون مرتبطة بجانبين: جانب الإيمان بالله واليقين، وجانب العلم، فلا تضعف ثقة العبد بالله في أيّ وجه من وجوهها إلاّ لضعف أحد الجانبين أو كليهما، ولهذا كان الأنبياء ومن بعدهم أتباعهم من العلماء أكثر النّاس ثقة بالله تعالى واطمئنانًا له وبه.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الثقة به. إنّه جواد كريم.