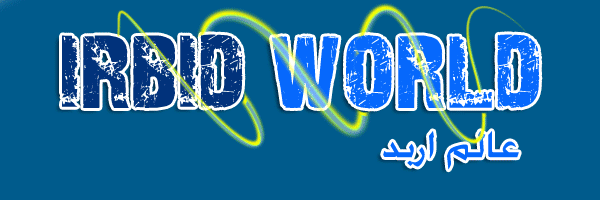عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ حدودا فلا تعتدوها ، وحرّم
أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء - رحمة لكم غير نسيان – فلا تبحثوا
عنها ) حديث حسن ، رواه الدارقطني وغيره .
الشرح
عندما
نقف متأملين لهذا الحديث ، فإننا نلحظ ما فيه من استيعاب لأحكام الشريعة
الإسلامية ، وما فيه من توضيح لطبيعة هذا الدين وحقيقته ؛ ولأجل ذلك أولى
العلماء هذا الحديث اهتماما بالغا قادهم إلى دراسته واستخراج معانيه ، وبلغ
بهم أن قالوا عن هذا الحديث : " ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده
لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث " .
وإذا
نظرنا إلى هذا الحديث ، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد لنا
معالم هذا الدين وطبيعته ، فعبّر عن شرع الله بألفاظ أربعة : الفرائض
والمحارم ، والحدود والمسكوت عنه ، وترتبط هذه الألفاظ ارتباطا وثيقا محكما
، لترسم لنا التصوّر الصحيح للمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في هذه
الدنيا .
لقد كانت أول قضيّة يتناولها الحديث بيان موقف المكلّف نحو ما يرد عليه من الأوامر في الكتاب والسنة فقال : ( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها )
، إنه توجيه إلى عدم التفريط في أداء الفرائض ، والفرائض هي الواجبات
الشرعية التي أوجبها الله على عباده وألزمهم بها ، ومنها ما يكون واجبا على
كل أفراد الأمة ، وهو ما يسمّى بالفرائض العينيّة ، ومنها ما هو واجب على
الكفاية ، أي : إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
فهذه
الفرائض – بنوعيها – واجبة على كل مكلّف مادام مستطيعا ، وإذا ورد الأمر
من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلّم فلا مجال لردّه أو عدم
تنفيذه ؛ لأن هذا هو مقتضى إيمان العبد بالله ورسوله ، كما قال الله تعالى
في كتابه : { وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } ( الأنفال : 1 ) ، فهذه الطاعة هي هي عنوان العبودية والتسليم لحكم الله وشرعه .
وإذا
تأمّلنا نصوص الوحيين فإننا نجد أنه قد جاء التعبير عن الفرض بكلمة أخرى
هي الواجب ، والحقيقة أنه لا فرق بين هذين اللفظين من حيث العمل ، فكلاهما
لازمٌ أداؤه ، لكن ذهب بعض أهل العلم – كالإمام أحمد
وغيره - إلى التفريق بينهما من ناحية المرتبة ، فجعلوا ما ثبت عن طريق
الكتاب فرضا ، وما ثبت عن طريق السنة واجبا ، وبعضهم جعل الفرض أعلى رتبة
من الواجب ؛ لأن الفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بالظن ،
وعلى أية حال فإن هذا تفريق اصطلاحي لا يؤثر على حكم العمل بهما .
أما فيما يتعلّق بالمحرّمات ، فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركها فقال : ( وحرّم أشياء فلا تنتهكوها )
، فدعا إلى ترك المعاصي بجميع أنواعها ، وإنما عبّر هنا بلفظ الانتهاك ؛
ليبيّن ما عليه حال من يقارف المعاصي من تعدٍّ وعدوان على أحكام الله عزوجل
، فأتى بهذه اللفظة للتنفير عن كل ما نهى الله عنه.
ولما
كان مدار التكليف كله على فعل المأمور وترك المحذور ، والتقيد بأحكام
الشريعة ، والالتزام بما ورد فيها ، والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها ،
أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ( وحدّ حدودا فلا تعتدوها ) .
والحدود
لفظة وردت في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة ، ولها مدلولات كثيرة بحسب ما
تتعلق به ، ففي الأوامر : يكون الوقوف عند حدود الله بعدم الخروج عن دائرة
المأذون به إلى دائرة غير المأذون ، وأما فيما يتعلّق بالنواهي فيحرم
مجرّد الاقتراب منها ؛ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً ، حرّم كل ما يؤدي
إليه ، وتلك هي خطوات الشيطان التي جاء التحذير منها في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر } ( النور : 21 ) .
فإذا
كان هذا هو موقف المسلم تجاه ما ورد بيانه في الشريعة ، فما هو موقفه تجاه
ما سكت عنه الشرع ولم يوضح حكمه ؟ وللجواب عن هذا نقول : إذا لم يرد نصّ
في حكم مسألة ما ، فإننا نبقى على الأصل ، وهو الإباحة .
وهذا هو السكوت المقصود في قوله : ( وسكت عن أشياء - رحمة لكم غير نسيان – فلا تبحثوا عنها )
، إنه سكوت عن إظهار حكمه ، ومقتضاه أن يكون باقيا على أصل إباحته ، وليس
معنى هذا جواز الابتداع في الدين والزيادة فيه ، بحجة أنه مسكوت عنه ؛ فإن
الابتداع ليس مسكوتا عنه ، بل هو محرّم كما دلّت الأدلّة على ذلك .
ومما
سبق يتبين لنا معاني تلك الألفاظ الأربعة ، والتي ترشدنا إلى القيام بحقوق
الله ولزوم شريعته ، مع العفو عما سُكت عنه ، فدخل الدين كله في تلك
الكلمات القليلة الجامعة المانعة .