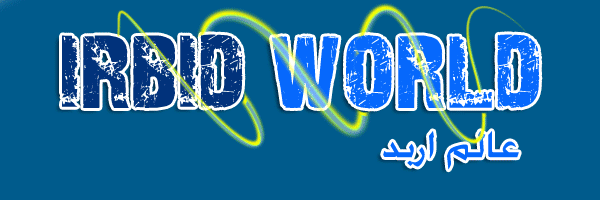عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
الله ، دلّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبّني الناس ، فقال : ( ازهد في الدنيا يحبّك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس ) .
الشرح
الإنسان
اجتماعي بطبعه ، يحبّ أن يأنس بالناس ، وأن يأنس به الناس ، كما يعجبه أن
يكون محبوبا في مجتمعه ، محترما في بيئته ، لذا فهو يسعى دائما لكسب ود
الناس وحبهم ، والعاقل من البشر من يسعى لرضى ربّ الناس قبل سعيه في كسب
رضى الناس .
ولا
شك أن لنيل محبّة الله ثم محبّة الناس سبيل وطريق ، من حاد عنه ، خسر تلك
المحبّة ، ومن سلكه فاز بها ، وأنس بلذتها ، ولذلك أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث ، ليكون معلما ومرشدا ، وليبيّن لنا الكيفية التي ينال بها العبد محبة ربّه ومحبة خلقه .
إن
محبّة الخالق للعبد منزلة عظيمة ، فهي مفتاح السعادة ، وباب الخير ، ولذلك
فإنها لا تُنال بمجرّد الأماني ، ولكنها تحتاج من العبد إلى الجدّ
والاجتهاد في الوصول إلى هذه الغاية ، وقد جاء في الكتاب والسنة بيان
للعديد من الطرق التي تقرّب العبد من مولاه وخالقه ، وتجعله أهلا لنيل رضاه
ومحبته ، وكان من جملتها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
الحديث من التخلق بخلق الزهد .
والزهد
هو قصر الأمل في الدنيا ، وعدم الحزن على ما فات منها ، وقد تنوعت عبارات
السلف في التعبير عنه ، وأجمع تعريف للزهد هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : " الزهد: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة " ، وهذا يشمل ترك ما يضر ، وترك ما لا ينفع ولا يضر .
ولا
يفهم مما سبق أن الأخذ من طيبات الحياة الدنيا على قدر الحاجة ينافي معنى
الزهد ، فقد كان من الصحابة من كانت لديه الأموال الكثيرة ، والتجارات
العديدة ، كأمثال أبي بكر الصديق و عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف
رضي الله عنهم أجمعين ، لكن هذه التجارات وتلك الأموال كانت في أيديهم ،
ولم تكن في قلوبهم ، ولهذا ترى الصحابة رضي الله عنهم في باب الصدقة ،
ومساعدة المحتاج ، والإنفاق في سبيل الله ، تراهم كمطر الخير الذي يعطي ولا
يمنع ، ويسقي حتى يُشبِع .
وعلى
هذا فإن حقيقة الزهد : أن تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك ، فإذا كان العبد
مقبلا على ربّه ، مبتعدا عن الحرام ، مستعينا بشيء من المباحات ، فذلك هو
الزهد الذي يدعو إليه الحديث ، وصدق بشر رحمه الله إذ يقول : " ليس الزهد في الدنيا تركها ، إنما الزهد أن يُزهد في كل ما سوى الله تعالى ، هذا داود و سليمان عليهما السلام قد ملكا الدنيا ، وكانا عند الله من الزاهدين " .
ولقد
وعى سلفنا الصالح تلك المعاني ، وقدروها حقّ قدرها ، فترجموها إلى مواقف
مشرفة نقل التاريخ لنا كثيرا منها ، وكان حالهم ما قاله الحسن البصري
رحمه الله : " أدركت أقواما وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا
إذا أقبل ، ولا يأسفون على شيء منها إذا أدبر ، وكانت في أعينهم أهون من
التراب " .
لقد نظروا إليها بعين البصيرة ، ووضعوا نُصب أعينهم قول الله تعالى : { يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور } (فاطر : 5 ) ، وقوله : { واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح } ( الكهف : 45 ) ، فهانت عليهم الدنيا بكلّ ما فيها ، واتخذوها مطيّة للآخرة ، وسبيلاً إلى الجنّة .
ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم السبيل إلى محبة الناس فقال : ( وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس )
،ومعنى ذلك : ألا يكون القلب متعلقا بما في أيدي الناس من نعيم الدنيا ،
فإذا فعل العبد ذلك ، مالت إليه قلوب الناس ، وأحبته نفوسهم .
والسرّ
في ذلك أن القلوب مجبولة على حب الدنيا ، وهذا الحب يبعثها على بغض من
نازعها في أمرها ، فإذا تعفف العبد عما في أيدي الناس ، عظم في أعينهم ؛
لركونهم إلى جانبه ، وأمنهم من حقده وحسده .
فما أعظم هذه الوصية النبوية ، وما أشد حاجتنا إلى فهمها ، والعمل بمقتضاها ، حتى ننال بذلك المحبة بجميع صورها .