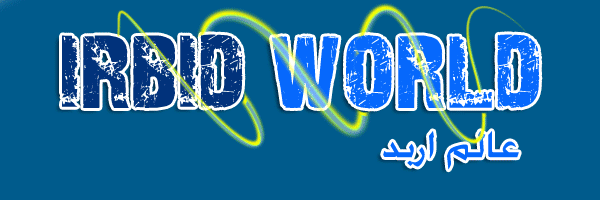يمتاز
الخطاب القرآني، بأنه خطاب يجمع بين الخوف والرجاء، وبين الترهيب
والترغيب، وبين الوعد والوعيد، وبين البشارة والنذارة، وبين العمل للدنيا
والتوجه للآخرة؛ فهو خطاب وسطي، يخاطب جوانب الإنسان كافة، لا يركز على
جانب ويدع جانبًا، بل يأتي على هذا وذاك، بما يناسب المقام، وبما يقتضيه
الحال .
وكان
المشركون في معركة أحد قد نالوا من المسلمين، وأصابوا منهم جراحًا كثيرة
وبليغة، وقتلوا منهم عددًا تجاوز السبعين صحابيًا، وكسروا بعض أسنان رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وجرحوا وجهه الكريم، وكادوا يفعلون أكثر من ذلك،
ولكن الله سلم؛ وقد تأثر المسلمون مما أسفرت عنه نتائج تلك المعركة، وظنوا
أن النصر لم يعد يعرف طريقًا إليهم، فبين لهم سبحانه، أن النصر والهزيمة،
يخضعان لقوانين لا تتخلف، وسنن لا تتبدل، فقال تعالى: { قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين } (آل عمران:137) .
ومن جملة الآيات التي نزلت بعد وقائع غزوة أحد، قوله تعالى: { ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين }
(آل عمران:139)، وقد جاءت هذه الآية لتخفف عن المسلمين ما نزل بهم، وتطلب
منهم أن لا يستسلموا للضعف والهزيمة، ولا ييأسوا من نصر الله، بل عليهم أن
يواجهوا الموقف بقوة وصلابة ورباطة جأش؛ وذلك لأن مكانتهم في الدنيا
والآخرة، أسمى وأرفع من مكانة أهل الكفر والضلال .
وقد
روى أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية خبرين، يكشفان الظروف التي نزلت
بسببها الآية الكريمة، ويليقان مزيدًا من الضوء على معناها .
الخبر الأول رواه الطبري في تفسيره عن الزهري ،
قال: كثر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القتل والجراح، حتى أصاب كل
امرئ منهم اليأس، فأنزل الله عز وجل القرآن، فواسى فيه المؤمنين بأحسن ما
واسى به قومًا، كانوا قبلهم من الأمم الماضية، فقال: { ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين }، فجاءت هذه الآية تعزية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحثًا لهم على قتال عدوهم، ووعدًا لهم بالنصر والظفر عليهم .
والخبر الثاني رواه الطبري أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقبل خالد بن الوليد - وكان ذلك قبل أن يسلم - يريد أن يعلو عليهم الجبل - جبل أحد - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم لا يعلون علينا )، فأنزل الله: { ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين } .
وقد
جاءت هذه الرواية من طريق آخر، فيها مزيد تفصيل عن وقائع هذا الحدث؛
فعندما انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قالوا: ما فعل
فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فنعى بعضهم بعضًا، وتحدثوا أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد قتل، فكانوا في هم وحزن. فبينما هم كذلك، إذ علا خالد بن الوليد الجبل بخيل المشركين فوقهم، وهم أسفل الجبل، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم لا قوة لنا إلا بك، وليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر ! ) ورجع نفر من المسلمين الرماة، فصعدوا الجبل، ورموا خيل المشركين حتى هزمهم الله، وعلا المسلمون الجبل. فأنزل سبحانه قوله: { وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين }؛
وقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم أهل الشرك والضلال، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم بعد وقعة أحد، لم يخرج في غزوة من غزواته، إلا كان النصر
حليفه، والتوفيق رفيقه .
قال الإمام القرطبي في
تفسيره، بعد ذكره سبب نزول هذه الآية: " فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرًا، إلا
ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل عسكر
كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر
لهم، وهذه البلدان كلها إنما افتتحت على عهد أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم، ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه، كما كانوا يفتتحون
في ذلك الوقت " .
والمستفاد
من سبب نزول هذه الآية، بيان سنة الله في المدافعة بين الكفر والإيمان،
والحق والباطل، وأن العاقبة للمتقين، والخزي والسوء نازل بالكافرين، وإن
كان ظاهر الأمر يدل على خلاف ذلك، فإنما هو من باب الاستدراج للكافرين،
والابتلاء للمؤمنين، فإن للباطل جولة، ثم لا يلبث أن يندحر، وينهزم، ويبوء
بالفشل والخذلان، وهذا ما تؤكده وقائع التاريخ الماضي والحديث .
على
أن الأمر المهم وراء سبب نزول هذه الآية، هو أن يعي المسلمون اليوم درس
يوم أحد؛ وسنن الله في الأرض، ويتعلموا أن قوانين الله في خلقه جارية لا
تتخلف، وباقية لا تتبدل، وأن الأمور لا تمضي جزافًا، وإنما تتبع قوانين
محددة، وسننًا ثابتة، فإذا هم درسوها، وأدركوا معانيها، وعملوا بمقتضاها،
كان النصر حليفهم، والتوفيق قائدهم؛ وأن من أهم تلك السنن، أن النصر دائمًا
إنما يكون حليفًا لمن يقيم شرع الله، ويعمل على هدي نبيه، { وإن تطيعوه تهتدوا } (النور:54)