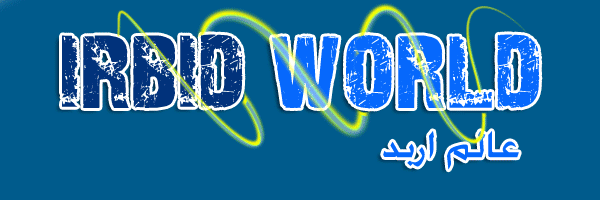ضَرْب
الأمثال أسلوب قرآني، القصد منه تقريب الفكرة إلى ذهن القارئ، وتبسيط ما
هو مجرد، وجعله أقرب ما يكون إلى الفهم؛ فكلما كانت الفكرة مصاغة بحسب ما
هو واقع ومحسوس، كانت أوضح في بيان المقصود، وأبلغ في تحديد المراد.
ومن الأمثلة القرآنية التي ضربها سبحانه للناس، تبياناً لمواقف المنفقين للمال، وتمحيصاً للمؤمن من المنافق، قوله تعالى: {
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه
وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
* ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل
جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما
تعملون بصير * أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها
الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار
فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون } (البقرة:264-266).
هذه الآيات الثلاث تضمنت أمثلة ثلاثة، تتعلق بأحوال الناس في الإنفاق:
المثال الأول:
فيه تشبيه بعض المتصدقين الذين يتصدقون طلباً للثواب، غير أنهم يُتبعون
صدقاتهم بالمن والأذى، بالمنفقين المرائين، الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون
من إنفاقها إلا السمعة والمفاخرة بين الناس. فالذي ينفق ماله ابتغاء
السمعة والظهور بين الناس، لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته، ويكون قلبه
مغشياً بالرياء، كالحجر الذي لا خصب فيه ولا ليونة، يغطيه تراب خفيف، يحجب
قسوته عن العين، كما أن الرياء يحجب قسوة القلب الخالي من الإيمان. فإذا
نزل مطر غزير على هذا الحجر، ذهب بالتراب الذي عليه، فانكشفت حقيقته، وظهرت
قسوته، ولم ينبت زرعه، ولم يثمر ثمره، كذلك القلب الذي أنفق ماله طلباً
للظهور بين الناس، فإن إنفاقه هذا لا يثمر خيراً، ولا ينفعه أجراً!
ووجه
التمثيل بين المانِّ والمؤذي بصدقته وبين المرائي بنفقته، أن كلا منهما قد
غش نفسه، فألبسها ثوب زور، يوهم الرائي شيئاً غير ما هو في الحقيقة.
المثال الثاني:
ضرب الله المثل فيه للمخلصين في الإنفاق؛ وذلك مثل المؤمن العامر قلبه
بالإيمان، ينفق ماله عن ثقة ثابتة في الخير، نابعة من الإيمان، كمثل بستان
خصب عميق التربة، يقوم على ربوة، فإذا نزل عليه مطر كثير، أعطى ثماراً
وغلالاً ضعفي ما يعطي غيره. وإذا نزل عليه مطر قليل كفاه ليبقى على رونقه
وجماله وبهائه.
ووجه التمثيل في هذا المثل - كما قال الشيخ رشيد رضا -
أن المنفق ابتغاء مرضاة الله هو في إخلاصه وسخاء نفسه وإخلاص قلبه كالجنة
الجيدة التربة الملتفة الشجر العظيمة الخصب في كثرة بره وحسنه، فهو يجود
بقدر سعته، فإن أصابه خير كثير أغدق ووسع في الإنفاق على ذوي الحاجات، وإن
أصابه خير قليل أنفق منه بقدره، فخيره دائم، وبره لا ينقطع; لأن الباعث
عليه ذاتي لا عرضي كأهل الرياء وأصحاب المن والإيذاء. فـ (الوابل) و(الطل)
على هذا عبارة عن سعة الرزق وما دون السعة.
ولك أن تقول: إن وجه التمثيل هنا - كما قال الشيخ محمد عبده -
أن النية الصالحة في الإنفاق كالوابل للجنة فيها تكون النفقة نافعة للناس;
لأن أصحابها يتحرون مواضعها، فيضعون نفقتهم موضع الحاجة، لا يبذرون بغير
روية. وأن أمثال هؤلاء المخلصين لا يخيب قاصدهم; لأن رحمة قلوبهم لا يغور
معينها، فإن لم تصبه بوابل من عطائها لم يفته طَلَّه، فهم كالجنة التي لا
يخشى عليها اليبس والزوال.
وهذا
التمثيل يفيد أن إنفاق المؤمن قد يكون إنفاقاً كثيراً، مثل المطر الغزير،
وقد يكون إنفاقاً قليلاً، مثل المطر القليل، وفي كلٍّ خير، وهو يُعبِّر عن
اهتمام المؤمن بغيره، والعمل على النهوض بأمته قدر استطاعته، وبحسب
إمكاناته.
وهذا
المثل مقابل للمثل الأول؛ فإذا كان قلب المرائي قاسياً، عليه ستار من
الرياء، كمثل حجر صلد عليه غشاء من التراب، فإن قلب المؤمن كالأرض الخصبة
المعطاء؛ وإذا كان قلب المرائي المغطى بالرياء والنفاق، كمثل حجر أملس مغطى
بالتراب، سرعان ما تنكشف حقيقته وطبيعته، فإن قلب المؤمن خير على كل حال.
المثال الثالث:
عقَّب سبحانه المثلين السابقين بمثل آخر، يتبين به حال الفريقين؛ إذ فيه
تمثيل لنهاية المن والأذى، وكيف يمحق الله آثار الصدقة المتبوعة بالمن
والأذى محقاً في وقت لا يملك صاحبها قوة ولا عوناً، ولا يستطيع لذلك المحق
دفعاً ولا منعاً، تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة بستان فيه من كل
الزروع والثمرات، جارياً الماء في كل أنحاءه، فهل يود من كان مالكاً لمثل
هذا البستان أن يخسر بستانه، خاصة بعد أن تقدمت به السن، وبلغ أرذل العمر،
وأخذ العجز منه كل مأخذ، وكان تحت رعايته أولاد ضعاف ونساء عجائز، لا
يستطيعون سعياً في الأرض ولا كسباً، فهل يرغب من كانت هذه حاله أن تأتي
بستانه عاصفة، تفني أخضره ويابسه، وتذره قاعاً صفصفاً، أو هل هو راغب أن
يحترق بستانه فيصبح نسياً منسياً؟
ويصور
لنا هذا المثل أنموذجاً من واقع الحياة البشرية، حيث نجد مثل هذا الشيخ
الفاني الكبير في ضعف جسمه، ووهن نشاطه، وقد تكون له ذرية لا يعطفون عليه،
أو قد يكونون فقراء لا يقدرون على نفعه بشيء، إن لم يكونوا عالة عليه، فكما
يتحسر هذا الشيخ على حياته السابقة، كتحسر الذي أنفق ماله منًّا وأذى، أو
كالذي أنفقه بقصد لفت الأنظار والأسماع؛ لأنه لم يدخر عملاً صالحاً يشفع له
يوم القيامة، إذا انقطعت به أسباب الدنيا.
والتمثيل
هنا أيضاً فيه تصوير لحال المؤمن المعطاء المنفق ماله ابتغاء وجه الله،
فهو لا يقصد أن يذهب بأجر صدقته هباء، بل هو حريص كل الحريص على أن تكون
خالصة لوجه الله تعالى، فلا يمنُّ بها على أحد، ولا يؤذي أحداً بكلمة تجرح
مشاعره، وتذهب ببركة صدقته.
كما
يدل هذا المثل الأخير على أن الذي يهمل طاعة الله من أجل ملاذِّ الدنيا،
لا يحصل في الآخرة إلا على الحسرة والندامة. فهو يحتاج في آخرته إلى
الأعمال الصالحة كحاجة صاحب الأرض إلى ثمارها وخيراتها. ولعل حسرة هذا
الشيخ الفاني الذي بلغ من الكبر عتياً تكون أعظم بعدما يئس من الشباب الذي
ولى هارباً، فلم يعد لديه إمكانية على العمل والعطاء.
فالقرآن
الكريم من خلال هذه الأمثلة الثلاثة، يريد أن يربي المسلم على مأثرة من
مآثره السامية، وهي مأثرة الإنفاق في سبيل الله، ويبين له أن الرياء يبطل
ثواب العمل، وأن المنَّ والأذى يحبط أجر الصدقة. فالرياء مرض من أمراض
المجتمع، يدل على ضعف في الشخصية، وسوء في الخلق، وتعلق بالدنيا، وبُعد عن
الآخرة. والإسلام عندما أوصى بالصدقة، إنما أوصى بها تزكية لنفس المتصدق،
وتزكية لماله أيضاً، وحرصاً على تكافل المجتمع، وبناء مجتمع معافى من الحسد
والبغضاء، وبعيد عن التناحر والتشاحن.