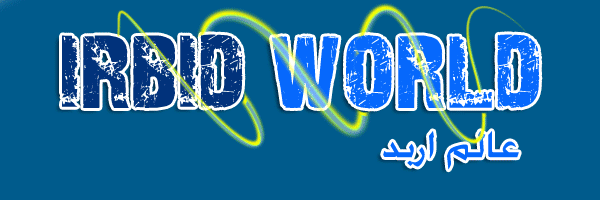عز وجل - في كتابه العزيز، وهو أصدق القائلين: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْـحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْـمُشْرِكُونَ) [التوبة: 33].
فالله - عز وجل - أرسل رسوله بهذا الدين الحق ليظهر على سائر الأديان، لا لينزوي ويندرس، وهذا الظهور: ظهور معنوي بالحجة والبرهان، وظهور مادي بالقوة والتمكين والغلبة كما في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها))[1].
ولا يعارض هذا الظهورَ الذي قرره الله - سبحانه - في كتابه كونُ المسلمين في ضعف في بعض الأماكن والأزمان؛ فذلك شيء مؤقت لا يدوم..ولا يلبث أن يزول، ويجدد الله للأمة دينها ويعلي شأنها، وليس أدلَّ علـى ذلـك مـن أن المسـيح بن مريم - عليه السلام - حين ينزل إلى الأرض في أواخر الزمان يحكم بالإسلام، ويكون كرجل من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، ويكون ذلك ظهوراً لهذا الدين بلا شك.
أما اندراس الدين وذهابه بالكلية فذلك لا يكون إلا في نهاية الزمان، قبيل قيام الساعة، وذلك حين يأذن الله - عز وجل - بإنهاء الحياة على هذه الأرض وإقامة القيامة؛ ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قــالت: سمعــت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبَد اللات والعزى))، فقلت: يا رسول الله! إن كنتُ لأظن حين أنزل الله - عز وجل -: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْـحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْـمُشْرِكُونَ) [التوبة: 33].
أن ذلك تامٌّ، قال: ((إنه سيكون من ذلك ما شاء الله - عز وجل - ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم))[2].
فهؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، وذلك - كما قلنا - إنما يحدث في نهاية الزمان تمهيداً لأخذ الله لمن بقي على الأرض لإقامة القيامة، ولا يعارض الآية التي أخبرت بظهور الدين؛ إذ هذه الحقيقة لا شك في تحقُّقها على توالي القرون منذ بعثته - صلى الله عليه وسلم - وإلى نزول عيسى بن مريم إلى الأرض، رغم تربُّص الكافرين وتمنِّيهم ذهاب هذا الدين وعملهم على إخماده: (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْـحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْـمُشْرِكُونَ) [التوبة: 32 - 33]
إن قلوبنا ينبغي أن تمتلئ ثقة ويقيناً بذلك الخبر الصادق من الله - عز وجل - وذلك القضــاء الــذي لا يُــرَدُّ حتــى لا نيأس ونتخاذل، وكم كانت ثقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الله لا بد ناصرٌ دينه ومتمٌّ أمره، ولو بعد حين؛ فقد روى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول: إنما اتَّبَعه ضَعَفة الناس ومن لا قوة له، وقد رَمَتهم العرب، أتعرف الحيرة))؟ قال عدي: لم أرَها وقد سمعت بها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فوالذي نفسي بيده ليُتمَّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جِوَار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز))! قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: ((نعم! كسرى بن هرمز، وليُبذلنَّ المال حتى لا يقبله أحد))[3].
قال عدي بن حاتم: (فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جِوار أحد، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده! لتكونن الثالثة؛ لأن رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - قد قالها، وقـد حدثت الثـالثـة فـي عهــد عمر بن عبد العزيز، - رحمه الله -؛ حيث كان يبعث عامله بالصدقات فيطوف بها في البلاد ولا يجد من يقبلها حتى يرجع بها كما هي).
ولا يظن أحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبشِّر بهذه البشارات إلا وهو على أعتاب النصر وبدايته، بل كان يبشِّر بمثل هذه البشارات في أحلك الظروف وفي أوقات عصيبة شديدة تتزلزل فيها الجبال وينفذ فيها اليأس إلى القلوب، نعم! كانت تصدر منه - صلى الله عليه وسلم - كلمات الواثق بنصر الله وهو يعاني مع أصحابه صنوف الأذى والشدائد، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم ييأس ولم يتردد في المضي حتى الموت في سبيل إعلاء أمر الله... ولقي في ذلك صنوفاً من المقاومة والإيذاء: تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، تارة بالوعد وتارة بالوعيد؛ فما وَهَن وما ضعف وما استكان. جاء المشركون إلى عمه أبي طالب يطلبون منه أن يكف محمداً - صلى الله عليه وسلم - عن دعوته، فقال أبو طالب: يا ابن أخي! قد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تُسمِعُهم ما يؤذيهم، فإن رأيتَ أن تكف عنهم. فحلَّق ببصره إلى السماء، فقال: «والله! ما أنا بأقدر أن أدع ما بُعثْتُ به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار»[4].
إنه ثبات أي ثبات، وعزيمة ومُضِي لإظهار أمر الله، عابوه وهمزوه ولمزوه، وسفَّهوه وصدوا الناس وشغلوهم عنه بالأحاديث الباطلة، ورموه بالجنون والسحر والكهانة، واعتدوا عليه بالأيدي محاولين خنقه تارة، وقَتْله بالحجارة مرة أخرى، وتجويعه ومن معه من المسلمين، ولقي ما لم يلقَ أحدنا اليوم شيئاً منه، ولك أن تتخيل الدماء تسيل من قدميه - صلى الله عليه وسلم - والسفهاء يلاحقونه بالحجارة، ولك أن تتصور المشركين حوله يجذبونه وأحدهم آخذٌ بمجمع ردائه يريدون خنقه، كل ذلك وهو - صلى الله عليه وسلم - يزداد قوة وثباتاً وإصراراً وثقة بوعد الله ونُصرَته.
أما أصحابه؛ فقد ذاقوا الكثير؛ فكان بلال يُخرَج إذا حميت الظهيرة فَيُطرح على ظهره في بطحاء مكة وتوضع الصخرة العظيمة على صدره، ويقال له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فما كان من بلال وهو في ذلك البلاء إلا أن يقول: أحد أحد، وكان عمار بن ياسر ووالداه يخرجهم المشركون إذا حميت الظهيرة يعذبونهم في رمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يستطيع أن يدفع عنهم شيئاً فيقول: ((صبراً آل ياسر! موعدكم الجنة))[5].
فلا يدور في نفوسهم شك أو تردُّد وهم يرون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر بهم فلا يدفع عنهم شيئاً ولا يدفع الله عنهم شيئاً؛ حتى قَتَلوا أم عمار، وهي تأبى إلا الإسلام.
قال سعيد بن جبير: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العذاب ما يُعذَرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله! إن كانوا ليعذِّبون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً، ولما اشتد عليهم الأمر ذهبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشكون له، كما يقول خباب - رضي الله عنه -: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسدٌ بردةً في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله! ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال: ((لقد كان مَنْ قبلَكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيُجعل فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، واللهِ لَيُتمَّن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون))[6].
واليوم ينظر المسلم إلى الواقع فإذا به يجد الزمان قد استدار كهيئته يوم كان الإسلام غريباً أول مرة ويوم كان المسلمون مضطهدين...
وما فتئ الزمـانُ يـدُورُ حتَّى *** مضى بالمجـدِ قـومٌ آخـرونَا
وأصبحَ لا يُرَى في الركْبِ قومِي *** وقـد عـاشوا أئمَّتـه سِنينَـا
ينظر المسلم إلى الواقع فيجد الفساد قد ظهر في البر والبحر، ولم تخلُ منه ناحية من نواحي حياة الناس:
- فساد في العقائد: من شرك ووثنية وخرافات وخضوع لغير الله.
- وفساد في السلوك: من فجور وفواحش وخمور وعري وتبرُّج وحياة كحياة الأنعام بل أضل.
- وفساد في الاقتصاد والأموال: من ربا ومكوس وتلاعُب ونهب وغصب.
- وفساد في مختلف أنظمة الحياة: من ظلم وعسف وسنٍّ لشرائع ما أنزل الله بها من سلطان، وذلٍّ للكافرين وموالاة لأعداء الله، وإيذاء لأولياء الله وأجواء من الذلة والعبودية لغير الله...
- وفساد في التعليم: من إماتة وتشويه للدين واستبدال الفتنة بالغرب أو الشرق أو العبودية والولاء لشعارات جوفاء... بالدين، وإهمالٍ لجو التربية الإسلامية والقدوة الإيمانية...
أنواع وأشكال متأصلة متمكنة من الفساد في كل ناحية من النواحي؛ حتى إن الكثيرين قد يساورهم اليأس والشك في وعد الله، ويلقي الشيطان في قلوبهم الوهن والتخاذل والخوف من مواصلة الطريق.
وهنا لا بد أن يفيء أولئك إلى تذكير الله - عز وجل - إذ يقول: (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِـمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) [آل عمران: 146]، وليتذكر هؤلاء قوله - عز وجل -: (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [يوسف: 21]، (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْـحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْـمُشْرِكُونَ) [الصف: 8 - 9].
فوعد الله آتٍ لا محالة وهذا الدين لا بد منتصر، ولَيزيدَن تمكُّناً وانتشاراً في الأرض، وهــا هــي بشــارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: ((ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعزِّ عزيز أو بذُلِّ ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاَّ يذل به الكفر))[7].
ولكن تحقُّق هذا الوعد له مقدمات وأسباب، منها: أن نكون في تقوانا وإخلاصنا أهلاً لذلك، وأن نكون قدم صدق في الاستعداد للثبات والتضحية فــي وجــه الفــتن أو المساومات.
إن بداية النصر تأتي من داخل النفس وانتصارها على نفسها وتطهُّرها من أدرانها، وما أجمل ما ذكره الله - عز وجل - عن أتباع الأنبياء وما فعلوه وقالوه لَـمَّا أصيبوا وأوذوا في سبيل الله حتى ينصرهم الله: (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِـمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: 146 - 147]؛
أي إنهم اتجهوا إلى داخل نفوسهم، فالتفتوا إلى ذنوبهم ودعوا ربهم أن يغفرها لهم ويغفر لهم كل إسراف وتجاوز لحدوده، وهي التفاتة يغيب ويذهل عنها كثير منَّا في وقت الشدة والفتنة، وحين يتطلع إلى النصر ورَفْع الفتنة، ثم قالوا: (وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا) وهو أمر كذلك يكون في داخل النفس؛ فالثبات يبدأ من ثبات القلب وطمأنينته. نسأل الله أن يرزقنا ذلك وينعم علينا به.
فتلك دروس من القرآن نتعلم منها كيف أن بداية الأشياء تكون من داخل النفـس، وأن أي تغييـر يجـب أن يبدأ من تغييــر ما بالنفس، (إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) [الرعد: 11]؛
فحين يعلم الله منا صلاح الداخل وسلامة القلب وثباته والاستقامة على دينه وشرعه والانخلاع عن التعلق بأي شيء غير الله ودعوته والعيش في الدنيا كالغريب أو عابر سبيل... حين يعلم الله منا ذلك ينقل خطانا بعنايته وحفظــه ويكــرمنا بمعيته ونصره، كما قال - سبحانه وتعالى -: (إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ) [النحل: 128].
ومن هنا نعلم أهمية تلك الوصايا الجامعة العظيمة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبني بها أصحابه ويؤهلهم بها لإحراز الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، سأله رجل أن يقول له في الإسلام قولاً لا يسأل عنه أحداً بعده، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((قل: آمنت بالله، ثم استقم))[8].
ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لآخَر: ((اتقِ الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حَسَن))[9].
وقوله لابن عمر: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل))[10].
وقوله لرجل سأله عن شيء يتشبث به: ((لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله))[11].
وقوله لابن عباس: ((احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعَت الأقلام وجفت الصحف))[12].
اللهم ارزقنا إيماناً راسخاً، ويقيناً صادقاً، وصبراً واسعاً، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.
ــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه أحمد: (5/278، رقم 22448)، ومسلم: (4/2215، رقم 2889).
[2] أخرجه مسلم: (8/182، رقم 7483).
[3] أخرجه أحمد: (4/377، رقم 19397)، والحاكم: (4/564، رقم 8582) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
[4] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: (8/252، رقم 8553)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/8): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى باختصار يسير من أوَّله، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
[5] أخرجه الطبراني: (24/303، رقم 769)، وقال الهيثمي (9/293): رجاله ثقات. وقال الألباني في تحقيقه لفقه السيرة (103): حسن صحيح.
[6] أخرجه أبو داود: 2649، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وفي صحيح الجامع 4450.
[7] أخرجه أحمد: (4/103، رقم 16998)، والطبراني: (2/58، رقم 1280)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/14): رجال أحمد رجال الصحيح، والحاكم: (4/477، رقم 8326)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
[8] أخرجه أحمد: (3/413 رقم 15454)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[9] أخرجه الترمذي: (1987)، والدارمي: (2791)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: (97).
[10] أخرجه البخاري: (6416)، كتاب الرقاق.
[11] أخرجه الترمذي: (3375)، وابن ماجه: (3793)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (2687).
[12] أخرجه الترمذي: (2516) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع: (7957).