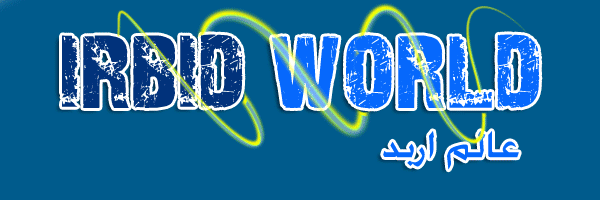من
الأساليب القرآنية التي اعتمدها القرآن الكريم تثبيتاً لمعاني الإيمان،
وتبياناً لأحكام الإسلام ضرب الأمثال، وهو أسلوب يُظهر المعنى المجرد بمظهر
الواقع محسوس، بحيث يكون أقرب إلى فهم المتلقي، وأوضح في بيان المقصود من
الخطاب القرآني.
ومن الأمثلة القرآنية التي ضربها القرآن الكريم لبيان أهمية الإنفاق في وجوه الخير، ما جاء في قوله تعالى: { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم }
(البقرة:261)، فقد بيَّن سبحانه أن مثل من ينفق ماله في سبيل الله كمثل
عود القمح الذي يحمل سبع سنابل، وتحمل كل سنبلة منه مائة حبة، بمعنى أن
الله سبحانه يضاعف له ما أنفقه أضعافاً مضاعفة.
فمن خلال هذا المثل الحسي المشاهد والحي، يدرك المؤمن أهمية وقيمة الإنفاق في سبيل الله.
وكان يمكن للخطاب القرآني أن يأتي بصيغة مجردة، كأن يقال مثلاً: أنفقوا من
أموالكم، ولا تبخلوا بها، فإن أنفقتم فإن الله يعوضكم خيراً مما أنفقتم،
بيد أن مجيئه على هذا النحو المجرد لن يكون له من الأثر والتأثير الذي جاء
عليه النظم القرآني.
وهذا
المثل يتضمن التحريض على الإنفاق في كل ما هو طاعة، وعائد نفعه على
المسلمين، فإن المال الذي يكد الإنسان في جمعه، هو عطاء من ربه { كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا } (الإسراء:20)، { والله يرزق من يشاء بغير حساب }
(البقرة:212). ولكن الرزق قد يكون نعمة على صاحبه، وقد يكون نقمة؛ فإن
أنفقه في وجوه الخير كان نعمة، وإن بخل به، وسعى في كنزه وادخاره كان نقمة.
فالله
سبحانه يضرب لنا مثلاً على الإنفاق في وجوه الخير والبر بالزرع الجيد
المعطاء؛ فالإنسان يبذر الحبة، التي لا تنبت عادة إلا سنبلة واحدة، فإذا
أنبتت سبع شعب في رأس كل منها سنبلة، وفي كل سنبلة مائة حبة، فإن الحبة
الواحدة تكون قد أعطت سبعمائة حبة. وهكذا فضل الذي ينفقون في سبيل الله،
كما يبرزه لنا المثل القرآني.
وقد يستغرب البعض كيف للسنبلة أن تحمل هذا العدد من الحَبِّ؟ ولكن لا غرابة إذا علمنا أن الله هو المنبت، { وأنه على كل شيء قدير } (الحج:6) { إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون } (يس:82)، { أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } (:64) والحبة في حقيقة أمرها سبب، أُسند إليها الإنبات، كما أُسند إلى الأرض والماء، لكن المنبت الحقيقي هو الله سبحانه { الله خالق كل شيء }
(الرعد:16)، فلا غرابة إذن أن يضاعف سبحانه نتاج الحبة، وهو المنان،
المعطاء الكريم، ذو الجلال والإكرام، ذو القوة المتين، الفعال لما يريد.
ومن
المهم أن نعلم، أن التمثيل هنا ليس إلا تصويراً للأضعاف، كأنها ماثلة أمام
عيني الناظر. فكل نفقة في سبيل الله يعادلها الله أضعافاً كثيرة، { فيضاعفه له أضعافا كثيرة } (البقرة:245)، { والله واسع عليم } (البقرة:247)، وليس المراد بالضرورة حقيقة العدد.
وللمفسرين كلام طيب حول بيان مرمى هذا المثل والمراد منه، نختار من كلامهم الآتي:
يقول ابن عاشور :
"وقد شبه حال إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها، وما أُعطي من الثواب لهم
بحال حبة أنبتت سبع سنابل...، أي: زُرعت في أرض نقية وتراب طيب، وأصابها
الغيث فأنبتت سبع سنابل. وحذف ذلك كله إيجازاً؛ لظهور أن الحبة لا تنبت ذلك
إلا كذلك، فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس، والمشبه به هيئة معلومة، وجعل
أصل التمثيل في التضعيف حبة؛ لأن تضعيفها من ذاتها لا بشيء يزاد عليها".
أما سيد قطب فيحلل
هذا المثل القرآني تحليلاً أدبياً فكريًّا، فيقول: "إن الدستور لا يبدأ
بالفرض والتكليف، إنما يبدأ بالحض والتأليف. إنه يستجيش المشاعر
والانفعالات الحية في الكيان الإنساني كله. إنه يعرض صورة من صور الحياة
النابضة النامية المعطية الواهبة، صورة الزرع. الزرع الذي يعطي أضعاف ما
يأخذه، ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره.
إن
المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى
سبعمائة حبة! أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل؛
وأكثر استجاشة للمشاعر، وتأثيراً في الضمائر. إنه مشهد الحياة النامية.
مشهد الطبيعة الحية. مشهد الزرعة الواهبة. ثم مشهد العجيبة في عالم النبات:
العُود الذي يحمل سبع سنابل. والسنبلة التي تحوي مائة حبة!
وفي
موكب الحياة النامية الواهبة يتجه - القرآن - بالضمير البشري إلى البذل
والعطاء. إنه لا يعطي بل يأخذ؛ وإنه لا ينقص بل يزاد. وتمضي موجة العطاء
والنماء في طريقها. تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلة..إن
الله يضاعف لمن يشاء. يضاعف بلا عدة ولا حساب. يضاعف من رزقه الذي لا يعلم
أحد حدوده".
وأما الشيخ رشيد رضا فقد
حلل هذا المثل القرآني تحليلاً نفسياً اجتماعياً، وذكر حوله كلاماً لا
ينبغي أن يُغفل عنه في مثل هذا المقام، حيث قال: "أمر الإنفاق في سبيل الله
أشق الأمور على النفوس، لا سيما إذا اتسعت دائرة المنفعة فيما ينفق فيه،
وبعدت نسبة من ينفق عليه عن المنفق؛ فإن كل إنسان يسهل عليه الإنفاق على
نفسه وأهله وولده، إلا أفراداً من أهل الشح المطاع، وهذا النوع من الإنفاق
لا يوصف صاحبه بالسخاء، ومن كان له نصيب من السخاء سهل عليه الإنفاق بقدر
هذا النصيب، فمن كان له أدنى نصيب، فإنه يرتاح إلى الإنفاق على ذوي القربى
والجيران. فإن زاد أنفق على أهل بلده فأمته فالناس كلهم، وذلك منتهى الجود
والسخاء. وإنما يصعب على المرء الإنفاق على منفعة من يبعد عنه؛ لأنه فُطر
على ألا يعمل عملاً لا يتصور لنفسه فائدة منه، وأكثر النفوس جاهلة باتصال
منافعها ومصالحها بالبعد عنها، فلا تشعر بأن الإنفاق في وجوه البر الهامة،
كإزالة الجهل بنشر العلم، ومساعدة العجزة والضعفاء، وترقية الصناعات،
وإنشاء المستشفيات والملاجئ، وخدمة الدين المهذب للنفوس هو الذي به المصالح
العامة حتى تكون كلها سعيدة عزيزة. فعلمهم الله تعالى أن ما ينفقونه في
المصالح، يضاعف لهم أضعافاً كثيرة، فهو مفيد لهم في دنياهم، وحثهم على أن
يجعلوا الإنفاق في سبيله.
فمثل
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وهي ما يوصل إلى مرضاته من المصالح
العامة، لا سيما ما كان نفعه أعم وأثره أبقى، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في
كل سنبلة مائة حبة، أي: كمثل أبرك بذر في أخصب أرض نما أحسن نمو، فجاءت
غلته مضاعفة سبعمائة ضعف، وذلك منتهى الخصب والنماء، أي أن هذا المنفق يلقى
جزاءه في الدنيا مضاعفاً أضعافاً كثيرة، كما قال سبحانه: { فيضاعفه له أضعافا كثيرة } (البقرة:245). فالتمثيل للتكثير لا للحصر؛ ولذلك قال: { والله يضاعف لمن يشاء }،
فيزيده على ذلك زيادة لا تقدر ولا تحصر، فذلك العدد لا مفهوم له، ولا يحد
عطاؤه عليم بمن يستحق المضاعفة من المخلصين، الذين يهديهم إخلاصهم إلى وضع
النفقات في مواضعها التي يكثر نفعها، وتبقى فائدتها زمناً طويلاً،
كالمنفقين في إعلاء شأن الحق وتربية الأمم على آداب الدين وفضائله التي
تسوقهم إلى سعادة المعاش والمعاد، حتى إذا ما ظهرت آثار نفقاتهم النافعة في
قوة ملكهم، وسعة انتشار دينهم وسعادة أفراد أمتهم عاد عليهم من بركات ذلك
فوق ما أنفقوا بدرجات لا يمكن حصرها. فالمراد بالإنفاق هنا الإنفاق في خدمة
الدين. وكلمة في { سبيل الله } تشتمل جميع المصالح العامة.
ومن
أراد كمال البيان في ذلك، فليعتبر بما يراه في الأمم العزيزة التي ينفق
أفرادها ما ينفقون في إعلاء شأنها، بنشر العلوم، وتأليف الجمعيات الدينية
والخيرية، وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها المصالح العامة، إذ يُرى كل
فرد من أفراد أدنى طبقاتها عزيزاً بها، محترماً باحترامها، مكفولاً
بعنايتها، كأن أمته ودولته متمثلتان في شخصه، وليقابل بين هؤلاء الأفراد
وبين كبراء الأمم التي ضعفت وذلت بإهمال الإنفاق في المصالح العامة، وإعلاء
شأن الملة، كيف يراهم أحقر في الوجود من صعاليك غيرهم، ثم ليرجع إلى نفسه
وليتأمل كيف أن نفقة كل فرد من الأفراد في المصالح العامة، يصح أن تعتبر هي
المسعدة للأمة كلها، من حيث إن مجموع النفقات التي بها تقوم المصالح تتكون
مما يبذله الأفراد، فلولا الجزئيات لم توجد الكليات".
ونختم
الحديث حول هذا المثل بالقول: إن الله سبحانه من خلال هذا المثل القرآني
أراد أن يضع العلاج والدواء الشافي لشح النفوس، وطمعها في حب المال؛ وأراد
أن يستل منها نزعة الحرص، ورغبة التقتير، ويدفعها إلى البذل والعطاء
والإنفاق بسماحة وطيب خاطر، ما يجعل هذا الإنفاق عنصراً فاعلاً في بناء
الأمة اقتصادياً، وتماسكها اجتماعيًا، ووحدتها عقدياً.