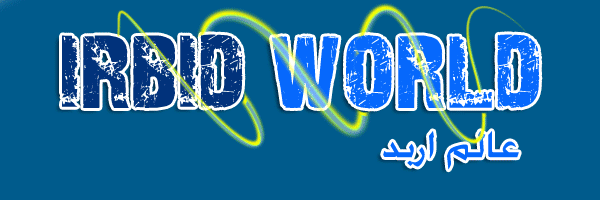أي إسـلام نــريد..؟
د. عبد الرزاق قسوم
في التاريخ الإنساني حقب ومراحل، هي عند المؤرخين بمثابة "الفواصل الزمنية" أو "محطات الاستراحة" من عناء الطريق، وقد اتسمت هذه الحقب أو المراحل التاريخية بخصوصيات معينة، استمدت معالمها من واقع الإنسان في كل زمان ومكان، فطبعتها بالطابع الإنساني العام.
لذلك تلون التاريخ البشري، بلون العقل الإنساني أثناء تحديد عصوره، كان ما يعرف بالعصر الحجري، والعصر الجاهلي، نسبة إلى مدى تطور الإنسان...
وكان ما يوصف بعصر الفتوحات عند المسلمين، والعصر المدرسي عند المسيحيين، وعصر التصنيع، وعصر النهضة، وعصر الحروب الساخنة والباردة عند الغربيين والشرقيين على العموم، وفي ضوء هذه المواصفات، يمكن وصف عصرنا الراهن "بعصر التدين" أو "الصحوة" عند البعض، وعصر "نهاية التاريخ" و "صدام الحضارات" عند البعض الآخر، أو "عصر العولمة" أو " النظام الأحادي الجديد" عند قسم ثالث.
وأيا كانت النعوت والمسميات التي تطلق على عصرنا، فإن اللافت لانتباه الراصدين للتطور الفكري الإنساني، هو موقع التدين عموما كظاهرة بارزة في الفكر الإنساني ومكانة الإسلام بصفة خاصة كحركة فاعلة في الخارطة العالمية.
إن الإسلام –على عكس ما يذهب إليه البعض- ليس مجرد ظاهرة فكرية أو اجتماعية، قد تظهر وتختفي، شأنها في ذلك شأن كل الظواهر الاجتماعية الأخرى، بل هو حركة قوية ما فتئت تنمو وتتزايد، متجاوزة حدود ما يعرف بالعالم الإسلامي، إلى كل نقاط المعمورة، لتحدث لنفسها موقعا متميزا في كل رقعة تصل إليها، ولعل ما يفسر هذه الحقيقة، الاهتمام المتزايد الذي يوليه مفكرو العالم للحركة الإسلامية، في محاولة لفهمها، واستبطان جوهرها، بغية التعامل معها من أجل سهولة احتوائها.
من هنا برز هذا الجمع الكبير من الباحثين المفكرين الغربيين في دراسة الحركة الإسلامية بتعليل عوامل نشأتها، وأسباب انتشارها، وجوانب القوة والضعف فيها، كما أثْروا القاموس السياسي المعاصر، بمعجم من المصطلحات تصب كلها في شلال النهر الإسلامي، مثل الأصولية، والإسلاموية، والتطرف، والراديكالية، والتقدمية، والتحديثية، واللائكية، ... الخ
إن القراءة المتأنية لهذه المصطلحات تفضي كلها إلى إفراز جملة من المفاهيم، فرضت على الثقافة العربية الإسلامية فأحدثت ما يمكن وصفه بصراع مفاهيم في عملية التعامل مع المصطلح، ذلك أنها مصطلحات نُحِتت في مصنع غربي خاص، وصيغت بقوالب مقدودة على قد طبيعة الثقافة الغربية ذات الإيديولوجية اليهودية المسيحية، فلما أريد تطبيقها على عقول ذوي الثقافة العربية الإسلامية، حدث هذا التوتر الذي غدا بمثابة الصدام الثقافي، المفضي إلى تصادم المفاهيم.
بما كان في ثنايا هذا التساؤل ما يثير نوعا من الغرابة، تماما كما هو الحال بالنسبة لعنوان الملف المقترح للدراسة، ولعل مبعث هذا التساؤل أنه يأتي في خضم ما يطرحه الغرب من مفاهيم نشاز، في معزوفة الثقافة العربية الإسلامية ... فقد تعودنا في هذه المفاهيم على التركيب المزجي، الذي يحول التزاوج بين الإسلام وشتى أنواع النعوت.. فهناك عندهم "الإسلام الأسود" و"الإسلام الأصفر" وهناك الإسلام الاشتراكي، والإسلام البورجوازي.. كما أن هناك الإسلام المتطرف، والإسلام المعتدل...
والحقيقة أنه لا مكان لمثل هذا المزج الغريب بين الإسلام ونعوت أخرى، ذلك "إن الدين عند الله الإسلام"، وهو القاسم المشترك الأعظم بين كل بني البشر في معتقدهم ضمن الشمولية التي هي الخاصية الرئيسية للإسلام، فلا يمكن القول بإسلام يتجه للأغنياء دون غيرهم، ولا لإسلام خاص بالملونين ونحو ذلك من التمايز الطبقي، بل إن الخاصية الأساسية للإسلام هي محو الفوارق بين الناس، وإزالة كل أنواع الطبقية المادية "فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود ألا بالتقوى"، "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
إن التمايز إذن لا يتعلق بالإسلام كدين، وإنما ينصرف إلى درجة الفهم لهذا الإسلام من معتنقيه، وطريقة ممارستهم لشعائره، وقدرتهم على تأويل نصوصه، واستنباط أحكامه، وربطهم بينه وبين واقع الناس في تكاملية رائعة هي التي تجعل من الإسلام -على خلاف باقي الديانات والمذاهب- دينا ودنيا، يحقق في واقع الناس تعادلية متناسقة ومنسجمة، تبدو غريبة على العقل الغربي، وهو ما يثير لديه إشكالا حضاريا بالغ التعقيد، مما يصعب عليه قبوله فكريا.
فأي إسلام يريدون؟ وأي فهم للإسلام نريد؟ من هذه الازدواجية تبدأ معاناة الإسلام مع الغرب، وتبدأ معاناتنا نحن المسلمين مع التصور الغربي للإسلام.
فعقدة الغرب المستعصية على الحل تتمثل في تعامله مع الإسلام من منطلق اختزالي تحيل الإسلام إلى إسلاموية، تنشر العنف وتشيع التطرف وتغدو مجرد إيدولوجيا، أو برامج أو ألوان من الأنشطة تصنع هذا الخطر الإسلاموي الذي يخوف الغرب به نفسه والآخرين.
إن هذا الاختزال للإسلام من جانب المفكرين الغربيين، هو الذي حدا ببعضهم إلى التحذير من الخطر الإسلاموي القادم على حد تعبير francois burgat في دراسته التي تحمل عنوان: "الإسلام الذي نواجهه: الخطر الإسلامي القادم ؟"، وهو ما جعل باحثا كجون إسبوزيتو John espositoيتحدث هو أيضا عن التهديد الإسلامي ضمن كتابه المعنون: الخطر الإسلامي، بين الأسطورة والواقع.
(the Islamic menace mith or reality ? ) (oxford unnivesity 1993)
إن فرانسوا بورغات هو من المفكرين الغربيين المنصفين للإسلام، هو الذي يطرح تساؤلا جريئا عندما يقول: "هل سيكون هذا الإسلاموي الخطير، هو المفاوض الوحيد أمام أوروبا، في مستقبل قريب ؟
من هذه المقدمة يصل بورغات إلى بعض النتائج يصوغها في الأحكام التالية:
- ينبغي التنبيه إلى "العنف الاستئصالي" ودوره في التغذية "التطرف الإسلاموي".
- كما ينبغي الاعتراف بالإسلامويين كترجيح سياسي بديهي، يقوم على قراءة التصاعد الإسلاموي الذي يتم بأدوات معرفية جديدة، وبعيون لا شرقية ولا غربية، وإنما بنظرات إنسانية عالموية واقعية.
إن نقطة الضعف في رؤية الغربيين للإسلام؛ أنهم ينظرون إلى الإسلام بمنظار كاثوليكي، ويحكمون على أحكامه وقِيَمه من رؤية غربية قِوامها مصلحة الغرب، واستراتجيها بسط النفوذ الغربي، ومحاولة إخضاع ما سواه لهيمنته.
من هنا يبدأ التباين بين رؤيتنا للدين عموما، وللإسلام بصفة أخص، ففي حين يتعامل الغرب مع الإسلام كخط قادم يبشر بالعنف وينذر بالحرب، ويرفع لواء العصيان في وجه الغرب ومخططاته التوسعية، العلمانية، الاستئصالية، ننظر نحن إلى الإسلام كحصن نلوذ به لحماية الذات وإثبات وجودها وصيانتها من الذوبان.
وإذا كان الغرب يحاول تطبيق المنطق الكنسي على الإسلام، فإن صراع المفاهيم بيننا وبينه يبدأ من هذه النقطة التي تعتبر العلمانية تعطيلا أو إلغاء للشريعة، ومحالة إبعادها من الحياة اليومية في التعامل للمواطن، أي فصل الدين عن الدولة لتحقيق استقلالية كل قطاع عن الآخر.
فالأصل في المسيحية أنها تفصل بين الدين والدولة تجسيدا لشعار السيد المسيح عليه السلام القائل: "أعطوا ما لله لله، وما لقيصر لقيصر" ولذلك لا يمكن التلاقي ـ والحالة هذه ـ مع الغرب المنزعج من مكونات الذات الغيرية التي قوامها العروبة والإسلام، المحصنة بالدين.
في هذه العلاقة المتوترة بين الإسلام والغرب تبرز حقيقة هامة، هي الفراغ الإيديولوجي لدى العقل المسلم، الذي فشل الغرب بمنهجه الغريب عن الفكر الإسلامي في ملأه، في حين نجح الإسلام -من خلال القيم والمبادئ التي يقدمها للعقل المسلم- في محاولة الإجابة عن مختلف تساؤلات الشباب عقديا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، فكانت قوة الإسلام الأصيلة وضعف المناهج الغربية الوافدة.
أية ممارسة لشعائر الإسلام نقدم؟... إن المعطيات النظرية، لتصور الغرب للإسلام تلقي علينا وعليه مسؤولية ثقيلة تتمثل في المنهج التغييري للنظرة من الجانب الغربي، والمنهج التفسيري للإسلام من جانب عرضنا له على الناس.
فما زالت الإشكالية قائمة بالنسبة لنا نحن المسلمين، في تبني أفضل الطرق، وأنجع الأدوات المعرفية لتقديم الإسلام .. فمن خلال الطرق المتبناة يمكن عرض الإسلام في قوالب متعددة: إما أنه الرافض لكل ما حوله، الكافر بعلوم الغرب وتكنولوجيته، المتقوقع المنغلق على أتباعه ومريديه.. وهو ما يمثل خيانة لروح الإسلام نفسه...
أو أنه دين المستسلمين الخائفين، الخاضعين، المنسحبين من الواقع المجتمعي، الناشدين للفناء في الله، وهو ما يجسد الفهم الخاطئ لجوهر الإسلام ومبادئه.
وهل يمكن تقديم الإسلام للناس على أنه دين "الذبح الحلال" و "القتل الجماعي" و"الإرهاب الأعمى" و"سبي الحرائر" و"ترويع الآمنين من الناس" ؟
معاذ الله! إن ألد أعداء الإسلام، هم المنسوبون إليه، من الذين يلصقون به هذا الفهم الخاطئ، فيلوون ألسنتهم بالكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون" [وإن كانوا لا يعلمون].
مشكلة الإسلام مع بعض أتباعه إذن- تتمثل في جهلهم بالإسلام أساسا، وممارستهم الخاطئة لشعائره، وهو ما قد يحسب -من غير المسلمين- جزء من الإسلام، فيحمّلونه تبعات كل ذلك.
والحقيقة أن في المجتمع الإسلامي، ماضويون تقليديون في خطابهم، يقدمون الإسلام للناس على أنه الموسوعة الصيدلانية المشتملة على كل أنواع الأدوية، لمختلف الأمراض، مثبتين بذلك عجزهم عن مسايرة تقدم الفرد والمجتمع معا.
وبالمقابل نجد اليوم في المجتمع الإسلامي دعاة منهج تبليغي يقلدون به المنصِّرين، في احتكاكهم بالإنسان داخل الأسرة والمصنع، وبيت الشباب، للتعايش مع مشاكلهم، ومساعدتهم على حلها، لدعوتهم بعد ذلك إلى العودة على الدين، وبلاغهم كلمة الله، ولا عيب في هذا المنهج إلا في عجز من يتطوعون للقيام به، فيكون مثلهم كمثل الساعي إلى الهيجاء بدون سلاح .. والحامل لرسالة دون امتلاك الاستعداد أو القابلية للتبليغ.
على أن هناك فريقا ثالثا يعجبك قوله في الدعوة إلى الإسلام، لأنه يدغدغ عواطف الإنسان المسلم، فهو يرفع شعار تحرير هذا الإنسان من كل قيوده الغرائزية، والمادية، والسياسية، وبالتالي تحرير المجتمع نفسه من عقدة الخضوع للتسلط القائم على الظلم والقمع والإذلال، إن هذا اللون من الفهم للإسلام، في ممارسة شعائره هو القائم على "تسييس الإسلام"، وهدفه هو تحرير المجتمع أو الأمة الإسلامية من التبعية للغرب، والعمل على التقليل من الفوارق الاجتماعية بإثارة الأغلبية للضرب سياسيا على أيدي الأقلية الطفيلية الحاكمة المتنفذة، التي تمتص خيرات الأمة على حساب تنميتها وسعادتها، لقد خرج أنصار الإسلاموية التغييرية، كحركة نابغة من رحم المجتمع، تترجم عمق أصالته، رافضة أن تكون حركة مستوردة، أو مؤتمرة بأوامر الغير، تحت أي لون من ألوان التبعية أو العمالة. إنها تعتبر نفسها ترديدا للأصوات المبحوحة التي ظل يطلقها الجيل الجديد الحائر، المأزوم ضمن التوتر الذي يطبع علاقات الأجيال، ويبرز أزمة القيم التي تردى فيها المجتمع الإسلامي.
لذا يمكن اعتبار الإسلاموية السياسية، أقرب الممارسات لمشاعر الإنسان المسلم، لأنها تعبر عن تجسيد لعقم الأنظمة المتعسفة في ممارستها، بحيث أحدثت صدمة حضارية بين طموحات القوى الحية في الأمة ولا سيما شبابها، وبين ما يعرض على هذه القوى من قشور حضارية غربية، مستفزة لشعور وأخلاق وقيم الأمة.
غير أن نقطة الضعف الجامعة بين مختلف أنظار المنهج التغييري الإسلاموي، تتجلى فيما يمكن اعتباره "عقدة المنهج"، فما يزال دعاة الإسلاموية يعانون تمزقا أمام المنهج الذي ينبغي الأخذ به في تطبيق الشريعة: هل يأخذون بنصية الخطاب في التطبيق، أم بمقاصدية هذا الخطاب في الهدف ؟
هل يتبنون الفقه الحركي المنفتح، والمتفاعل مع مشاكل الإنسان في الحياة ؟ أم هل يأخذون بالفقه المقاصدي، الرافع لشعار "حيث مصلحة الأمة فثم شرع الله" ؟
لنخضع تجربة أصحاب المنهج التغييري الإسلاموي لعملية التحليل والنقد، فنعرضه على الواقع النابع منه، والهادف إلى تغييره، حتى يمكن في ضوء ذلك استخلاص المنهج التكاملي الشمولي، الذي لا يؤمن بالتجزيئية في العلاج ولا بالاختزالية في التشخيص، وإنما يكون منهجا متكاملا، ينظر إلى الإنسان وإلى المنهج نظرة كلية شاملة.
أين يقف فقه الفكر، وفكر الفقه، من أزمة المنهج التي يعانيها الفقه الإسلامي اليوم، وسط حملات التشويه التي تستهدف الحركة الإسلامية عموما وتنعتها بشتى أنواع النعوت، كالإرهاب، والعنف، والغلو، والتطرف؟.
وهل يسلم دعاة الحركة الإسلامية، بما ينعتون به من عنف، وإرهاب، وتطرف، وغلو؟
إن مما لا جدال فيه، أن الغلو موجود لدى الطرفين، وان العنف ممارس بطريقتين مختلفتين.
فالخطاب الإسلامي المعاصر من جهته يعاني عنفا في ذبذبة أمواجه، حيث يوظفه البعض في مناصبة العداء لفئات مختلفة من المجتمع، بدءًا بالحكام، والعلماء، والمثقفين، وانتهاء بالأغنياء، والنساء معتبرين الجميع سببا مباشرا في انحراف المجتمع عن طريق الله، وعقبة في سبيل تطبيق شريعته.
ولنأخذ مناصبة بعض الإسلامويين للعداء للمرأة، فهم يحرمونها من ممارسة حقها الاجتماعي، كالعمل والدراسة وحرية اختيار الشريك، وفي ذلك تعطيل لطاقة اجتماعية هامة في المجتمع ـ وقد ينصب عنف هذا الخطاب على قضايا جزئية من حياة المجتمع، كالاختلاط بين الجنسين، ومسألة النقاب، ومصافحة المرأة، والسدل في الصلاة أو القبض، وحرمة جواز التصوير، وسماع الموسيقى، وهي كلها قضايا أقل ما يقال فيها أنها قضايا فقهية خلافية، قصارى القول فيها، فتوى يصدرها مجمع فقهي إسلامي، أو دار إفتاء، أو عالم له تضلعه في مجال الفقه. ويتخذ الغلو في مواضع أخرى طابع العنف، حينما يعمد إلى تسييس الدين، فيحل التفكير محل التقدير ويفرض منطق المغالبة بدل منطق المطالبة، وبذلك يوظف النص الديني لصالح النص السياسي.
أما الأسلوب الآخر للعنف، فهو الذي يمارس من طرف الحكام في شكل قمع أعمى، وظلم فاضح، ومصادرة لحق المواطن في التعبير أو المشاركة في اتخاذ قرار المصير.
إن هذا اللون من العنف قد أدى إلى رد فعل أعنف، تمثل في غلو الحركة الإسلامية، في تكفير الحكّام جميعا، واعتبارهم "طاغوتا" واتهام العلماء بممالئة هؤلاء الحكام، ومساعدتهم على ممارسة إسلام مؤسساتي تبريري يكون رهن النظام السياسي، يصدر الأحكام والفتاوى حسب المقاس والطلب، ليفضي في النهاية إلى استيراد نموذج من التعامل مع الحكام بمنهج يسالم ولا يهدد، ويساوم لا يقاوم.
وإلى عنف الحاكم، يضاف العنف الإعلامي ممثلا في الاعتداء على عقول الناس، وذبح قِيَمهم وفضائلهم، وإن هذا لهو أخطر أنواع العنف الممارس على الإنسان المسلم في مجتمعه.
إن هذا العنف والعنف المضاد، قد ولد في القاموس السياسي الإسلامي ما يصفه جيل كيبيل GILLES KIBEL في كتابه "مثقفو ومناضلو الإسلام المعاصر"،
Intellectuels et militants de l islam contemporain بصراع "المستضعفين والمستكبرين"، وعبر عنه فهمي هويدي "بالتدين المنقوص"، ووصف أصحابه الشيخ يوسف القرضاوي "بالظاهرين الجدد".
إن عجرفة المستكبرين وحلفائهم هؤلاء الذين أحلو لأنفسهم إهدار المال العام، وجناية سياستهم المجحفة، بالتسبب في تبعية دولة -غنية بمواردها- في خبزها، على الاستيراد من الخارج، قد كان العنف الذي ولد العنف المضاد، وكوَّن نموذجا من العلماء هم من يُعرفون بعلماء السوء، والويل كل الويل لدعاة الفقه الحركي، أو الفقه المقاصدي إن هم حاولوا الوقوف في وجه هؤلاء المستكبرين دفاعا عن المستضعفين، فإنهم سوف يلقون من العناء، ما يجعلهم يغيبون طوعا أو يغيبون كرها، كما يقول فهمي هويدي ...
من هنا، ضاع البحث عن فهم صحيح للإسلام يقود إلى ممارسة سليمة لشعائر الدين، تكون في مستوى نقاوة، وصفاء، وحكمة الإسلام، الدين السماوي الذي يمزج الشريعة بالحياة فتكون الصحوة التي تزاوج بين الدين -بقيمه، وأحكامه وقوانينه- والحياة بتنميتها، وعلومها، وتكنولوجيتها.
ما هو النموذج الإسلامي الذي نريده لأنفسنا وللآخرين؟
أنريد نموذجا لدين صدامي، يقيم الفتنة بين أفراد الأمة، ويبث العداوة والبغضاء بين الفئات الاجتماعية؟ أم نريده تدينا قوامه المصالحة مع أهله، وشعاره المصافحة للآخرين؟
وهذه الصحوة التي نفتخر بها، وندعو إلى إشاعتها، أهي الصحوة الدينية العقلية والفكرية التي تشمل الجانب العلمي، والإيديولوجية في حياة المجتمع الذي نشأت بين أحضانه؟ أم أنها الدعوة التي اختزلت وشوهت، لتستحيل في النهاية إلى مجرد خزان للعنف، ومصنع للبارود؟؟..
الخاتمــة:
إننا مدعوُّون إلى ممارسة إسلام سمح تسامحي قوي الحجة، واثق بمبادئه وقيمه، قادر على مخاطبة الآخرين من منطلق الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
ولكي يتحقق ذلك، فإن الحركة الإسلامية ـ وهي المؤتمنة على تبليغ دين الله ـ مدعوة إلى تجديد منهجها، بدءا بتجديد فهمها للإسلام، واستنباط أدوات معرفية تساير تطور الإنسان المعاصر، وتواكب متطلبات عقله.
وإن تأكيدنا على تجديد الفهم والمنهج من طرف دعاة الحركة الإسلامية، لا يعفي أطرافا أخرى من تغيير النظرة، وتحديث أسلوب التعامل، وفي مقدمة هؤلاء مفكرو الغرب، وحكام المجتمع الإسلامي، ووسائل الإعلام هنا، وهناك ـ ونعتقد أن تحقيق ذلك كله، يبدأ باتباع الخطوات التالية:
أ. الغـــرب:
1. تحلي الغرب ولا سيما مفكروه – بالموضوعية العلمية في دراستهم للإسلام، وذلك بعدم توظيف شكوك المسلمين أو انحراف بعضهم، في الحكم على الإسلام أولا، وبعدم الخلط بين المنطق الكنسي المسيحي، والمنهج الحركي الإسلامي، فلكل ذهنيته المتميزة، وطريقته الخاصة
2. تعامل الغرب مع الحركة الإسلامية، على أنها النابض الحقيقي، بحقيقة ومشاعر وطموحات المجتمع الإسلامي، بمختلف فئاته، مهما بدا في هذه الحركة من أعراض تأزم، أو مظاهر خطإ، ذلك أنها تظل – ديمقراطيا – هي المعبر عن رأي أغلبية الأمة.. ولأن نخطئ التقدير باسم الأغلبية خير من أن نخطئ المصير مع الأقلية.
3. تنبيه الغرب إلى حقيقة هامة، وهي أن الحركة الإسلامية ضحية صراع حضاري مع الغرب، وليست سببا لنشوبه، وعلى المفكرين الغربيين - وقد بدأوا يظهرون – أن يؤكدوا على مثل هذه الحقيقة، حتى يجنبوا أنفسهم، بذور العداوات الناشبة بين الغرب والإسلام، في جميع أنحاء العالم.
4. إدراك الغرب خطأه التقديري والتقريري، في اعتبار الإسلام عدوه الأكبر، وخطره القادم، وصدامه المحتمل.
إن الحركة الإسلامية حركة عقلية تغييرية، هدفها النهوض بالمجتمع من هوة التخلف الاقتصادي، والتقهقر الثقافي والسقوط الحضاري، والتبعية السياسية، وإن هذا لحق من حقوق الإنسان، والشعوب التي يسلم بها الجميع ..
ب. الحُـــكام:
1. تحلي الحكام المسلمين بقدر معين من الديمقراطية التي ينادون بها في ميدان الممارسة، وذلك بإشراك الفئات المثقفة في صنع قرار مصيرها ومستقبلها، والاستماع أكثر إلى صوت المعذبين من المستضعفين، والطبقات المحرومة.
2. التسليم بمبدأ التداول على السلطة، واعتبار كل مواطن صاحب حق في المشاركة في هذه السلطة، وبالتالي فسح المجال له، سيما إذا كان عاكسا للشريحة المجتمعية الكبرى، كما هو الشأن بالنسبة للحركة الإسلامية..
3. تبني الحكام المسلمين لمبدأ "حوار لا مواجهة" .. على حد تعبير المفكر الإسلامي كمال أبو المجد... ذلك أن المواجهة بين الدول وأبنائها، هي أكبر عار يسجله التاريخ الوطني على تلك الدولة .. وأن الدم المراق مهما كان المتسبب فيه، فإن تبعته الكبرى تعود بالدرجة الأولى على الدولة، على اعتبار أنها حامية الإنسان، والمؤتمنة على دماء المواطنين.
4. اقتراب الحكام من الشريعة الإسلامية، الذي هو عامل القوة لهم، وليس عامل ضعف _فهم مسلمون وينحدرون من أصول إسلامية، ويتحملون باسم الدساتير التي أدوا اليمين على احترامها وتطبيقها مسؤولية تجسيد هذه الدساتير في الواقع والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة.
5. حماية الديمقراطية من الإسفاف، والابتذال وذلك بالضرب على أيدي العابثين والمسفين باسم الديمقراطية، من الذين يحلون لأنفسهم إهدار مال الأمة دون محاسب أو رقيب، وفي غفلة من أغلبية الأمة _والذين يستخدمون المنابر الإعلامية، وهي ملك للأمة_ بالتهجم منها على قيَم وثقافة ومقدسات الأمة، ومتسببين في ردود فعلها العنيفة بخلق الذرائع وإحداث العنف الدموي..
ج. الحركـة الإسلاميـة:
تتحمل الحركة الإسلامية مسؤولية تاريخية عليا، أمام الله، وأمام التاريخ، في حسن التنظير للعمل الإسلامي، وفي دقة التنظيم للعاملين فيه، وفي نجاعة اختيار الأسلوب الأمثل لإيصال كلمة الله للمسلمين ولغير المسلمين.
وفي اضطلاع الحركة الإسلامية بهذه المسؤولية، هي مدعوة إلى القيام بخطوات عديدة، يعتقد أنها ضرورية لنجاعة الرسالة وأهمها في نظري:
1. تطهير الصف الإسلامي من الجهلة، وأدعياء العمل الإسلامي، والمتسللين، والوصوليين، وحديثي التوبة والنعمة، فليس أضر على الإسلام، ولا على الحركة الإسلامية، ممن يتسللون إلى العمل الإسلامي، حاملين الخنجر تحت العباءة الإسلامية.
2. إعادة النظر في المنهج، والخطة والطريقة، بتجديد المصطلحات وتدقيق المفاهيم، وترتيب الأولويات، وانتقاء لغة الخطاب، والإقناع، والحوار.
3. ضرورة الاندماج في المجتمع، والتعاون معه بدل هجرته وتكفيره، وسل سيف الغضب ضده، والعمل بدَل ذلك على تقديم الإسلام له في طبق يليق وصفاء الإسلام ونقاوته.
4. إسناد مقاليد الحركة الإسلامية إلى العلماء والفقهاء، كي تبقى حركة علمية، إصلاحية تغييرية تأتمر بأوامر الله، وتنتهي بنواهيه، بدل أن تتحول إلى فصائل عسكرية، سياسية، مثلها كمثل فصائل المافيا، وعصابات المخدرات، وتهريب الأسلحة.
5. العناية بتكوين المتخصصين في الفكر الغربي داخل الحركة الإسلامية، الذين يوكل إليهم أمر التنظير للعمل الإسلامي الموجه إلى الغرب، ونقل كنوز الفكر الإسلامي إلى هذا الغرب، وتقديم رسالة الإسلام إلى العالم أصيلة، نقية، سمحة، متسامحة، بعيدة عن أي غلو، أو تطرف، أو عنف مادي أو معنوي.
6. السمو بالعمل الإسلامي إلى مستوى قضايا الإنسان والمجتمع بعيدا عن "تكشير الأنياب، وتكحيل العينين، وتكميش الثياب" على حد تعبير الشيخ محمد الغرالي، والانشغال بعمارة الأرض قدر الانشغال بعمارة الجنة، على حد تعبير فهمي هويدي.
إن هذه الخطوات المشتركة بين مسؤولية الغرب، وحكام المسلمين، والقائمين على الحركة الإسلامية، لو أن كل طرف قام بما يجب عليه في حدود ميدان اهتمامه وانشغاله لبرز وجه الإسلام الصحيح المطموس ظلما وعدوانا، ولغدا هذا الإسلام ليس دين المسلمين فحسب، بل الدين الذي تحتاج الإنسانية إليه اليوم، وهي تتخبط في جهلها وجاهليتها، وفي ذلك إنقاذ لها من هذا السقوط الحضاري، وهذه الهمجية التي تفشت تحت شعار كلمات مظلومة كالعلم والتكنولوجيا.