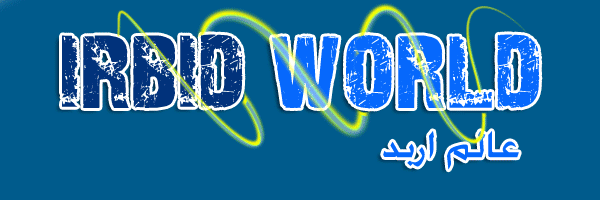كانت
رحلة الإسراء اختباراً جديداً للمسلمين في إيمانهم ويقينهم ، وفرصة
لمشاهدة النبي – صلى الله عليه وسلم - عجائب القدرة الإلهية ، والوقوف على
حقيقة المعاني الغيبيّة ، والتشريف بمناجاة الله في موطنٍ لم يصل إليه بشرٌ
قطّ ، إضافةً إلى كونها سبباً في تخفيف أحزانه وهمومه ، وتجديد عزمه على
مواصلة دعوته والتصدّي لأذى قومه .
فقد شهدت الأيّام السابقة لتلك الرحلة العديد من الابتلاءات ، كان منها موت زوجته خديجة بنت خويلد
رضي الله عنها ، والتي كانت خير عونٍ له في دعوته ، ثم تلاها موت عمّه أبي
طالب ، ليفقد بذلك الحماية التي كان يتمتّع بها ، حتى تجرّأت قريشٌ على
إيذائه – صلى الله عليه وسلم – والنيل منه ، ثم زادت المحنة بامتناع أهل
الطائف عن الاستماع له ، والقيام بسبّه وطرده ، وإغراء السفهاء لرميه
بالحجارة ، مما اضطرّه للعودة إلى مكّة حزيناً كسير النفس .
ومع
اشتداد المحن وتكاثر الأحزان ، كان النبي – صلى الله عليه وسلم – في أمسّ
الحاجة إلى ما يعيد له طمأنينته ، ويقوّي من عزيمته ، فكانت رحلة الإسراء
والمعراج ، حيث أُسري به – صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس ، ثم عُرج
به إلى السماوات العُلى ، ثم عاد في نفس اليوم .
وتبدأ القصّة عندما نزل جبريل
إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بصحبة ملكين آخَريْن ، فأخذوه وشقّوا
صدره ، ثم انتزعوا قلبه وغسلوه بماء زمزم ، ثم قاموا بملء قلبه إيماناً
وحكمة ، وأعادوه إلى موضعه .
ثم جاء جبريل
عليه السلام بالبراق ، وهي دابّة عجيبة تضع حافرها عند منتهى بصرها ،
فركبه النبي - صلى الله عليه وسلم – وانطلقا معاً ، إلى بيت المقدس .
وفي هذه المدينة المباركة كان للنبي - صلى الله عليه وسلم – موعدٌ للقاء بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام ، فقد اصطحبه جبريل عليه السلام إلى المسجد الأقصى ، وعند الباب ربط جبريل
البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء جميعاً ، ثم دخلا إلى المسجد ،
فصلّى النبي – صلى الله عليه وسلم – بالأنبياء إماماً ، وكانت صلاته تلك
دليلاً على مدى الارتباط بين دعوة الأنبياء جميعاً من جهة ، وأفضليّته
عليهم من جهة أخرى .
ثم بدأ الجزء الثاني من الرّحلة ، وهو الصعود في الفضاء وتجاوز السماوات السبع ، وكان جبريل
عليه السلام يطلب الإذن بالدخول عند الوصول إلى كلّ سماءٍ ، فيؤذن له وسط
ترحيب شديد من الملائكة بقدوم سيد الخلق وإمام الأنبياء – صلى الله عليه
وسلم - .
وفي السماء الدنيا ، التقى – صلى الله عليه وسلم – بآدم عليه السلام ، فتبادلا السلام والتحيّة ، ثم دعا آدم
له بخيرٍ ، وقد رآه النبي – صلى الله عليه وسلم – جالساً وعن يمينه وشماله
أرواح ذريّته ، فإذا التفت عن يمينه ضحك ، وإذا التفت عن شماله بكى ، فسأل
النبي – صلى الله عليه وسلم – جبريل عن
الذي رآه ، فذكر له أنّ أولئك الذين كانوا عن يمينه هم أهل الجنّة من
ذرّيّته فيسعد برؤيتهم ، والذين عن شماله هم أهل النار فيحزن لرؤيتهم .
ثم صعد النبي– صلى الله عليه وسلم – السماء الثانية ليلتقي ب عيسى و يحيى عليهما السلام ، فاستقبلاهُ أحسن استقبالٍ وقالا : " مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح " .
وفي السماء الثالثة ، رأى النبي– صلى الله عليه وسلم – أخاه يوسف عليه السلام وسلّم عليه ، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله : ( ..وإذا هو قد أعطي شطر الحسن ) رواه مسلم .
ثم التقى بأخيه إدريس عليه السلام في السماء الرابعة ، وبعده هارون عليه السلام في السماء الخامسة .
ثم صعد جبريل بالنبي– صلى الله عليه وسلم – إلى السماء السادسة لرؤية أخيه موسى عليه السلام ، وبعد السلام عليه بكى موسى فقيل له : " ما يبكيك ؟ " ، فقال : " أبكي ؛ لأن غلاماً بُعث بعدي ، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي " .
ثمّ كان اللقاء بخليل الرحمن إبراهيم
عليه السلام في السماء السابعة ، حيث رآه مُسنِداً ظهره إلى البيت المعمور
- كعبة أهل السماء - الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون
إليه أبداً ، وهناك استقبل إبراهيم عليه السلام النبي – صلى الله عليه وسلم – ودعا له ، ثم قال :
( يا محمد ، أقرئ أمتك مني السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة
الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا
الله ، والله أكبر ) رواه الترمذي .
وبعد هذه السلسلة من اللقاءات المباركة ، صعد جبريل
عليه السلام بالنبي– صلى الله عليه وسلم – إلى سدرة المنتهى ، وهي شجرةٌ
عظيمة القدر كبيرة الحجم ، ثمارها تُشبه الجرار الكبيرة ، وأوراقها مثل
آذان الفيلة ، ومن تحتها تجري الأنهار ، وهناك رأى النبي– صلى الله عليه
وسلم – جبريل عليه السلام على صورته الملائكيّة وله ستمائة جناح ، يتساقط منها الدرّ والياقوت .
ثم
حانت أسعد اللحظات إلى قلب النبي – صلى الله عليه وسلم - ، حينما تشرّف
بلقاء الله والوقوف بين يديه ومناجاته ، لتتصاغر أمام عينيه كل الأهوال
التي عايشها ، وكل المصاعب التي مرّت به ، وهناك أوحى الله إلى عبده ما
أوحى ، وكان مما أعطاه خواتيم سورة البقرة ، وغفران كبائر الذنوب لأهل
التوحيد الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك ، ثم فَرَض عليه وعلى أمّته خمسين
صلاة في اليوم والليلة .
وعندما انتهى – صلى الله عليه وسلم – من اللقاء الإلهيّ مرّ في طريقه بموسى عليه السلام ، فلما رآه سأله : ( بم أمرك ؟ ) ، فقال له : ( بخمسين صلاة كل يوم ) ، فقال موسى عليه السلام : ( أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم ، وإني والله قد جربت الناس قبلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ) ، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم – إلى ربّه يستأذنه في التخفيف فأسقط عنه بعض الصلوات ، فرجع إلى موسى
عليه السلام وأخبره ، فأشار عليه بالعودة وطلب التخفيف مرّةً أخرى ،
وتكرّر المشهد عدّة مرّات حتى وصل العدد إلى خمس صلواتٍ في اليوم والليلة ،
واستحى النبي – صلى الله عليه وسلّم أن يسأل ربّه أكثر من ذلك ، ثم أمضى
الله عزّ وجل الأمر بهذه الصلوات وجعلها بأجر خمسين صلاة .
وقد شاهد النبي – صلى الله عليه وسلم – في هذه الرحلة الجنّة ونعيمها ، وأراه جبريل
عليه السلام الكوثر ، وهو نهرٌ أعطاه الله لنبيّه إكراماً له ، حافّتاه
والحصى الذي في قعره من اللؤلؤ ، وتربته من المسك ، وكان عليه الصلاة
والسلام كلما مرّ بملأ من الملائكة قالوا له : " يا محمد ، مر أمتك بالحجامة " .
وفي
المقابل ، وقف النبي – صلى الله عليه وسلم – على أحوال الذين يعذّبون في
نار جهنّم ، فرأى أقواماً لهم أظفار من نحاس يجرحون بها وجوههم وصدورهم ،
فسأل جبريل عنهم فقال : " هؤلاء الذين
يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم " ، ورأى أيضاً أقواماً تقطّع
ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار ، فقال له جبريل عليه السلام : " هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا ، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب ، أفلا يعقلون ؟ " .
ورأى شجرة الزّقوم التي وصفها الله تعالى بقوله : { والشجرة الملعونة في القرآن } ( الإسراء : 60 ) ، وقوله : { إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ، طلعها كأنه رءوس الشياطين } ( الصافات : 64 – 65 ) .
ورأى مالكاً
خازن النار ، ورأى المرأة المؤمنة التي كانت تمشط شعر ابنة فرعون ، ورفضت
أن تكفر بالله فأحرقها فرعون بالنار ، ورأى الدجّال على صورته ، أجعد الشعر
، أعور العين ، عظيم الجثّة ، أحمر البشرة ، مكتوب بين عينيه " كافر " .
وفي تلك الرحلة جاءه جبريل
عليه السلام بثلاثة آنية ، الأوّل مملوء بالخمر ، والثاني بالعسل ،
والثالث باللبن ، فاختار النبي – صلى الله عليه وسلم – إناء اللبن فأصاب
الفطرة ، ولهذا قال له جبريل عليه السلام : " أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك " رواه البخاري .
وبعد
هذه المشاهدات ، عاد النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى مكّة ، وأدرك أن ما
شاهده من عجائب ، وما وقف عليه من مشاهد ، لن تتقبّله عقول أهل الكفر
والعناد ، فأصبح مهموماً حزيناً ، ولما رآه أبوجهل على تلك الحال جاءه وجلس
عنده ثم سأله عن حاله ، فأخبره النبي – صلى الله عليه وسلم – برحلته في
تلك الليلة ، ورأى أبو جهل في قصّته فرصةً للسخرية والاستهزاء ، فقال له : "
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني ؟ " ، فقال له النبي – صلى الله
عليه وسلم – : ( نعم ) ، فانطلق أبو جهل
ينادي بالناس ليسمعوا هذه الأعجوبة ، فصاحوا متعجّبين ، ووقفوا ما بين
مكذّب ومشكّك ، وارتدّ أناسٌ ممن آمنوا به ولم يتمكّن الإيمان في قلوبهم ،
وقام إليه أفرادٌ من أهل مكّة يسألونه عن وصف بيت المقدس، فشقّ ذلك على
النبي – صلى الله عليه وسلم – لأن الوقت الذي بقي فيه هناك لم يكن كافياً
لإدراك الوصف ، لكنّ الله سبحانه وتعالى مثّل له صورة بيت المقدس فقام يصفه
بدقّة بالغة ، حتى عجب الناس وقالوا : " أما الوصف فقد أصاب " ، ثم قدّم
النبي – صلى الله عليه وسلم – دليلاً آخر على صدقه ، وأخبرهم بشأن القافلة
التي رآها في طريق عودته ووقت قدومها ، فوقع الأمر كما قال .
وفي ذلك الوقت انطلق نفرٌ من قريش إلى أبي بكر
رضي الله عنه يسألونه عن موقفه من الخبر ، فقال لهم : " لئن كان قال ذلك
لقد صدق " ، فتعجّبوا وقالوا : " أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس
وجاء قبل أن يصبح ؟ " ، فقال : " نعم ؛ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ،
أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة " ، فأطلق عليه من يومها لقب " الصديق "
.
وكان في هذه المواقف المتباينة حكم إلهيّة عظيمة ، ففي تصديق أبي بكر
رضي الله عنه إبرازٌ لأهميّة الإيمان بالغيب والتسليم له طالما صحّ فيه
الخبر، وفي ردّة ضعفاء الإيمان تمحيصٌ للصفّ الإسلامي من شوائبه، حتى يقوم
الإسلام على أكتاف الرّجال الذين لا تهزّهم المحن أو تزلزلهم الفتن ، وفي
تكذيب كفار قريشٍ للنبي – صلى الله عليه وسلم – وتماديها في الطغيان والكفر
تهيئةٌ من الله سبحانه لتسليم القيادة إلى القادمين من المدينة ، وقد
تحقّق ذلك عندما طاف النبي – صلى الله عليه وسلم – على القبائل طلباً
للنصرة ، فالتقى بهم وعرض عليهم الإسلام ، فبادروا إلى التصديق والإيمان ،
ليكونوا سبباً في قيام الدولة الإسلامية وانتشار دعوتها في الجزيرة العربية
.