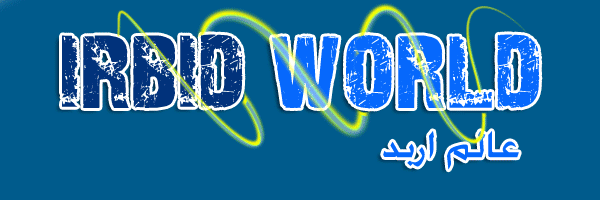Jasmine collar

 |  موضوع: شريط الذكريات موضوع: شريط الذكريات  10/2/2011, 03:10 10/2/2011, 03:10 | |
|
شريط الذكريات
متى نحتسي القهوة في روابي عمان
زياد جيوسي
أخي جهاد...لقد نكأت كلماتك جراح الوطن في نفسي، أعدت إلي ذكريات طفولتنا، أشعلت نار الحنين في نفسي إلى مدينتين..مدينة أحيا بداخلها و مدينة تحيا بداخلي..
رام الله التي نشأت بها زرعت بداخلنا بذور الوعي، عشق الثقافة، عندما كنا نتألم للحصول على مجلة مصورة أو كتاب للأطفال نلتهمه التهاما، عندما كنا نوفر أجرة المواصلات كي نشتري مجلة أو كتابا، ونسير المسافات على أقدامنا الغضة للوصول إلى المدرسة أو العودة منها..
رام الله التي بدأت أنت فيها ( فك الحرف ) في المدرسة، بعد أن كنت قد سبقتك بعامين دراسيين في روابي عمان..
عمان التي كانت حاضنتي الأولى، وفيها بدأت الدرس الأول في الحياة، أقرأ..درسا أعطاه الله سبحانه لرسله وأنبيائه.
قرأت الحروف لأول مرة في مدرسة عظيمة ومقدسه، ليس على مقاعد الدراسة، وليس تحت ظلال شجرة الكتاب بل على يدي معلمة الكون (الأم ) ..والدتنا..هذه المرأة البسيطة العظيمة، التي بوعيها الكبير ودراستها المتواضعة، علمتني كيف ( أفك الحرف )..وأن اقرأ وهي تعد الليالي بانتظار عودة فارسها ( الوالد ) من عمله المتنقل بين مدينة وأخرى، كعسكري لا يملك من أمر قراره شيئا..
كنت أنت صغيرا وكان عامين من فرق العمر بيننا تعني الكثير في تلك المرحلة، كنا وما زلنا أصدقاء وكنت أنت ( وما زلت ) الطفل المدلل عند الوالد بشعرك الأشقر وعينيك الخضراوين، ربما لأنك كنت تشبهه اكثروكنت أنا ببشرتي الحنطية وشبهي من الوالدة وكوني الأكبر لديها الأقرب لها، فكنت اسهر الليالي معها وهي تقرأ بكتاب في زمن انعدمت فيه وسائل الحضارة الحديثة، فلم يكن لدينا تلفاز أو وسائل إعلام وتسلية، وكان لدينا مذياع لم نستمع إليه، لسبب بسيط هو أنه لم يكن لدينا كهرباء.. وكان المذياع جزءا من مهر الوالدة..
كانت الوالدة تقطع الليالي تقرأ على مصباح يعمل ( بالكاز ) وأنا أندس إلى جانبها، وقليلا قليلا تعلمت ( فك الخط ).. وبدأت اقرأ..
لهذا ما زالت عمان عندي ( حبة الفؤاد والعينين )، وما زلت أقول بعد أن أصبحت في الخمسين من العمر ( أنا وعمان كبرنا سوا ).
ما زالت عمان عندي بذرة الوعي وعشق الثقافة والأدب، نشأة الكلمة نمو الشخصية، ما زالت وستبقى صفصافة باسقة مزروعة في النفس لا تنسى، وستبقى تحيا في داخلي وتسكن مني القلب رغم سنوات وأد الحرية التي عانيتها فيها..
أعادتني يا أخي وصديقي كلماتك سنوات وسنوات إلى تلك الأيام، إلى عمان الصغيرة التي كبرت بنا وكبرنا بها، أعدتني إلى ذكريات ما زالت صورها في ذهن طفل عايشها، ذكريات عمان وأحيائها..الملفوف والخرفان والاشرفية والتاج والشعيلية والدبايبة والمريخ والنظيف والجوفة والأرمن وغيرها، من أحياء سكناها وتنقلنا بينها، من الملفوف الذي تنطبع في ذاكرتي منه أولى صور الوعي لعمان.. الذي كنا نرى منه سيل عمان وفيضانه في الشتاء، فيقسم عمان إلى قسمين يموج في وسطها كأنه شلال موجات من الذهب يجرف بطريقه ما يجده..كان ذلك سيل عمان الذي كان أشبه بنهر هادر في الشتاء، وتحف جنبا ته الأشجار وبساتين الفواكه في الصيف، ولا اعلم إن كان قد بقي منه شيئ تحت سقفه الحالي، فآخر عهدي به قبل أن يسقفوه خيط بسيط من المياه لا علاقة له بما عرفناه..
أعدتني إلى وسط المدينة ونافورة المسجد الحسيني الكبير، التي كانت معلما ومركزا للراحة ونقطة لقاء الغرباء..
تذكرت المصرفين العملاقين العربي والعثماني في شارع السعادة، والجزيرة في وسط الشارع التي كانت موقفا للسيارات المتجهة شمالا....يا الله كم تغير الزمان وكم تغيرت عماني..نفس الشارع الآن يختنق بأزمة السير ويموج بالمركبات التي تملؤه..ما زال المصرف العربي قائما وشاهدا، بينما ذهب العثماني وأصبح مكانه مركز للشرطة ومكاتب ومحلات تجارية..
تتدفق الذكريات إلى مصدار عائشة والى الدير القابع في منحدره، والى بداية جبل النظيف مقابل ما عرف بشارع بارتو، حين سعت الحكومة لتوسيع الطريق عند منحنى صعب وشاق، فإذا الأرض تنشق عن قبرين رومانيين، وتدفقنا مع المئات من الناس وأنا امسك بيدك خوفا أن تضيع مني في لجة الطريق، لرؤية هذا الاكتشاف قبل أن تنقله الحكومة للمتحف، ولأول مرة في حياتي أرى هيكلا عظميا في مثواه ولم استطع لصغر سني أن افهم شيئا، أو أن أجيب على تساؤلاتك البريئة.
وما زالت الصورة مرسومة في الذاكرة، وتجول الذكريات إلى بيادر القمح في الاشرفية، التي لم يكن بها إلا أربعة معالم لا تنسى أضيف لها خامسا.
الإصلاحية وهي سجن الأحداث على رأس التل، والتي تحولت لمبرة أم الحسين لتحتضن أطفالا جنى عليهم الدهر أو الأهل، ودار النهضة والتي لا أعلم إلى ما آلت إليه بعد هذه السنين، والمستشفى الجراحي الرابض في أعلى الجبل بين حر ش من أشجار الصنوبر والسرو، والذي توسع وكبر وأصبح مستشفى البشير..
ما زلت أذكر الأساطير التي حيكت حوله وحجم الخوف الذي كان يلبسنا إذا مررنا من هناك، فقصص الأشباح الذين يخرجون من غرفة ( عزرا يين ) كما كنا نسميها كانت تسيطر علينا، فكان قلة من يجرؤون أن يمروا من هناك بعد غياب الشمس.. ترى لو أن المئات من الذين دفنوا في حفرة ضخمة تقبع في أحد زواياه، في لحظة من لحظات غياب العقل.. لو أنهم دفنوا أيام طفولتنا!! كم من القصص ستخرج من الخيال الشعبي عندها !!!؟؟؟
ورابع المعالم هو الكنيسة المتربعة على التل، مواجهة لجبل القلعة والقصور، الكنيسة ذات الجرس الصامت، والتي اذكر عش الحمام في برجها منعما بالهدوء والسكينة..
والمعلم الخامس الذي أضيف هو مسجد أبو درويش، هذا المسجد الذي بناه ذلك الشيخ الجليل القادم من القوقاز ليكون رحمة لآخر ته، ودعاءا له من المصلين وصدقة جارية ما دام هناك من يصلي فيه..
ذاك المسجد الذي بني من حجارة بيضاء وسوداء فكان آية في الجمال، وأنموذجا من البناء لم تشهده عمان من قبل..
أتذكر يا صديقي يوم افتتاحه ..؟؟ عندما كان رجال ( الدرك ) يحملون سياطهم المشهورة، لتنظيم دخول آلاف الأشخاص الذين تدفقوا من اجل التمتع بآيات من الجمال لم نعهد ها من قبل..
كانت ذكرى افتتاحه وانبهاري بسجاده وثرياته وزخرفه ذكرى لا تفارقني، حتى دار الزمان دورته وعدت إليه في بداية الشباب، لأكمل المرحلة الثانوية في المدرسة الرابضة أسفله..
أعدتني يا أخي بكلماتك سنوات وسنوات وما زال معين الذكريات يتدفق كشلال ضوء، انبثق فجأة من خلف غيمه.
أذكر يومي الأول في مدرستي الرسمية الأولى - مدرسة عبد الرحمن بن عوف -الواقعة ما بين حافة المخيم وبداية العمران الزاحف وحافة الصحراء، فكانت خليطا من التلامذة القادمين من الحضر والقادمين من البادية.
اذكر عندما أتى العم أبو عبدا لله ليأخذني إلى المدرسة في يومي الأول، وكانت المدرسة قد بدأت منذ فترة وأنا لم التحق لأني اصغر من السن المطلوب قليلا، وأعطتني الوالدة زوادتي الأولى ( خبزة متضمخة بالزيت والزعتر )، وهل كان لنا أن نعرف غيرها ؟؟ ومصروفي الأول الذي كان الحاجب لي من رهبة المدرسة ( تعريفه ) كما كنا نسميها، أي خمسة فلسات كاملة..وحقيبة صغيرة لا اعلم من أين حصلت عليها، وان كنت أجزم أنها لم تشترها فلم تكن تمتلك ثمنها، وقلم رصاص ودفترين..
أدخلني العم أبو عبد الله وهو يرتدي بزته العسكرية، ونجمة أو نجمتين تتلألئان على كتفيه، عند أبي علي مدير المدرسة والذي كان مكتبه في زاوية من صالة المدرسة..فلم تكن المدرسة سوى صالة تتوسط أربعة من الغرف تحتوي بجنباتها الطلاب من الصف الأول إلى الصف الرابع الابتدائي، وكنت هزيل الجسم وزادتني رهبة الموقف هزالا، وقال له.. هذا الولد الذي قلت لك عنه.. لك يا أستاذ اللحم ولنا العظم..
ووقفت بينهما لا أدرك شيئا، مدير المدرسة الذي حمل عصاه ووضعها تحت إبطه، والعم أبو عبد الله ببزته العسكرية ومسدسه على وسطه..
شعرت لأول مرة برهبة السلطة: سلطة المدرسة وسلطة الجيش.. ونادى المدير على أحد الأساتذة وقال له: خذ هذا الولد عندك وأخبرني إن كان يصلح وان لم يكن فأبقه مستمعا للعام القادم، فهو اصغر من السن القانوني..
أمسكني المدرس بحنان من يدي وما زلت أتساءل..هل كان المدرس حنونا يومها!! أم أنه تصرف كذلك أمام رهبة السلطة المتمثلة بوجود ضابط من الجيش !! وأدخلني الصف ووقفت لحظات خلتها الدهر، وكل عيون الطلبة محدقة بي، وقال لي المدرس: حظك جيد.. هناك طالب غائب اليوم، سأجلسك مكانه في آخر الصف ولكن لا تحضر غدا إلا ومعك مقعد صغير والا ستجلس على الأرض فأنت متأخر ولا يوجد مقاعد فارغة، وكان كل مقعد يجلس عليه ثلاثة من الطلبة..
كانت الحصة الأولى هي اللغة العربية ، كان هذا من حسن حظي، كانت بعض الكلمات مكتوبة على اللوح، وفجأة قال المدرس من يستطيع القراءة ؟؟ رفعت يدي..نظر إلي المعلم باستغراب..أنت !! هل تقرأ.. تحشرجت الكلمات في حنجرتي بالكاد استطعت أن أقول نعم..إذن اقرأ.. استجمعت شجاعتي وقرأت..ولم اشعر إلا بيد المعلم تتناولني من مقعدي، ذاهبا بي إلى المدير قائلا له..هذا الولد قرأ الدرس المكتوب على اللوح..
نظر إلي أبو علي..هل قرأت..نعم يا أستاذ..إذن أمامي..ساقني أمامه للصف وطلب مني أن أقرأ..وقرأت..لم أكن متفهما ما يجري، كنت خائفا جدا أشعر أنني اقترفت ذنبا لا اعرفه..وهنا طلب من الطلاب أن يصفقوا لي..لماذا وكيف لا اعرف..
سألني من علمك القراءة؟ قلت له باعتزاز..أمي يا أستاذ., كم أنت عظيمة يا أمي، كم اذكر هذه اللحظات التي ميزتني عن غيري، وكم شعرت بالفخر والاعتزاز بأمي وما زلت..
جاء الربيع وجاءتني معه تجربة جديدة، فالوالد نقل إلى القدس وفاجأنا باكتراء بيت هناك، وكان لا بد من الرحيل، ولكن لم يكن باستطاعتي الانتقال من المدرسة تبعا لظروف وجودي فيها ، فتقرر تركي لدى جدتنا لأمي رحمها الله، ولأول أيام حياتي أعيش بعيدا عن دفء الوالدة وعنك...شعرت باليتم مبكرا فلم يكن لدي من صديق غيرك، وغالبت دمعاتي وأنا أودعكم وبقيت صامتا، فقد تجمد مني الحس والدمع أمام جبروت نظرة الجدة.
تجربة جديدة أن تعيش بالمخيم لاجئ جديد بعيد عن أهله، يضاف إلى لاجئين طردوا من ديارهم، كنت لا اعرف ماذا تعني كلمة لاجئ.. ورويدا رويدا بدأت اعي معنى التشرد وفقدان الوطن والبيت.
كان بيت جدي في المخيم يموج بالعدد الكبير، فالجدة ولود والأعداد كبيرة بالكاد أجد لي زاوية أتكور بها لأنام، على حاشية رقيقة من قطع القماش التي جمعت مع بعضها، وكان اسمها ( جنبية )، بالكاد كنت اشبع من الطعام، فالجدة تقسم الطعام لكل حصة بماعون صغير وقطعة من الخبز، وكانت ترسلنا لنأكل في مطعم وكالة الغوث أياما، على بطاقة منحت للاجئين، وكان علي أن أتدبر أمري بين هؤلاء الأطفال والا حرمت من الطعام، رحمها الله كانت ظروف الحياة تجبرها على القسوة بعد أعوام العز التي مضت في فلسطين، والتي كانت تتحدث عنها بكل ألم وأسى، والجد الطيب الرائع الحنون يقول لها بألم صامت: وحدي الله يا (مره )..رحمه الله كم كان طيبا ورائعا، ولعل طيبته وحنانه هو ما كان يواسيني بألمي الصامت بعيدا عنك والوالدة..
جاء الصيف.. وانتهت السنة الدراسية، وحضر الوالد بلباس الشرطة على دراجته النارية، وقبلت يده وهو يقف عملاقا ضخما فارع الطول مفتول العضلات، وسألني حضر حالك بدك تروح للبيت، وسألني عن شهادة المدرسة وأحضرتها له وأنا ارتجف كورقة في مهب الريح، وأبتسم مغادرا وقال سأعود بعد ساعة لأخذك..
قامت الجدة فورا وسخنت الماء، ونادت إحدى خالاتنا الكثيرات وقالت لها ( حممية ) وخليه يروح لأمه نظيف, وبعد الحمام ألبستني جدتي بنطالا بصدر ازرق اللون ذا أزرار ذهبية لامعة، قالت لي هذا( طلع) لنا ( بالبقجة ) وهي ملابس كانت توزعها الهيئات على اللاجئين وأخفيته لك، قل لامك هذا من جدتي واحذر أن تقول لها إنني كنت أضربك لا تغضب مني يا جدتي فأنا أمك التي أرضعتك وأنا احبك، ولأول مرة اكتشف أن لي أما أخرى هي التي أرضعتني كما أرضعتك أيضا ومازجت دمنا ولحمنا بحليبها..
وجاء الوالد.. ووضعني بسيارة مع أناس غرباء، وسار أمام السيارة بدراجته النارية وأنا انظر يمينا و يسارا، أتأمل بطريق يتلوى من عمان للقدس، تحيط بجنباته الوديان أحيانا، والأشجار أحيانا أخرى، وأنا اشعر بالفخر والوالد يتموج على دراجته أمامنا فاتحا لنا الطريق خلفه، فكأننا موكب رسمي.
وصلنا إلى القدس وكانت لحظة لقائي بك وبالوالدة، لحظة لا تنسى غامره بالفرح والسعادة
وأنت تصرخ فرحا و تجمع ألعابا لا تزيد عن قطع من الأخشاب متروكة وتقول لي : كنت ( مخبيها إلك عشان تلعب معي ) ولعبنا، وأخذتني للحارة بين أبناء الجيران متباهيا، تقول لهم هذا ( اخوي ) القادم من عمان..
كانت أيام لا تنسى.. كان بيتنا المستأجر( كالعادة )، يقع في أعالي وادي الجوز في القدس، وكانت خلفنا مباشرة قلعة ( هداسا ) وكنا نرى اليهود من بعيد، ونلعب قرب السلك الشائك الذي يحيطهم، ونسمع القصص الخيالية عن هذه القلعة التي كانت معزولة عن القدس الغربية المحتلة.
بدأت الدراسة بمدرسة مميزة بكل شيء، بطلبتها ومبانيها وساحاتها ومدرسيها، كانت تختلف تماما عن مدرستي السابقة، كان اسمها مدرسة خليل ألسكاكيني وفيها عرفت بداية الوعي الوطني، فقد كنا نجمع الفلسات التي نأخذها مصروفا لنا وندفعها لدعم ثورة الجزائر، وكانت الصفوف تتنافس في من سيدفع أكثر
فكلما جمعنا خمسين فلسا كانت توضع لنا صورة صغيرة لمليك البلاد، على لوحة خاصة داخل الصف، وفي ألسكاكيني أيضا عرفت لأول مرة تعبير الغضب الوطني بالحجارة ضد المحتل، فقد كانت هناك قافلة تمر برعاية الصليب الأحمر قادمة من هداسا إلى القدس الغربية مرتين في الأسبوع لتنقل التموين لليهود في هداسا، والتي تبين بعد حرب حزيران أنها كانت تنقل السلاح والعتاد والرجال أيضا، وكانت القافلة تمر من أمام المدرسة وكانت الشرطة العسكرية تطردنا من الساحة المطلة على الشارع، إلى ساحة أخرى من ساحات المدرسة، ولكن هذا لم يكن يمنعنا من التسلل وضرب الحجارة على القافلة ..ورغم قصر الفترة..إلا أن مدرسة السكاكيني بقيت منقوشة بالذاكرة ولم تزل!! ترى ...؟؟ هل هو نسيج الذكريات الذي أعادني بعد أن عدت لرام الله عام 1998 إلى الالتصاق بمركز خليل السكاكيني الثقافي حتى وصلت إلى هيئته الإدارية عضوا منتخبا ؟؟
في القدس ارتسمت بذاكرتي صورة الأقصى وقبة الصخرة والقيامة، عندما أخذتنا الوالدة لزيارتها وكانت المرة الأولى والأخيرة، فما طال المقام شهرين من بدء المدرسة حتى عدنا إلى عمان من جديد، وعدت أنا إلى مدرستي السابقة.
و ما أن اكتمل العام الدراسي حتى كان الوالد قد نقل إلى رام الله، وحان موعد الرحيل مجددا فاكترى لنا بيتا في رام الله على أطراف بيتونيا بعيدا عن البلدة، بل اقرب لرام الله من بيتونيا، وكنت أسائل نفسي دوما لم يختار الوالد المنازل البعيدة.. البعيدة عن المدرسة والبعيدة عن الناس وعن اقرب بقاله حتى...
شددنا الرحال إلى بيتونيا، بلدة جميلة بحق، كان بيتنا الذي تذكره جيدا جميلا، في حي كل بيوته الحجرية الحديثة خمسة منازل وكل مستقل بذاته، ودخلنا المدرسة أنا وأنت لنبدأ مرحلة جديدة بحق مرحلة من أجمل المراحل وأكثرها أثرا في حياتي، مدرسة تستحق اسم مدرسه.. معلموها عظام يعتبر غالبيتهم التدريس رسالة أكثر من مهنة، وفي مكتبتها الكبيرة وعلى أيدي مدرسينا بدأت التهم الكتب التهاما، وبدأت مداركي بالتوسع رغم صغر سني، وساهمت ثقافة الوالد وتفتحه على الفكر القومي والناصري بزيادة كم المعارف لدينا، كان لا يتأخر عن إحضار مجلات كنت التهمها مثل العربي الكويتية وآخر ساعة والمصور والكاتب المصرية، وان كنت أواجه صعوبة في فهم ما يكتب بمجلة الكاتب من موضوعات زخمها لا يتناسب مع عمري وسني، وما كان الوالد يبخل علينا بشرح بعض المسائل التي لم نفهمها، فمنه عرفت عن عبد الناصر الكثير وعن ثورة السلال باليمن، وكثير من قضايا تلك المرحلة..
ولعل موقع البيت الذي سكناه بعيدا عن البلدة في قلب منطقة تزدحم بالأشجار من كل الأنواع، والهواء العليل النقي والطبيعة الخلابة، قد ساهمت كلها بتوسيع مداركنا، ففي تلك الفترة اشتدت لدي رغبة الرسم وصنع بعض القطع الصغيرة الجميلة، من لحاء شجر الصنوبر وكنت اعتمد على أزهار الربيع ألوانا بدل أقلام الألوان الصناعية غير المتوفرة دوما، فهي علبة صغيرة من خمسة أقلام، كان علينا أن نكمل بها العام الدراسي بطوله فكان لا بد من بديل، هذه الهواية لازمتني حتى تزوجت وانغمست في الحياة العملية فابتعدت عنها،مع أنني ما زلت أحضر معارض الفن التي أعرف عنها ، وكنت وكلما سؤلت عن سبب ابتعادي عن الرسم والفن أجيب مبتسما.. كنت ارسم باحثا عن الجمال.. لقد تزوجت من امرأة أجمل من كل اللوحات التي رأيتها..فاكتفيت..
عامان من أجمل الأعوام قضيناها في ذلك الحي الهادئ الجميل، والذي أصبح الآن بعد أن عدنا إليه زوارا بعد ثلاثين عاما و نيف لا هادئا ولا جميلا فقد اختفت أشجاره وتزاحمت منازله وأصبحت ذات ادوار عديدة، ولوثت أجواءه المصانع وورش تصليح السيارات...
فترة لا أنساها ولا أنسى قسما من المدرسيين الذين طبعوا بصماتهم
في صفحات نفوسنا، وفي بناء شخصياتنا وفي توسيع مداركنا.. ولعلي لا أنسى ولن أنسى مدرس اللغة العربية الأستاذ خالد الأسمر، لما كان له من دور لا ينسى، وعندما عدت إلى رام الله بعد غياب طويل سارعت بالبحث عنه، وكنت كمن يبحث عن إبرة في كومة قش حتى التقينا ذلك اللقاء العاطفي الجميل، بعد أربع وثلاثين عاما من الغياب وحين انحنيت على يده مقبلا إياها، بكى وترقرقت الدموع في عينيه فرحا أن يجد طالبا كان عنده طفلا، يبحث عنه ليراه بعد أن أصبح رجلا يخط الشيب ما تبقى من شعره وبعد سنين طوال.. ولا أنسى يوم رأيته مرة في الطريق بعد لقائنا بفترة وبيدي لفافة من التبغ، فلم أتمالك نفسي وألقيتها أرضا خجلا وخوفا، وكأني ما زلت ذلك الطفل الذي يلعب في ساحة المدرسة وملاعبها، وقد ضحك وقبلني وربت على كتفي، وقال لي ما زلت أنت تلميذي الذي اعتز به وبتربيتي له..
وفي هذه المدرسة تفتحت عيناي على معنى المظاهرات والاحتجاج، فكانت أولى الأحداث التي عايشتها حين انطلقنا في تظاهرة احتجاجا على تصريحات الحبيب بورقيبة، ومظاهرات الاحتجاج والاستنكار للغارة البشعة التي شنها اليهود على قرية السموع....
انتقلنا بعد عامين لبيت جديد في مدخل مدينة رام الله، منطقة هادئة وجميله ولكنها تفتقد المساحات الخضراء التي عشناها سابقا، ولكنها فترة جميله عرفنا فيها رام الله أكثر، فنحن بتنا أكثر قربا من وسط المدينة، فالتصقنا بها وعشقناها..
وفي هذه الفترة تنقل الوالد بعمله مرة إلى أريحا، ومرة إلى بيت لحم، ورفضت الوالدة الانتقال معه، حرصا على دراستنا وحبا لرام الله التي أحبتها كثيرا..
حتى كان ذلك اليوم المشئوم حين استيقظنا على اشتعال حرب حزيران، وودعنا الوالد ملتحقا بعمله كعسكري منضبط وتركنا مع الوالدة أطفالا..
لا أنسى تلك الأيام وبالتأكيد انك لا تنساها، صوت العرب يتحدث عن انتصارات العرب، ونحن نقف على شرفة المنزل ونرى الطائرات اليهودية تقصف ضواحي القدس، ونظنها طائرات عربيه تقصف جيش اليهود والوالدة ترفع يديها إلى الله تضرعا ودعاءا.. انصرهم يا رب..انصرهم يا رب..حتى جاءت الطائرات إلى سماء رام الله وشنت غاراتها على محطة الإرسال الإذاعي، وجاء بعض من الجنود من المعسكر القريب وقالوا للوالدة.. غادري المنزل فقد سقطت القدس وصدرت أوامر الانسحاب، خذي أولادك ولا تبقي فاليهود قادمون ونحن مغادرون، وأنت صغيرة السن ونخشى عليك...
وفي هذه اللحظات بدأت القذائف بالتساقط على المدينة، وغادرنا على عجل واندفع الآلاف من البشر متدافعين إلى وادي العين، واختلطت الجموع بالجنود الفارين من ساحة المعركة، ورأيت بأم عيني العشرات من قطع السلاح الملقاة بين الأشجار، وأذكر منها جهاز للتخاطب اللاسلكي الذي يحمل على الظهر، وصوت جندي ما يصرخ وينادي وما من مجيب، والطائرات تحلق بالجو فوقنا مما زاد من الرعب والخوف، حتى وصلنا إلى مغارة قادنا لها احد الجيران الذي التقانا ولم يتخل عنا، وما زالت أصوات الناس الذين تفرقوا عن بعضهم البعض وهم ينادون ويصرخون ترن في أذني، وقضينا أياما لا أذكر عددها في تلك المغارة نقتات على ما تنبته الأرض، وعلى بعض المواد التي تمكن البعض من التسلل وإحضارها من البيوت، حتى سمعنا أن اليهود سمحوا لمن غادروا إلى البراري بالعودة رافعين الأعلام البيضاء...
عدنا رافعين قطعة قماش بيضاء ووصلنا بيتنا، لنجد جزءا منه قد تهدم والرصاص قد اخترق نوافذه، عدنا وشعرت لأول مرة بذل الهزيمة ومعنى الانكسار..عدنا ونحن لا نعرف عن الوالد شيئا.. احي هو أم شهيد، أتمكن من الانسحاب أم أصبح أسيرا في الأصفاد...
كانت مرحلة صعبة فالوالد مفقود ونحن صغار بالسن، ولا أهل لنا ولا أقارب في المنطقة، شعور قاس بالغربة تشعر به وأنت في وطنك، وبدأنا نسأل هنا وهناك عن أخبار عن الوالد، حتى أتانا خبر أن سيارته شوهدت فارغة في منطقة عقبة جبر في أريحا وأن الرصاص قد زنرها، وأن دبابة قد سحقت قسما كبيرا منها وهذا ما زاد بالألم والأسى والقلق...
حتى جاءنا النبأ مع متسلل ما عاد من شرق النهر, ليخبرنا أن الوالد في عمان ويطلب أن نلتحق به، وبدأنا بجمع القليل من الحوائج المسموح أخذها عبر الجسر المحتل وغادرنا رام الله الجميلة عائدين من جديد إلى عمان مرتع الطفولة والوعي، ولكن عدنا بقلوب كسيرة وآلام في النفس لا تنسى، حاملين لقبا جديدا علينا..نازحين..
عدنا لعمان والتقينا بالوالد والأهل والعشيرة، لنبدأ مرحلة جديدة في حياتنا لعلنا نتذاكرها يوما...
وها أنا الآن وأنا بعيد عن عماني منذ سنوات ثمانية لم أرها، تجول في النفس الذكريات وتخترق حواشي القلب محبتها...وأصرخ من صدر يملؤه الشوق...
أما آن لنا أن نحتسي القهوة في روابي عماني ؟؟؟؟؟؟
| |
|
خالد الرواضيه

 |  موضوع: رد: شريط الذكريات موضوع: رد: شريط الذكريات  10/2/2011, 03:11 10/2/2011, 03:11 | |
| اشكرك على موضوعك المميزلك من كل تقدير واحترام | |
|
Jasmine collar

 |  موضوع: رد: شريط الذكريات موضوع: رد: شريط الذكريات  10/2/2011, 03:29 10/2/2011, 03:29 | |
| | |
|