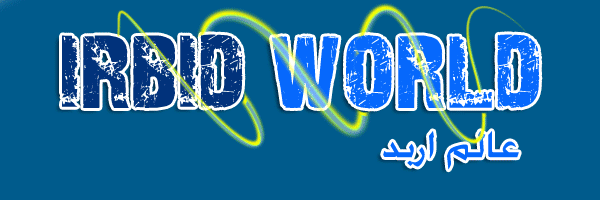إنتقلنا إلى الرمثا، منتصف خمسينيات القرن الماضي، حيث شغل المرحوم والدي موقع مدير الناحية، وكانت تابعة لمتصرفية اربد، مع عدة مديريات، وكانت الرمثا تكتسب أهميتها من كونها مركزاً حدودياً، إضافة إلى أن الجميع نظروا إليها بإعتبارها بؤرة ثورية، تتأثر أسرع من غيرها، بما يجري في الجمهورية السورية المجاورة، والتي لا تبعد حدودها عن الرمثا أكثر من بضعة كيلومترات.
كان مركز مديرية الناحية في منزل لأبي هاني الطلاق، وقد إستاجرنا بيتاً لأخيه الذي كان ضابطاً. كان البيت يقع على الطريق المؤدية إلى مركز الحدود مباشرة، بجانب كازية الشرع، التي كنا نفرح حين تتوقف عندها سيارة تقل سياحاً، وفي العادة، كان يتجمع حولها أطفال تعلموا من الانجليزية عبارة واحدة pleas give me some money ، ومعناها “من فضلك أعطني بعض النقود”، وغالبا ما كان الطالب يحصل على علكة، أو قطعة حلوى. كانت تعبئة الوقود في السيارات تتمّ يدوياً، وكنا نفرح حين يُسمح لنا بإستخدام عضلاتنا الفتية لتعبئة الوقود .
مركز تهريب
كانت الرمثا أيضاً مركزاً معتمداً لعمليات التهريب، التي كان المواطنون يقومون بها يومياً، على ظهور البغال والحمير، أو إعتماداً على أية وسيلة متاحة، وأذكر أن تهريب السكر إلى سوريه، في تلك الآونة، كان عملية مربحة تستحق المجازفة من المهربين، الذين كانوا يعرفون جيداً أن هناك إمكانية لإتهامهم بتهم سياسية، نتيجة تنقّلهم عبر الحدود بصورة غير شرعية، لكنهم كانوا يستمرون في التهريب.
في تلك الفترة، كان الرماثنة يهاجرون أيضاً إلى ألمانيا للعمل هناك، وقد عاد أحدهم إلى بلدته بسيارتي مرسيدس 180 عملتا على نقل الركاب بين إربد والرمثا، وأذكر أنه قال مرة إن سعر كل منهما كان 700 دينار. وكانت تعملان مع سيارتين أخريين لنفس الغرض، لكنهما كانتا أميركيتين.
وعلى ذكر السيارات، أذكر أن كلّ مستوردات الأردن من السيارات كانت تصل عن طريق الرمثا، وكنا أطفالاً نجلس على شرفة منزلنا لنراقبها وهي تمر، بألوانها الزاهية، الممتزجة بلمعة “النجل” الذي كان سائداً إستخدامه بكثرة في سيارات الخمسينيات.
كان الطريق الدولي، الذي يمر عبر الشارع الرئيسي للرمثا يعج صيفاً بسيارات البطيخ، التي تنقله من قرى الطره والشجره إلى سوريه، وإذا كان المصدر من أصدقاء الوالد، فإن الشاحنة كانت تقف أمام منزلنا لتزويدنا بعدة بطيخات، كانت تتجمع تحت السرير الوحيد في المنزل لحين الحاجة اليها.
الهربيد يعلن “جمهورية الرمثا”
في منتصف الخمسينيات إندلعت في الرمثا مظاهرات عارمة تطالب بالإنضمام للوحدة المصرية السورية، وكان القائد لتلك التظاهرات شاباً لم يكمل دراسته الثانوية بعد، لكن (الهربيد/ هذا هو إسمه) سيغدو مشهوراً حين يعلن الرمثا جمهورية مستقلة، وينقل أتباعه اليافطة التي تحمل عبارة الحدود الاردنية، من موقعها بين الأردن وسوريه إلى منطقة المثلث، الواقعة على الطريق بين عمان والمدينة الثائرة، وكان المتظاهرون يتجمعون يومياً في وسط المدينة، ثم يتوجهون إلى المركز الحدودي ليلقوا خطاباتهم الحماسية، وقد أخذتهم حماستهم يوماً إلى مقهى في المركز الحدودي كنا نطلق عليه ( rest house ) ، وإستولوا على موجوداته من خمور وغيرها، باعتبار أنه كان يمثل الإمبريالية العالمية، ثم توجهوا الى ( الغربال ) وهو منشاة تبرعت بها الولايات المتحدة لمساعدة المزارعين على تصفية حبوبهم من الشوائب، فاحرقوه هاتفين للوحدة وضد الاستعمار .
لم يكن والدي المعروف بحنكته الإدارية يناهض المتظاهرين، وإن لم يكن متفقاً معهم، وكان مستعدا على الدوام للسير في مقدمة المتظاهرين، كيلا يثير حفيظتهم، لكنه كان في كل مساء يتصل برؤسائه لوضعهم في صورة ما يحدث، وعلى العكس منه كان مدير ناحية الكفارات قد شتم المتظاهرين، وهددهم بمسدس كان يحمله، فأوسعوه ضرباً حتى أدخلوه المستشفى .
لم تكن العواطف واضحة، ولا المواقف السياسية، فهؤلاء المتظاهرون أنفسهم هم من سير المظاهرات المؤيدة للملك الراحل الحسين، حين أعلنت الحكومة الاردنية أنه نجا بطائرته من محاولات بذلها الطيران السوري لإجباره على الهبوط في سوريه، حين كان في رحلة رسمية إلى الجمهورية التركية، كان الحديث عن حنكة الملك وجراته ومهارته كطيار قد إستحوذت على قلوب الناس، الذين جابوا الشوارع مهنئين ملكهم بالنجاة، ومنددين بالمحاولة السورية الفاشلة.
علي الحياري وأوامر القمع
لم يطل صبر الحكومة كثيراً على الفوضى المندلعة في أحد أهم المراكز الحدودية الأردنية مع العالم، ففي الساعات الأولى من صبيحة يوم شديد البرودة، طرق ضابط باب بيتنا ليخبر والدي أنه مطلوب للحاكم العسكري للرمثا، إرتدى الرجل ثيابه على عجل، ليلتقي بزميل دراسته في السلط علي الحياري، الذي قاد كتائب من الجيش الاردني لفرض النظام على المدينة المتمردة، التي كان متظاهروها يطالبون قبل أيام بإعدام الملازم الأول عبد الرزاق الحباشنه، والذي كان يشغل مسؤولية المركز الحدودي، لكنهم لم يتمكنوا منه، وهي المدينة التي ختم متظاهروها بعض جوازات سفر المغادرين بعبارة جمهورية الرمثا.
كان الحياري يحمل أوامر يمكن القول ببساطة إنها قمعية، من قبيل مطالبته الاهالي بعدد كبير من قطع السلاح، التي قال إنها هُرّبت الى الرمثا من الجمهورية المجاورة، وكان ينوي هدم أجمل وأكبر عشرة منازل، وقد فرض حظر التجول، واعتقل رجالات البلدة وأهانهم، ويحكي الرمثاويون وأغانيهم عن تلك الفترة حكايات بعضها قابل للتصديق والآخر ياتي من قبيل المبالغات الرامية لتاكيد الظلم، الذي يعتقد أهالي المدينة أنهم تعرضوا له. وليس سراً ان والدي إستغل زمالته السابقة للحياري لتقليل حجم مطالبه القمعية، التي بات واضحاً أنها كانت للتخويف أكثر منها للتنفيذ.
درست الثاني الإبتدائي في مدرسة لم يكن بناؤها يتّسع لكافة الصفوف , فألحقوا بها ( خاناً ) كان معداً لزرب الحيوانات في بيت مجاور، كان طوله يتجاوز العشرين متراً، ولكم تخيل ماذا كان الجالس في المقعد الأخير يسمع من الأستاذ. كان معنا طالب يحمل معه كل يوم كاساً فارغة، ويغادر بعد الحصة الثانية ( خلال الفرصة ) إلى بقالة تقع في منتصف المسافة بين منزلهم والمدرسه، ومعه تعريفة، كان يقول إنه يشتري بها قفرة لغداء ذلك اليوم، رافقته مرة لاكتشف ان البائع يملأ نصف الكاس بزيت الزيتون، الذي كان يشكل الدسم لغداء ذلك الزميل .
في الصف الخامس، تزوج أحد زملائنا الطلاب، كان وحيد عائلته، وكان والده كبيراً في السن، فأراد أن يزوج إبنه ليفرح به، لكنه لم يكن يعرف أن ذلك الطفل كان يجد متعته في جمعنا صباح كل يوم، ليحدثنا بالتفصيل الممل عن أحداث الليلة االماضبة. لم يطل به الأمر طالباً، إذ كثيراً ما كان يغفو على طاولة الدراسة بسبب الأعباء التي كانت ملقاة على عاتقه في الليلة الماضية. ولعل ذلك الزواج هو ما فتح أعيننا على المسالة الجنسية، التي لم نكن نعرف عنها شيئاً، رغم أن بوادر الرجولة كانت تلوح على الكثيرين، خاصة أولئك الذين رسبوا في سنوات سابقة، فاعادوا دراسة الصف الواحد أكثر من سنة.
وللحديث عن الرمثا بقية، إن كان في العمر متسع.