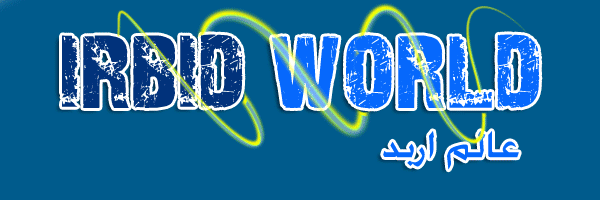إني حقاً لأشفق على المتابع للشأن الإقتصادي العالمي هذه الأيام , فالوضع في غاية الضبابية وقد أختلط السياسي بالإقتصادي , والشفافية سواءاً على مستوى الحكومات أو على مستوى الأسواق لم تكن أبداً أسوأ مما هي علية اليوم , فالمتابع عندما يستمع إلى التصريحات الرسمية سواءاً الصادرة عن الحكومات أو تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية وعندما يرى مستوى أسعار الأسهم في البورصات وأسواق المال العالمية إو ينظر إلى نتائج الشركات والبنوك الباهرة والتي تأتي دائماً مقرونة بعبارة “أفضل من التوقعات” في الربع الأول يقتنع إلى أن الأزمة أصبحت وراءنا بالفعل وأن الأقتصاد العالمي قد بدأ يتعافى بالفعل , لكن في المقابل عندما يستمع أو يقرأ تقارير المؤسسات المستقلة ووكالات التصنيف يجد عكس ذلك وتزداد حيرته عندما تزدحم الأرقام أمامه بعضها أيجابي الدلالة وبعضها سلبي الدلالة وبعضها الاَخر لا دلالة له على الإطلاق , لكن أين تكمن الحقيقة؟ هل فعلاً بدأ الإقتصاد العالمي في التعافي؟ أم أنه مجرد فجر كاذب.
أن التباين لا يكمن في تصريحات السياسيين والتقارير الإعلامية فحسب بل يمكن أيضاً في اَراء الخبراء والمراقبين , وهذا التباين في أراء الخبراء يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب أهمها المرجعية الأيدلوجية والأكاديمية لكل منهم , فأتباع المدرسة الكينزية التي تقول بضروة التدخل الحكومي في الإقتصاد يرون أن الإقتصاد العالمي بدأ بالفعل في إظهار علامات التعافي وذلك–حسب هذا الفريق- بفضل خطط الإنقاذ والتحفيز التي أقرتها إغلب دول العالم وأنه لولا هذا التدخل الكبير والسريع لكانت العواقب وخيمة , في حين يرى أتباع -مدرسة “فيينا” التي تقول بحاكمية الأسواق- أن الإقتصاد العالمي أبعد ما يكون عن التعافي وذلك بسبب التدخل الحكومي الذي إعاقها عوضاً عن تسريعها ويرى هذا الفريق كذلك أن الأزمة لم تكن سوى عملية تصحيح صحية كان يجب أن تترك لكي تأخذ مداها وانه دون ذلك لا يمكن الحديث عن تعافي والحقيقة أن التعافي لا يرتبط بمسألة التدخل الحكومي من عدمه بقدرما يرتبط بالاسباب الكامنة وراء الأزمة , كما أنه عند الحديث عن مسألة تعافي الإقتصاد العالمي لا يجب النظر في البيانات التي تخرج بين الحين والاَخر بقدر ما يجب النظر في إذا ما تم تدارك هذه الأسباب من قبل الحكومات من خلال خطط الإنقاذ والتحفيز التي أقرتها , يقر الكثير من المراقبين والسياسيين أن الأزمة كانت نتيجة خلل في الهياكل الإقتصادية في بعض الدول الغربية التي إنطلقت منها الأزمة وقصور كبير في التشريعات المنظمة للقطاع المصرفي وأسواق المال نتج عنه قصور كبير في الرقابة على عمل هذه الأسواق ما فتح الباب واسعاً للكثير من التجاوزات والمضاربات والممارسات التي أدت في المحصلة إلى ما يعاني منه الجميع اليوم , وبالنظر في الإجراءات التي إتخذتها الحكومات في مختلف الدول يمكن إدراجها في مجموعتين:
الأولى إجراءات إنقاذ تهدف إلى مساعدة الشركات والبنوك التي تعاني من صعوبات في التعامل مع ديونها نتيجة تراجع عائداتها أو تعاني من مشكلات في السيوله نتيجة العجز أو صعوبه الحصول على قروض , وتتلخص هذه الأجراءات في تقديم القروض الميسرة من قبل الحكومة أو تقديم ضمان حكومي لدائني الشركة مقابل إعادة هيكلة هذه الديون أو تقديم دعم مالي حكومي مقابل تملك الحكومة حصة أغلبية أو أقلية في الشركة كما يمكن أن تأخذ شكل مساعدة مالية مقابل إعادة هيكلة الشركة أو إندماجها أو الإستحواذ عليها من قبل شركة أخرى لتشكيل كيان أكثر كفاءة وتنافسية.
الثانية إجراءات تحفيز تهدف إلى دعم وتحفيز الإستهلاك الذي عادة ما يتراجع نتيجة حالة عدم اليقين التي تنتاب المستهلكين وتراجع مستوى الإئتمان وتشدد البنوك في عمليات الإقراض , وتأخذ هذه الإجراءات شكل إجراءات مالية مثل تخفيض الضرائب من ناحية وزيادة الإنفاق الحكومي من ناحية أخرى وذلك لتوفير السيولة الكافية لدى المستهلكين وتشجيعهم على الإنفاق , كما يمكن أن تأخذ شكل إجراءات نقدية –أستخدام السياسة النقدية- مثل تخفيض سعر الفائدة لتسهيل عمليات الإقراض وتشجيع البنوك على التوسع في إقراض الإفراد لزيادة السيولة في الإقتصاد كما أنها يمكن أن تأخذ شكل زيادة السيولة في الإقتصاد عن طريق طبع المزيد من النقود وهو ما يعرف بـ”التخفيف الكمي” (Quantitative Easing) وهو إجراء أخير لا تلجأ إليه الحكومات عادة إلا بعد إستنفاذ الإجراءت المالية والنقدية الإخرى وعند ما يكون سعر الفائدة قريب من الصفر وذلك لما ينطوي علية هذا الإجراء من مخاطرة كبيرة تتمثل في إمكانية خروج التضخم عن السيطرة أو إنهيار أسعار صرف العملة المحلية للدول التي تلجأ حكومتها إلية.
لقد قامت جميع الدول دون إستثناء على الإقل بإجراء واحد من هذه الإجراءات أبتداءاً بالولايات المتحدة والدول الأوروبية مروراً باليابان والصين ودول شرق اَسيا وإنتهاءاً بدول الشرق الأوسط الفقيرة والغنية وذلك بالرغم من إختلاف الهياكل الإقتصادية لهذه الدول , وذلك مرده إلى ضخامة الأزمة وأتساع نطاق تأثيرها والذي شمل كل الدول دون أستثناء , وقد بلغت المبالغ التي أنفقتها مختلف الدول من خلال خطط الإنقاذ والتحفيز عدة تريليونات إن لم يكن عشرات التريليونات من الدولارات , والحقيقة لا يوجد لدي رغم محدد بسبب صعوبة متابعةالمبالغ التي تم إنفاقها من قبل الحكومات لكن يمكن القول أنه رقم كبير وكبير جداً ولعل أزمة الديون السيادية التي تعاني منها الكثير من الدول الصناعية الكبرى خير دليل على ضخامة المبالغ التي تم إنفاقها , التي إعقتد جازماً أن كان لها –أي مبالغ خطط الإنقاذ والتحفيز- الفضل الأول والأخير في الأرقام الإيجابية التي بدأت تظهر في مختلف إقتصادات العالم خاصة في الغرب.
لذا لا إعتقد أنه يمكن القول بأن الإقتصاد العالمي –بالرغم من البيانات الإيجابية- قد خرج من منطقة الخطر أو القول بأن الأزمة قد أصبحت وراءنا كما يعتقد أو يريد أن يعتقد الكثير من السياسيين والمستثمرين بل أعتقد أننا لم نزل في عين العاصفة وأنها –أي الأزمة الإقتصادية- قد إنتقلت من طور إلى طور اَخر قد يكون أخطر وهو إنتقالها من قطاع البنوك والشركات إلى القطاع الحكومي , أن الدول في مكافحتها للأزمة قد وصلت إلى خط الدفاع الأخير ألا وهو الإنفاق الحكومي والذي أوصل مستويات الدين العام في الكثير من الدول إلى مرحلة الخطر ما دفع بعض الدول مثل اليونان إلى طلب المساعدة الخارجية.
كما أني لا أعتقد أنه يوجد أي مخرج يلوح في الأفق –حتى الاَن على الأقل- وذلك مرده إلى أن ما قامت به الحكومات لا يعدو أن تكون إجراءات تسكينية تتعامل مع أعراض المرض دون أن تعالج أسبابه , هذا بالإضافة إلى أن كل الحكومات –برغبه منها أو دون رغبة- عجزت عن إقرار أي إجراء للإصلاح سواءاً في القطاع المالي أو المصرفي خاصة سوق المشتقات المالية التي يتجاوز حجمه الـ 450 يريليون دولار والذي كان أحد أهم أسباب ومنابع الإزمة , ويبدو أن إخفاق إدارة الرئيس أوباما الإخير في الكونجرس لأصلاح النظام المالي لن يكون كذلك –أي الإخير- أو الوحيد وهو ما سيفتح الباب على مصارعيه للإزمة لأن تدخل مرحلة وتأخذ أبعاد جديدة تزيد من ضراوتها وتعقد عملية التعامل معها خاصة إذا ما زاد عدد الدول التي تعاني من مشكلة إرتفاع الديون السيادية والتي لن تجد من ينقذها عندما يأتي اليوم الذي فيه “يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أخيه