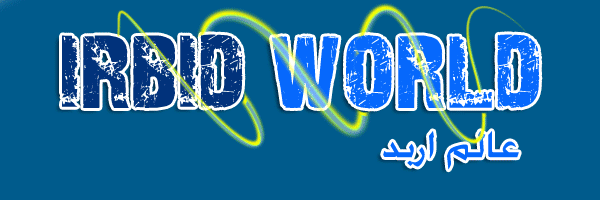الكماليات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كان الطالب يعيش ظروفا صعبة يذهب الى مدرسته الى قرية أخرى مجاورة مشياً على الاقدام. وكانت المدارس آنذاك تتكون من عدة غرف متواضعة حولها زرائب الغنم والبقر. والحقول الخضراء تنتشر عبر شبابيكها المتواضعة الى مد البصر.
كانت حقيبة الطالب على هيئة جيب كبير مصنوع من احد أكياس الطحين لها علاّقة طويلة توضع على الكتف. في داخل هذا الكيس عدة دفاتر معدودة الورق ممشوقة الخصر. بالإضافة الى رغيف من خبز القمح يأكله الطالب اذا قرصه الجوع أثناء المشي أو عند الفسحة المقررة بعد الحصة الثالثة.
ورغم تواضع المبنى المدرسي انذاك الا ان الرهبة كانت تختلج حيطانة البدائية واثاثه البسيط والذي كان عبارة عن بعض المقاعد المصفوقة يتوسطها من الأمام كرسي الاستاذ والذي لا يجوز لأحد ان يقترب منه أو يجلس عليه. بالإضافة الى لوح خشبي معلق على الحائط الأمامي يدوّن عليه الأستاذ ما يشاء لتلاميذه الانجاب.
كانت ملابس الطلاب انذاك رثة يختلجها التقطيع والتدوير تتناقلها اجيال عديدة من الصبية فاذا أصبحت ضيقة على أحدهم فإنه يُحتفظ بها لمن يأتي في المستقبل القريب والقادم الجديد ليلبسها هو بدوره لتدور معه عجلة الحياة ويتخرج من المدرسة ناجحا متفوقا.
ومع تلك الحياة البسيطة فقد كانت الغبظة والسرور عنوان تلك الفترة من ازاهير العمر.كان الطالب يدرس ليله على ضوء احد الفوانيس أو الأسرجة البسيطة. وكان طعامه من نتاج الحواكير وزرائب المعزى التي لم تكن تخلو من أي بيت في القرية.
كان الطالب يعمل بجد الى جانب امه وأبيه يحرث ويزرع ويعشب ويرعى الغنم ويحلب البقر وينظف تحتها ويصون مأواها. وفي الليل يهجع الطالب بعد ذلك البرنامج المضني الى كتبه وواجباته المدرسية. فيقرا بشغف ويقبل على كتبه بمجبة فتجده متفوقا نشيطا رغم كل الأعباء والأعمال التي يقوم بها.
لم يكن طالب الستينات يملك هاتفاً خلويا ولا سيارة تجثم على باب مدرسته. لم يكن يحمل مصروفا يشتري به ما يشاء بل لم يكن في مدارس ذلك الزمان مقاصف مدرسية أو دكاكين مجاورة أو حلويات متنوعة كثيرة مثل هذه الأيام باستثناء نوعين من الحلويات كان لها قدم السبق في تلك الايام الغابرة وهي الحلقوم و البسكويت فقد كان الذي يحصل على جزء منهما فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
اما تسريحات الشعر فقد كانت على نوعين لا ثالث لهما. الأولى وهي الحلق بواسطة الشفرة وهذه تكون اجبارية للطلاب ما دون الصف السادس الابتدائي أما الثانية أو التسريحة الثانية فهي ما كانت تدعى بالحلاقة الإفرنجيّة والتي كانت من حق طالب المرحلة الإعدادية فما فوق حيث كان يدفع الطالب قرشين كاملين للحصول عليها.
كان المعلم في ذاك الزمن مقدّرا مجلّلاً. إذا مرّ من أحد الشوارع أو الأزقة، فكأنما فُرض نوعٌ من حظر التجوّل على ذلك الشارع فلا يلحظ الاستاذ أحداً من تلاميذه يلعب أو يمشي في الشارع الذي يمر منه، باستثناء بعض الصبية الذين كانوا يسترقون النظر على حين غفلة منه.
أما الطالب فقد كان يجل ويقدر معلمه اعظم تقدير، ويعامله بمحبة ويزوره اذا مرض ويلقي عليه التحية اذا صادفه ولو بعد طول غياب لأنه غرس فيه حب العلم ومحبة الناس وتقديرهم.
ما اجمل تلك الأيام رغم علقمها وأحلى تلك اللحظات رغم صعوبتها وقلّة ابجديات الراحة فيها وندرة الزائفة التي افقدت طعم الطبيعة وزهو الحياة.
عودي يا ازهار بلادي بنواوير حقولك المعطاءة. عودي الينا فقد اشتقنا لعبق ريحك واشتقات عيوننا للاكتحال برحيقك الأصيل ولونك العليل.عودي يا ازهار بلادي الى عهد كرمك وجودك وبركتك التي كانت تستقي مطر الشتاء في كوانيين لتنشر عبيرها الفواح عند قطف ثمار الربيع وحصاد خيرات تموز. ها نحن بانتظارك فما زالت سهولك هي ذات السهول وجبالك هي ذات الجبال. فلم يتغير إلا الإنسان الذي انقلبت في أعماقه المشاعر وتغيرت في أنفاسه روح الأصاله الغابر الذي استقيناه ورضعناه من نهد الأمومة الدافيء وحنان أضلعها الرؤم.