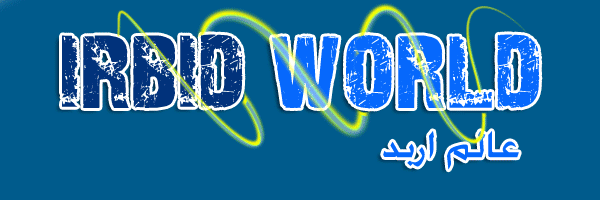هذا مبحث مهم في علوم القرآن بل هو أهم مباحثه جميعاً، لأن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن وأنه كلام الله، وأساس للتصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام حق. ثم هو أصل لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن. فلا جرم أن يتصدرها جميعاً، ليكون من تقريره وتحقيقه سبيلٌ إلى تقريرها وتحقيقها. وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس ودعام؟ ولأجل الإحاطة بهذا المطلب العزيز، نتكلم (إن شاء الله) على معنى نزول القرآن، ثم على مرات هذا النزول، ودليل كل نزول، وكيفيته، وحكمته، ثم على الوحي وأدلته العقلية والعلمية، مع دفع الشبهات الواردة في ذلك المقام. تنزلات القرآن شرف الله هذا القرآن بأن جعل له ثلاثة تنزلات: 1- التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ. ودليله قول الله سبحانه: (بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ) (سورة البروج، الآيتان: 21 – 22). وكان هذا الوجود في اللوح بطريقة وفي وقت لا يعلمها إلا الله تعالى، ومن اطلع على غيبه. وكان جملة لا مفرقاً، لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق، ولا صارف عنه. ولأن أسرار تنجيم القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل تحققها في هذا التنزل. وحكمة هذا النزول، ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح نفسه، وإقامته سجلاً جامعاً لكل ما قضى الله وقدر، وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين. فهو شاهد ناطق، ومظهر من أروع المظاهر، الدالة على عظمة الله، وعلمه، وإرادته، وحكمته، وواسع سلطانه وقدرته، ولا ريب أن الإيمان به يقوي إيمان العبد بربه من هذه النواحي، ويبعث الطمأنينة إلى نفسه، والثقة بكل ما يظهره الله لخلقه، من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه، وسائر أقضيته وشؤونه في عباده، كما يحمل الناس على السكون والرضا، تحت سلطان القضاء والقدر، ومن هنا تهون عليهم الحياة بضرائها وسرائها، كما قال (جل شأنه) (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور) (سورة الحديد، الآيتان: 22 – 23) اهـ وللإيمان باللوح وبالكتابة فيه، أثرٌ صالح في استقامة المؤمن على الجادة، وتفانيه في طاعة الله ومراضيه، وبعده عن مساخطه ومعاصيه، لاعتقاده أنها مسطورة عند الله في لوحه. مسجلة لديه في كتابه. كما قال جل ذكره: (وكل صغير وكبير مستطر) (سورة القمر، الآية: 53) اهـ ب- التنزل الثاني للقرآن كان هذا التنزل الثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والدليل عليه قوله سبحانه في سورة الدخان: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) (الآية: 3). وفي سورة البقرة: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) (الآية: 185) وفي سورة القدر: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) (الآية 1) دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة، توصف بأنها مباركة أخذاً من آية الدخان، وتسمى ليلة القدر أخذاً من آية سورة القدر، وهي من ليالي شهر رمضان أخذاً من آية البقرة. وإنما قلنا ذلك جمعاً بين هذه النصوص في العمل بها، ودفعاً للتعارض فيما بينها. ومعلوم بالأدلة القاطعة (كما يأتي) أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً لا في ليلة واحدة، بل في مدى سنين عدداً، فتعين أن يكون هذا النزول الذي نوهت به هذه الآيات الثلاث نزولاً آخر غير النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول وأنه في بيت العزة من السماء الدنيا، كما تدل الروايات الآتية: 1- أخرج الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: " فُصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. 2- وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: " أُنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة " ثم قرأ: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) (سورة الفرقان، الآية: 33). (وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً) (سورة الإسراء، الآية: 106) 3- وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض ". 4- وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) (سورة البقرة، الآية: 185)، وقوله: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) (سورة القدر، الآية: 1). وهذا أنزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، وفي المحرم، وصفر، وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رِسلاً في الشهور والأيام ". قال أبو شامة: رسلاً أي رفقاً وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطها ؛ يريد أنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم مفرقاً، يتلو بعضه بعضاً على تؤدة ورفق. هذه أحاديث أربعة من جملة أحاديث ذكرت في هذا الباب، وكلها صحيحة كما قال السيوطي، وهي أحاديث موقوفة على ابن عباس، غير أن لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مقرر من أن قول الصحابي ما لا مجال للرأي فيه ولم يُعرف بالأخذ عن الإسرائليات، كلمة حكم المرفوع. ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تُعرف إلا من المعصوم، وابن عباس لم يُعرف بالأخذ عن الإسرائليات فثبت الاحتجاج بها. وكان هذا النزول جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر كما علمت ؛ لأنه المتبادر من نصوص الآيات الثلاث السابقة، وللتنصيص على ذلك في الأحاديث التي عرضناها عليك. بل ذكر السيوطي أن القرطبي نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهناك قول ثان بنزول القرآن إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين ينزل في كل ليلة قدر منها ما يقدَّر الله إنزاله في كل السنة، ثم ينزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة على النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة قول ثالث: إنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر ؛ ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة من سائر الأزمان على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن صاحب هذا القول ينفي النزول جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر. وذكروا قولاً رابعاً أيضاً أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وان الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. ولكن هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة بمعزل عن التحقيق، وهي محجوجة بالأدلة التي سُقناها بين يديك تأييداً للقول الأول. والحكمة في هذا النزول، على ما ذكره السيوطي نقلاً عن أبي شامة – هي تفخيم أمره (أي القرآن) وأمر من نزل عليه، بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، وبإنزاله مرتين، مرة جملة ومرة مفرقاً. وذكر بعضهم أن النزول إلى السماء الدنيا إلهاباً لشوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه على حد قول القائل: وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الخيام من الخيام أقول: وفي تعدد النزول وأماكنه، مرة في اللوح، وأخرى في بيت العزة، وثالثة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: في ذلك التعدد مبالغة في نفي الشك عن القرآن وزيادة للإيمان به، وباعث على الثقة فيه، لأن الكلام إذا سُجل في سجلات متعددة، وصحت له وجودات كثيرة، كان ذلك أنفى للريب عنه وأدعى إلى تسليم ثبوته، وأدنى إلى وفرة الإيقان به، مما لو سجل في سجل واحد، أو كان له وجود واحد. ج- التنزل الثالث للقرآن هذا هو واسطة عقد التنزلات، لأنه المرحلة الأخيرة التي منها شع النور على العالم ؛ ووصلت هداية الله إلى الخلق، وكان هذا النزول بواسطة أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليله قول الله تعالى في سورة الشعراء مخاطباً لرسوله عليه الصلاة والسلام: (نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين) (الآيات: 193 – 195) كيفية أخذ جبريل للقرآن، وعمن أخذ؟ هذا من أنباء الغيب. فلا يطمئن الإنسان إلى رأي فيه إلا إن ورد بدليل صحيح عن المعصوم، وكل ما عثرنا عليه أقوال منثورة هنا وهناك، نجمعها لك فيما يأتي مع إبداء رأينا في كل منها: أولها: قال الطيبي: " لعل نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفاً روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ، فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه إليه " اهـ. وأنت خبير بأن كلمة (لعل) لا تشفي غليلاً، ولا تهدينا إلى المقصود سبيلاً، ولا نستطيع أن نأخذ منها دليلاً. ثانيهما: حكى الماوردي أن الحفظة نجمت القرآن على جبريل في عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم عشرين سنة اهـ ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الحفظة نجوماً عشرين. ولكن لا نعرف لصاحب هذا الرأي دليلاً ولا شبه دليل. ثالثها: قال البيهقي في معنى قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) (سورة القدر، الآية: 1) " يريد (والله أعلم) إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع " اهـ. ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله سماعاً. وذلك فيما أرى أمثل الأقوال من ناحية أخذ جبريل عن الله لا من ناحية تأويل النزول في الآية بابتداء النزول. ويؤيده ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجداً فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله بوحيه بما أراد، فينتهي به إلى الملائكة فكلما مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق، فينتهي به حيث أمر". وأياً ما تكن هذه الأقوال، فإن هذا الموضوع لا يتعلق به كبير غرض، مادمنا نقطع بأن مرجع التنزيل هو الله تعالى وحده. ما الذي نزل به جبريل؟ ولتعلم في هذا المقام، أن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن باعتبار أنه الألفاظ الحقيقية المعجزة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس. وتلك الألفاظ هي كلام الله وحده، لا دخل لجبريل ولا لمحمد في إنشائها وترتيبها، بل الذي رتبها أولاً هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تنسب له دون سواه، عمن نطق بها جبريل ومحمد، وملايين الخلق من بعد جبريل ومحمد، من لدن نزول القرآن إلى يوم الساعة. وذلك كما ينسب الكلام البشري إلى من أنشأه ورتبه في نفسه أولاً دون غيره، ولو نطق به آلاف الخلائق، في آلاف الأيام والسنين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله (جلت حكمته) هو الذي أبرز ألفاظ القرآن وكلماته مرتبة على وفق ترتيب كلماته النفسية لأجل التفهيم والتفهم، كما نبرز نحن كلامنا اللفظي على وفق كلامنا النفسي لأجل التفهيم والتفهم، ولا ينسب الكلام بحال إلا إلىمن رتبه في نفسه أولاً، دون من اقتصر على حكايته وقراءته، ولذلك لا يجوز إضافة القرآن على سبيل الإنشاء إلى جبريل أو محمد، ولا لغير جبريل ومحمد، كما لا يجوز نسبة كلام أنشأه شخص ورتبه في نفسه أولاً إلى شخص آخر حكاه وقرأه حين اطلع عليه أو سمعه. وقد أسفّ بعض الناس فزعم أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن، والرسول يعبر عنها بلغة العرب. وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنى فقط وكلاهما قول باطل أثيم، مصادم لصريح الكتاب والسنة والإجماع، ولا يساوي قيمة المداد الذي يكتب به. وعقيدتي أنه مدسوس على المسلمين في كتبهم. وإلا فكيف يكون القرآن حينئذ معجزاً واللفظ لمحمد أو جبريل؟ ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس لله؟ مع أن الله يقول: (حتى يسمع كلام الله) (سورة التوبة، الآية: 6)، إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله. والحق أنه ليس لجبريل في هذا القرآن سوى حكايته للرسول وإيحائه إليه، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن سوى وعيه وحفظه، ثم حكايته وتبليغه، ثم بيانه وتفسيره، ثم تطبيقه وتنفيذه. نقرأ في القرآن نفسه أنه ليس من إنشاء جبريل ولا محمد نحو: (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) (سورة النمل، الآية: 6). ونحو: (وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي) (سورة الأعراف، الآية: 203). ونحو: (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) (سورة يونس ن الآية: 15). ونحو: (ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين) (سورة الحاقة، الآيات: 44 – 47) ثم إن ما ذكرناه هو تحقيق ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وإن كان قد نزل عليه أيضاً غير القرآن ؛ نقل السيوطي عن الجويني أنه قال: " كلام الله المنزل قسمان: قسم: قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه: إن الله يقول افعل كذا وكذا، وأمر بكذا وكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي، وقال له ما قاله ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة، كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة، واجمع جندك للقتال، فإن قال الرسول: يقول لك الملك: لا تتهاون في خدمتي، ولا تترك الجند يتفرق، وحثهم على المقاتلة، لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة. وقسم آخر: قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب، فنزل به جبريل من الله من غير تغيير، كما يكتب الملك كتاباً ويسلمه إلى أمين، ويقول اقرأه على فلان، فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفاً " اهـ. قال السيوطي بعد ذلك: قلت: القرآن هو القسم الثاني، والقسم الأول هو السنة. كما ورد أن جبريل كان ينزل بالقرآن، ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى لأن جبريل أداها بالمعنى. ولم تجز القراءة بالمعنى لأن جبريل أدى القرآن باللفظ، ولم يُبح له أداؤه بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه. والتخفيف على الأمة لا يحاط به كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه. والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم على قسمين: قسم يروونه بلفظه الموحى به، وقسم يروونه بالمعنى. ولو جعل مما يروى باللفظ لشق، أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف فتأمل اهـ. أقول: وهذا كلام نفيس، بيد أنه لا دليل أمامنا على أن جبريل كان يتصرف في الألفاظ الموحاة إليه في غير القرآن. وما ذكره الجويني فهو احتمال عقلي لا يكفي في هذا الباب. ثم إن هذا التقسيم خلا من قسم ثالث للكتاب والسنة، وهو الحديث القدسي الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حاكياً عن الله تعالى، فهو كلام الله تعالى أيضاً، غير أنه ليست فيه خصائص القرآن التي امتاز بها عن كل ما سواه. ولله تعالى حكمة في أن يجعل من كلامه المنزل معجزاً وغير معجز، لمثل ما سبق في حكمة التقسيم الآنف، من إقامة حجة للرسول ولدين الحق بكلام الله المعجز، ومن التخفيف على الأمة بغير المعجز، لأنه تصح روايته بالمعنى، وقراءة الجنب وحمله له ومسه إياه، إلى غير ذلك. وصفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه من الله اتفاقاً، وأن الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من الله على المشهور، والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. بيد أن القرآن له خصائصه من الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظة على أدائه بلفظه ونحو ذلك، وليس للحديث القدسي والنبوي شيء من هذه الخصائص. والحكمة في هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآن، فلو أبيح أداؤه بالمعنى لذهب إعجازه، وكان مظنة للتغيير والتبديل، واختلاف الناس في أصل التشريع والتنزيل. أما الحديث القدسي والحديث النبوي فليست ألفاظهما مناط إعجاز، ولهذا أباح الله روايتهما بالمعنى، ولم يمنحهما تلك الخصائص والقداسة الممتازة التي منحها القرآن الكريم، تخفيفاً على الأمة، ورعاية لمصالح الخلق في الحالين من مَنْحٍ ومَنْعٍ (إن الله بالناس لرؤوف رحيم) (سورة الحج، الآية: 65) مدة هذا النزول وابتدأ هذا الإنزال من مبعثه عليه الصلاة والسلام، وانتهى بقرب انتهاء حياته الشريفة، وتُقدر هذه المدة بعشرين أو ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين عاماً، تبعاً للخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة، أكانت عشر سنين أن ثلاث عشرة أو خمس عشرة سنة أما مدة إقامته بالمدينة فعشر سنين اتفاقاً. كذلك قال السيوطي. ولكن بعض محققي التشريع الإسلامي يذكر أن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً من 17 رمضان سنة 41 من مولده الشريف إلى أول ربيع الأول سنة 54 منه. أما مدة إقامته في المدينة بعد الهجرة فهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من أول ربيع الأول سنة 54 من مولده إلى تاسع ذي الحجة سنة 63 منه. ويوافق ذلك سنة عشر من الهجرة. وهذا التحقيق قريب من القول بأن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر سنين، وأن مدة الوحي بالقرآن ثلاثة وعشرون عاماً. ولكن هذا التحقيق لا يزال في حاجة إلى تحقيقات ثلاثة ؛ ذلك لأنه أهمل من حسابه باكورة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا الصادقة ستة أشهر، على حين أنها ثابتة في الصحيح. ثم جرى فيه على أن ابتداء نزول القرآن كان ليلة السابع عشر من رمضان وهي ليلة القدر على بعض الآراء، غير أنه يخالف المشهور الذي يؤيده الصحيح. ثم ذهب فيه مذهب القائلين بأن آخر ما نزل من القرآن هو آية (اليوم أكملت لكم دينكم) (سورة المائدة، الآية: 3) وذلك في تاسع ذي الحجة سنة عشرة من الهجرة، وسترى في مبحث آخر ما نزل من القرآن أن هذا المذهب غير صحيح. دليل تنجيم هذا النزول والدليل على تفرق هذا النزول وتنجيمه، قول الله – تعالت حكمته – في سورة الإسراء: (وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً) (سورة الإسراء، الآية: 106) وقوله في سورة الفرقان: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) (سورة الفرقان، الآيتان: 32 – 33). روي أن الكفار من يهود ومشركين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن مفرقاً، واقترحوا عليه أن ينزل جملة، فأنزل الله هاتين الآيتين رداً عليهم، وهذا الرد يدل على أمرين: أحدهما: أن القرآن نزل مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: أن الكتب السماوية من قبله نزلت جملة، كما اشتهر ذلك بين جمهور العلماء حتى كاد يكون إجماعاً. ووجه الدلالة على هذين الأمرين. أن الله تعالى لم يكذبهم فيما ادعوا من نزول الكتب السماوية جملة، بل أجابهم ببيان الحكمة من نزول القرآن مفرقاً، ولو كان نزول الكتب السماوية مفرقاً كالقرآن لرد عليهم بالتكذيب، وبإعلان أن التنجيم هو سنة الله فيما أنزل على الأنبياء من قبل، كما رد عليهم بقوله: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) (سورة الفرقان، الآية: 20). حين طعنوا على الرسول وقالوا: (مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) (سورة الفرقان، الآية: 7). اهـ الحكم والأسرار في تنجيم القرآن لتنجيم نزول القرآن الكريم أسرار عديدة وحكم كثيرة، نستطيع أن نجملها في أربع حكم رئيسية: الحكمة الأولى: تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوية قلبه، وذلك من وجوه خمسة: الوجه الأول: أن في تجدد الوحي، وتكرار نزول الملك به من جانب الحق إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سروراً يملأ قلب الرسول، وغبطة تشرح صدره، وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه العناية الإلهية، وتعهد مولاه إياه في كل نوبة من نوبات هذا النزول. الوجه الثاني: أن في التنجيم تيسيراً عليه من الله في حفظه وفهمه، ومعرفة أحكامه وحكمه، وذلك مُطمئن له على وعي ما يُوحى إليه حفظاً وفهماً، وأحكاماً وحكماً، كما أن فيه تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله. الوجه الثالث: أن في كل نوبة من نوبات هذا النزول المنجم معجزة جديدة غالباً، حيث تحداهم كل مرة أن يأتوا بمثل نوبة من نوب التنزيل، فظهر عجزهم عن المعارضة، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولاشك أن المعجزة تشد أزره وتُرهف عزمه، باعتبارها مؤيدة له ولحزبه. خاذلة لأعدائه ولخصمه. الوجه الرابع: أن في تأييد حقه ودحض باطل عدوه – المرة بعد الأخرى – تكراراً للذة فوزه، وفَلَجه بالحق والصواب. وشهود لضحايا الباطل في كل مهبطٍ للوحي والكتاب. وإنْ كل ذلك إلا مشجع للنفس مقو للقلب والفؤاد. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله، هو الفرق بين الشيء وأثره، أو الملزوم ولازمه، فالمعجزة من حيث أنها قوة للرسول ومؤيدة له مطمئنة له ومثبتة لفؤاده، بقطع النظر عن أثر انتصاره وهزيمة خصمه بها. ثم إن هذا الأثر العظيم وحده مطمئن لقلبه الكريم ومثبت لفؤاده أيضاً، أشبه شيء بالسلاح: وجوده في يد الإنسان مُطمئن له ولو لم يستعمله في خصمه، ثم انتصار الإنسان وهزيمة خصمه به إذا أعمله فيه مطمئن للفؤاد مريح للقلب مرة أخرى. الوجه الخامس: تعهد الله إياه عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه بما يهون عليه هذه الشدائد. ولا ريب أن تلك الشدائد كانت تحدث في أوقات متعددة، فلا جرم كانت التسلية تحدث هي الأخرى في مرات متكافئة. فكلما أحرجه خصمه، سلاَّه ربه. وتجيء تلك التسلية تارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين، التي لها في القرآن عرض طويل، وفيها يقول الله: (وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) ( الآية: 120) من سورة هود. وتارة تجيء التسلية عن طريق وعد الله لرسوله بالنصر والتأييد والحفظ، كما في قوله سبحانه في سورة الطور: (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيينا) ( الآية: 48) وقوله في سورة المائدة: (والله يعصمك من الناس) ( الآية: 67) ونحو ما في سورتي الضحى وألم نشرح من الوعود الكريمة، والعطايا العظيمة. وطوراً تأتيه التسلية عن طريق إبعاد أعدائه وإنذارهم نحو قوله تعالى في سورة القمر: (سيهزم الجمع ويولون الدبر) ( الآية: 45) وقوله سبحانه في سورة فصلت: (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) ( الآية: 13)، وطوراً آخر ترد التسلية في صورة الأمر الصريح بالصبر نحو قوله جل شأنه في سورة الأحقاف: (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) ( الآية: 35) أو في صورة النهي عن التفجع عليهم ؛ والحزن منهم ؛ نحو قول الله في سورة فاطر: (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) ( الآية: 8) ونحو قوله سبحانه في خواتم سورة النحل:(واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون) (الآية: 127) ومن موارد تسلية الله لرسوله أن يخوفه عواقب حزنه من كفر أعدائه نحو: (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) ( الآية: 3) في فاتحة سورة الشعراء. ومنها أن يؤيسه منهم ليستريح ويتسلى عنهم نحو: (وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم يآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون) ( الآيتان: 35 – 36) من سورة الأنعام. ويمكن أن تندرج هذه الحكمة بوجوهها الخمسة تحت قول الله في بيان الحكمة من تنجيم القرآن: (كذلك لنثبت به فؤادك) ( الآية: 31) من سورة الفرقان. الحكمة الثانية: التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملاً، وينضوي تحت هذا الإجمال أمور خمسة أيضاً: أولها: تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية، وهي كما علمت كانت أمة أمية. وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتهم، وكانت مُشتغلة بمصالحها المعاشية، وبالدفاع عن دينها الجديد بالحديد والدم، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، فاقتضت الحكمة العليا أن ينزله الله إليهم مفرقاً ليسهل عليهم حفظه، ويتهيأ لهم استظهاره. ثانيها: تسهيل فهمه عليهم كذلك، مثل ما سبق في توجيه التيسير في حفظه. ثالثها: التمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة، وعبادتهم الفاسدة وعاداتهم المرذولة. وذلك بأن يُراضوا على هذا التخلي شيئاً فشيئاً، بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئاً فشيئاً، فكلما نجح الإسلام معهم في هدم باطل، انتقل بهم إلى هدم باطل آخر، وهكذا يبدأ بالأهم ثم بالمهم، حتى انتهى بهم آخر الأمر عن تلك الأرجاس كلها فطهرهم منها وهم لا يشعرون بَعَنتٍ ولا حرج، وفطمهم عنها دون أن يرتكسوا في سابق فتنة أو عادة. وكانت هذه سياسة رشيدة، لابد منها في تربية هذه الأمة المجيدة لاسيما أنها كانت أبية معاندة، تتحمس لموروثاتها، وتستميت في الدفاع عما تعتقده من شرفها ؛ وتتهور في سفك الدماء وشن الغارات، لأتفه الأسباب. رابعها: التمهيد لكمال تحليهم بالعقائد الحقة، والعبادات الصحيحة، والأخلاق الفاضلة، بمثل تلك السياسة الرشيدة السابقة. ولهذا بدأ الإسلام بفطامهم عن الشرك والإباحة، وإحياء قلوبهم بعقائد التوحيد والجراء، من جراء ما فتح عيونهم عليه من أدلة التوحيد، وبراهين البعث بعد الموت، وحُجج الحساب والمسؤولية والجزاء. ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات فبدأهم بفرضية الصلاة قبل الهجرة، وثنى بالزكاة وبالصوم في السنة الثانية من الهجرة، وختم بالحج في السنة السادسة منها. وكذلك كان الشأن في العادات: زجرهم عن الكبائر وشدد النكير عليهم فيها. ثم نهاهم عن الصغائر في شيء من الرفق، وتدرج بهم في تحريم ما كان متأصلاً فيهم كالخمر … تدرجاً حكيماً حقق الغاية، وأنقذهم من كابوسها في النهاية. وكان الإسلام في انتهاج هذه الخطة المثُلى أبعد نظراً، وأهدى سبيلاً، وانجح تشريعاً، وأنجع سياسة، من تلكم الأمم المتمدنة المتحضرة التي أفلست في تحريم الخمر على شعوبها أفظع إفلاس، وفشلت أمرَّ فشل. وما عهد أمريكا في مهزلة تحريمها ببعيد.! أليس ذلك إعجازاً للإسلام في سياسة الشعوب، وتهذيب الجماعات، وتربية الأمم؟ بلى، والتاريخ على ذلك من الشاهدين !! خامسها: تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين، بسبب ما كان يقصه القرآن عليهم الفينة بعد الفينة والحين بعد الحين، من قصص الأنبياء والمرسلين وما كان لهم ولأتباعهم مع الأعداء والمخالفين، وما وعد الله به عباده الصالحين، من النصر والأجر والتأييد والتمكين. والآيات في ذلك كثيرة حسبك منها قول العلي الكبير في سورة النور: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) (سورة النور، الآية: 55). وقد صدق الله وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) (سورة الأنعام، الآية: 45) ويمكن أن تندرج هذه الحكمة الثانية بما انضوى تحتها في قول الله تعالى في سورة الإسراء: (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) (سورة الإسراء، الآية: 106) كما يمكن أن يفسر بها قوله تعالى في سورة الفرقان في بيان أسرار التنجيم (ورتلناه ترتيلاً) (سورة الفرقان، الآية: 32) باعتبار أن التنوين للتعظيم إشارة إلى المعاني المنطوية تحت هذا الترتيل. الحكمة الثالثة: مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها، فكلما جد منهم جديد، نزل من القرآن ما يناسبه، وفصَّل الله لهم من أحكامه ما يوافقه. وتنتظم هذه الحكمة أموراً أربعة: أولها: إجابة السائلين على أسئلتهم عندما يوجهونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبت من رسالته. كما قال الله تعالى في جواب سؤال أعدائه إياه. (ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) (سورة الإسراء، الآية: 85) في سورة الإسراء. وقوله: (ويسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً) (سورة الكهف، الآية: 83) إلخ الآيات في هذا الموضوع من سورة الكهف. أم كانت لغرض التنور ومعرفة حكم الله كقوله تعالى في سورة البقرة: (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو) (سورة البقرة، الآية: 219) (ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) (سورة البقرة، الآية: 220) ولا ريب أن تلك الأسئلة كانت تُرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، وعلى نوبات متعددة، حاكية أنهم سألوا ولا يزالون يسألون. فلا بدع أن ينزل الجواب عليها كذلك في أوقاتها المختلفة، ونوباتها المتعددة. ثانيها: مُجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حُكم الله فيها عند حدوثها ووقوعها. ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة، بل وقعت تفصيلاً وتدريجاً. فلا مناص إذن من فصل الله فيها بنزول القرآن على طبقها تفصيلاً وتدريجاً. والأمثلة على هذا كثيرة، منها قوله سبحانه في سورة النور: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) (سورة النور، الآية: 11) إلى قوله سبحانه: (أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) (سورة النور، الآية: 26) وهن عشر آيات نزلن في حادث من أروع الحوادث: هو اتهام السيدة الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك. وفيها دروس اجتماعية لا تزال تقرأ على الناس، كما لا تزال تُسجل براءة الْحَصانِ الطاهرة من فوق سبع سموات. ومن الأمثلة قوله تعالى في مُفتتح سورة المجادلة: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) (سورة لمجادلة، الآية: 1) إلى قوله تعالى: (وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) (سورة المجادلة، الآية: 4) وهن ثلاث آيات نزلن عندما رفعت خَوْلة بنت ثَعْلَبَة شكواها إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم من أن زوجها أوْس بن الصامت ظاهر منها، وجادلت الرسول بأن معها صبية صغاراً إن ضمتهم إلى زوجها ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا. ثالثها: لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي يخطئون فيها وإرشادهم إلى شاكلة الصواب في الوقت نفسه. ولا ريب أن تلك الأغلاط كانت في أزمان متفرقة، فمن الحكمة أن يكون القرآن النازل في إصلاحها، متكافئاً معها في زمانها. اقرأ إن شئت قوله سبحانه في سورة آل عمران: (وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال) (سورة آل عمران، الآية: 121) إلى آيات كثيرة بعدها، وكلها نزلت في غزوة أحد إرشاداً للمسلمين إلى مواضع أخطائهم في هذا الموقف الرهيب والمأزق العصيب. وكذلك اقرأ قوله سبحانه في سورة التوبة: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم) (سورة التوبة، الآيات: 25 – 27) وهي آيات تردع المؤمنين عن رذيلة الإعجاب والاغترار في يوم من أيام الله، وتلفت نظرهم إلى مقدار تدارك الله لهم في شدتهم، وإلى وجوب أن يثوبوا إلى رشدهم، ويتوبوا إلى ربهم. رابعها: كشف حال أعداء الله المنافقين، وهتك أستارهم وسرائرهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كيما يأخذوا منهم حذرهم فيأمنوا شرهم. وحتى يتوب من شاء منهم. اقرأ – إن شئت – قوله تعالى في سورة البقرة: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) إلى قوله: (إن الله على كل شيء قدير) (سورة البقرة، الآيات: 8 – 20) وهن ثلاث عشرة آية فضحت المنافقين، كما فضحتهم سورة التوبة في كثير من الآيات، وكما كشف القرآن أستارهم في كثير من المناسبات ؛ ويمكن أن تندرج هذه الحكمة الثالثة بمضامينها الأربعة في قول الله تعالى في تلك الآية من سورة الفرقان: (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) (سورة الفرقان، الآية: 33) الحكمة الرابعة: الإرشاد إلى مصدر القرآن، إنه كلام الله وحده، وإنه لا يمكن أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام مخلوق سواه. وبيان ذلك أن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذٌ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجُمله، يجري دَمُ الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل كأنه حلقة مُفرغةٌ ! أو كأنه سمط وحيد وعقد فريدٌ يأخذ بالأبصار: نُظمت حروفه وكلماته، ونسقت جُمله وآياته، وجاء آخره مُساوقاً لأوله، وبدا أوله مواتياً لآخره !! وهنا نتساءل: كيف اتسق للقرآن هذا التآلف المعجز؟ وكيف استقام له هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة، بل تنزل آحاداً مفرقة تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين عاماً ! ! الجواب: أننا نلمح هنا سراً جديداً من أسرار الإعجاز، ونشهد سمة فذة من سمات الربوبية، ونقرأ دليلاً ساطعاً على مصدر القرآن، إنه كلام الواحد الديان (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) (سورة النساء، الآية: 82) وإلا فحدثني – بربك – كيف تستطيع أنت؟ أم كيف يستطيع الخلق جميعاً أن يأتوا بكتاب محكم الاتصال والترابط، متين النسج والسرد، متآلف البدايات والنهايات، مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجية عن مقدور البشر، وهي وقائع الزمن وأحداثه التي يجيء كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تبعاً لها، ومتحدثاً عنها: سبباً بعد سبب، وداعية إثر داعية، مع اختلاف ما بين هذه الدواعي، وتغاير ما بين تلك الأسباب، ومع تراخي زمان هذا التأليف، وتطاول آماد هذه النجوم، إلى أكثر من عشرين عاماً. لا ريب أن هذا الانفصال الزماني، وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي، يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال، ولا يدعان مجالاً للارتباط والاتصال بين نجوم هذا الكلام. أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضاً: نزل مفرقاً منجماً، ولكنه تم مترابطاً محكماً. وتفرقت نجومه تفرق الأسباب، ولكن اجتمع نظمه اجتماع شمل الأحباب. ولم يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عاماً، ولكن تكامل انسجامه بداية وختاماً !! أليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق القوى والقدر، ومالك الأسباب والمسببات، ومدبر الخلق والكائنات، وقيوم الأرض والسموات، العليم بما كان وما سيكون، الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون؟؟ لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه آية أو آيات، قال " ضموها في مكان كذا من سورة كذا ". وهو بشر لا يدري (طبعاً) ما ستجيء به الأيام، ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان، ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث فضلاً عما سينزل من الله فيها. وهكذا يمضي العمر الطويل والرسول على هذا العهد، يأتيه الوحي بالقرآن نجماً بعد نجم، وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم، وينتظم ويتآخى ويأتلف ويلتئم، ولا يؤخذ عليه أدنى تخاذل ولا تفاوت، بل يُعجز الخلق طُرًّا بما فيه من انسجام ووحدة وترابط: (كتاب أحكمت آيته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) (سورة هود، الآية: 1) !! وإنه ليستبين لك سر هذا الإعجاز، إذا ما علمت أن محاولة مثل هذا الاتساق والانسجام، لن يمكن أن يأتي على هذا النمط الذي نزل به القرآن ولا على قريب من هذا النمط، لا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام غيره من البلغاء، وغير البلغاء. خذ مثلاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما هو في روعته وبلاغته، وطهره وسموه: لقد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات مختلفة، لدواع متباينة، في أزمان متطاولة، فهل في مُكنتك ومُكنة البشر معك، أن ينظموا من هذا السرد الشتيت وحده، كتاباً واحداً يصقله الاسترسال والوحدة، من غير أن ينقصوا منه أو يتزيدوا عليه أو يتصرفوا فيه؟؟ ذلك ما لن يكون، ولا يمكن أن يكون، ومن حاول ذلك فإنما يحاول العبث، ويخرج للناس بثوب مرقع، وكلام ملفق ينقصه الترابط والانسجام، وتعوزه الوحدة والاسترسال، وتمجُّه الأسماع والأفهام. إذن فالقرآن الكريم ينطق نزوله منجماً بأنه كلام الله وحده. وتلك حكمة جليلة الشأن، تدل الخلق على الحق في مصدر القرآن ! (قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيما) (سورة الفرقان، الآية: 6)