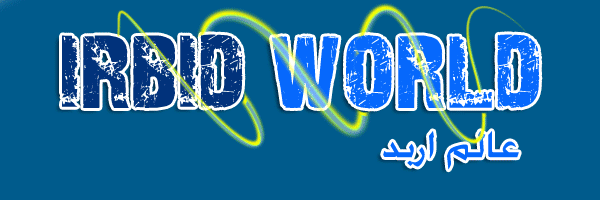نظر الملك حسين وقتها إلى الهجوم الإسرائيلي على السموع بصورة أكثر خطورة واعتبره مؤشرا على تغير في الموقف الإسرائيلي تجاه نظامه، بل وكجزء من مخطط أكبر حجما لإثارة حرب تتمكن قوات الدفاع الإسرائيلية من خلالها من الاستيلاء على الضفة الغربية، إلا انه لم يظهر دليل يعزز شكوكه في هذا الشأن، على الأقل من جانب الحكومة الإسرائيلية بقيادة حزب العمل. ومن الجانب الإسرائيلي زعم اسحق رابين، الذي كان في ذلك الوقت رئيسا لأركان قوات الدفاع الإسرائيلية، ان بعضا من العواقب الخطيرة لم يكن متعمدا، وأكد مرارا على ان المشكلة من الجانب السوري تتمثل في النظام، فيما المشكلة من جانب الأردن لم تكن النظام وإنما المدنيين الذين كانوا يدعمون الفلسطينيين. كما ان خطة العمل التي اقترحها على الحكومة الإسرائيلية لم تكن قائمة على أساس إلحاق خسائر في صفوف الجيش الأردني، بل تحذير السكان المدنيين كي لا يتعاونوا مع العناصر الفلسطينية. الأضرار التي تسبب فيها الهجوم الإسرائيلي تجاوزت كثيرا التقديرات التي اقترحها رابين على الحكومة، بل انه أقر في وقت لاحق بأن لدى ليفي اشكول سببا وجيها للشعور بالغضب تجاهه، إذ قال رابين في هذا السياق: «لم تكن لدينا أسباب سياسية أو عسكرية لإثارة مواجهة مع الأردن أو لإذلال الملك حسين»(2).
كان ليفي اشكول في واقع الأمر يشعر بغضب بالغ تجاه رابين بسبب نزيف الدم والدمار الذي حدث. وشعر بأن كبار ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية قد قدموا للحكومة نصائح سيئة، وأن سورية كان من المفترض أن تكون هي الهدف، وليس الأردن. وكانت النتيجة، على حد تعبير ليفي اشكول هي ان «اسرائيل وجهت ضربة للزوجة بدلا من الحماة الشريرة». كانت هناك مسألة مبدئية أيضا، وهي ان ديفيد بن غوريون عندما كان رئيسا للحكومة نادرا ما دعا إلى مساءلة قوات الدفاع الإسرائيلية عن أفعالها. يضاف إلى ذلك ان اشكول أيضا جمع بين رئاسة الحكومة وحقيبة الدفاع، لكنه كان مصمما على التأكيد على سيطرة المدنيين على الجيش. وقد أشارت مريم اشكول، زوجة رئيس الوزراء، في يومياتها إلى المرارة التي كان يشعر بها زوجها تجاه قادة قوات الدفاع الإسرائيلية في ذلك الوقت. وجاء في يوميات مريم اشكول ان زوجها عقب الهجوم على السموع قال لها: «اكتبي في يومياتك انني، على خلاف سلفي، لست ممثلا للجيش في الحكومة»(3). السبب الرئيسي لغضب اشكول تجاه الهجوم على السموع يكمن في انه جاء معاكسا لسياسته القائمة على أساس دعم الملك حسين ومساعدته في جهوده ضد المنظمات الفلسطينية. نظر الملك حسين إلى الهجوم على قرية السموع كونه عملا حربيا أكثر منه هجوما روتينيا للرد على هجوم سابق. وفسر ما حدث على اعتبار انه مؤشر على ان اسرائيل لم تعد ملتزمة ببقاء واستمرار نظامه وان الإسرائيليين يضعون الضفة الغربية لمملكته نصب أعينهم. بالنسبة للملك حسين، لم يكن الهجوم على السموع حادثة منفصلة، بل جزءا من مخطط إسرائيلي واسع لتصعيد النزاع على الحدود إلى حرب توسعية واسعة النطاق. اما زئيف بار ـ لافي، الذي كان يعمل في القسم الخاص بالأردن في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والذي كان يحتفل بعيد ميلاد الملك حسين، فقد كتب التقييم التالي للعواقب المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على السموع: «مسألة السموع أثارت قلقا بالغا لدى الملك حسين. فقد نظر إلى الهجوم كونه نية من جانب اسرائيل لتمهيد الطريق لغزو الضفة الغربية ومحاولة تهدف لتطويق خط الدفاع الأردني من اتجاه الجنوب. كل المحاولات لتهدئته من جانب القوى الغربية باءت بالفشل. الملك حسين لم يشعر بالارتياح، واستمر خوفه من ان اليهود سينتزعون من الأردن ثمن الهجمات السورية وعمليات المخربين. لماذا يقنع اليهود أنفسهم بتدمير بضعة ألوية سورية غير ذات اهمية؟ لا، اليهود سيتجهون صوب شيء ملموس، مثل غزو الضفة الغربية في أي لحظة يجدون فيها مبررا»(4).
وصفي التل كان من جانبه أيضا على قناعة بأن اسرائيل كانت بصدد جر الأردن إلى رد فعل يدفع اسرائيل إلى خوض حرب. باختصار، كان كل من وصفي التل والملك حسين يشك في ان اسرائيل كانت بصدد نصب فخ للأردن، وكانا حذرين من الوقوع فيه. وبدلا من الرد على الهجوم الإسرائيلي آثرا إحالة المسألة إلى مجلس الأمن. الهجوم على السموع وفشل الملك حسين في الرد عليه بقوة أثارا عداء فلسطينيا كبيرا تجاهه وصب ما حدث في مصلحة أعدائه. وهكذا، فإن الهجوم على السموع وسّع من الشقة الموجودة أصلا بين النظام الأردني والفلسطينيين في الأردن. واتُهم النظام الأردني وقتها داخليا وعربيا بإهمال دفاعات الأردن والفشل في حماية سكان قرية السموع من العدو. منظمة التحرير الفلسطينية وسورية ومصر أججت من جانبها العداء الشعبي تجاه النظام الأردني من خلال شن هجوم دعائي شرس كان معظمه موجها ضد الملك حسين شخصيا، وانفجر الإحباط المكبوت فجأة وأشعل احتجاجات غاضبة وعنيفة، واندلعت مظاهرات في مخيمات اللاجئين في مدن الضفة الغربية. كما اندلعت أعمال شغب خطيرة في كل من الخليل وأريحا والقدس ورام الله ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية، وسار المتظاهرون في الشوارع يحملون لافتات عليها شعارات قومية ويرددون شعارات مؤيدة لجمال عبد الناصر وبانتهاء الملك حسين إلى مصير نوري السعيد. استهدف المتظاهرون المكاتب الحكومية وسيارات الشرطة، واستدعي الجيش وصدرت له تعليمات باستخدام إجراءات مشددة لإخماد أعمال الشغب فرضت بموجبها حالة حظر التجول، كما جرت حملات اعتقالات جماعية واستخدم الغاز المسيل للدموع وأطلق الرصاص الحي على التجمعات. على الرغم من هذه الإجراءات المشددة لم تستطع قوات الجيش استعادة الأمن والنظام إلا بعد حوالي اسبوعين. ولكن ثمة ملمحا جديدا ظهر في تلك الأزمة، ألا وهو المشاركة النشطة لقادة وعُمد الضفة الغربية في الاحتجاجات المناوئة للنظام الأردني. بعض هؤلاء الأعيان طرحوا أنفسهم كـ«قيادة وطنية» وطالبوا بعقد «اجتماع شعبي لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالوطن»، وصاغوا «مانفستو وطنيا» نادى بوجود للجيوش العربية فوق الأراضي الاردنية وأيد منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد لإرادة الشعب الفلسطيني، إلا أن المانفستو لم يتضمن تأكيدا على إعلان فلسطيني من جانب واحد لاستقلال الضفة الغربية، لكنه شكّل تحديا للنظام الهاشمي لم يستطع النظام الأردني التغاضي عنه.
الهجوم الإسرائيلي على قرية السموع، كما هو واضح من ردود الفعل العنيفة على الصعيد الداخلي، كان بمثابة نقطة تحول في العلاقات بين المملكة الهاشمية وفلسطينيي الضفة الغربية، وشكّل على حد وصف الخبير الإسرائيلي موشي شيميش نقطة تحول في «موقف الأردن تجاه اسرائيل، من حالة تعايش خاضع للحراسة إلى حالة إحباط وتشاؤم». وكتب شيميش ان التفكير الذي كان سائدا ومسيطرا على المستويين العسكري والمدني في الأردن هو أن: «خطة اسرائيل الرئيسية كانت ترمي إلى غزو الضفة الغربية، وان اسرائيل كانت تعمل جاهدة لاستدراج الدول العربية كافة إلى حرب عامة تستطيع اسرائيل من خلالها الاستيلاء على الضفة الغربية. وطبقا لهذا التفكير، وعلى ضوء الضعف العسكري الأردني والتردد العربي، كانت تعتقد اسرائيل انها لن تواجه مشكلة تُذكر في الاستيلاء على الضفة الغربية. أقلقت هذه المخاوف الأردنيين عقب الهجوم الإسرائيلي على قرية السموع إلى حد بالغ على نحو يستدعي اعتبارها عاملا أساسيا في قرار الملك حسين بالمشاركة في حرب الأيام الستة. فقد كان مقتنعا بأن اسرائيل ستحتل الضفة الغربية إذا شارك الأردن في الحرب أو لم يشارك.
القلق الذي شعر به القادة الإسرائيليون عقب الهجوم على قرية السموع تركز في احتمال انهيار نظام الملك حسين ونقل قوات من الدول العربية إلى الأردن. وأرسل د. ياكوف هيرزوغ على وجه السرعة إلى لندن لمعالجة جزء على الأقل من الأضرار التي لحقت بالعلاقات مع الأردن نتيجة هجوم السموع. عقد اجتماع مع الملك حسين كان امرا مستبعدا، لذا فقد صاغ هيرزوغ خطابا الى الدكتور ايمانويل هيربيرت لإرساله بدوره إلى صديقه الملك حسين. وعلى الرغم من ان هيربيرت كان يشعر بغضب بالغ تجاه أصدقائه الإسرائيليين، إلا انه آثر إرسال الخطاب إلى الملك حسين لكي ينقذ ما وصفه هيرزوغ بـ«مشروع أساسي في السياسة الخارجية الإسرائيلية». عبّر الخطاب عن أسف بالغ تجاه الخسائر في الأرواح وأكد للملك حسين استنادا على «معلومات موثوقة للغاية من أعلى سلطة» ان لا تغيير أيا كان في السياسة الأساسية. ووصف الخطاب الهجوم كونه «خطأ بالغ الفداحة»، لكنه أشار أيضا إلى الاستفزاز الذي تعرضت له اسرائيل من «جانب عصابات الإرهابيين»، واختتم الخطاب بمناشدة الطرفين ببذل جهد في سبيل تخفيف التوتر، مثلما فعلا في السابق. ولم يتلق هيربيرت ردا على ذلك الخطاب، وقال ان أصدقاء الملك حسين الذين جاءوا لمقابلته عقب الهجوم تحدثوا حول اسرائيل بأسلوب مختلف وطريقة عدائية للغاية.
جرت عدة مناقشات في ديسمبر (كانون الأول) 1966 في القدس حول السياسة تجاه الأردن بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والاستخبارات العسكرية والموساد. كان ثمة إجماع عام على ان النظام الأردني قد عبّر عن تصميمه على البقاء والاستمرار خلال السنوات الـ18 السابقة لكنه ظل يفتقر تماما إلى أي فرصة للاستمرار على المدى الطويل، وتركز السؤال حينها على كيف كان استمرار النظام الأردني عاملا حاسما بالنسبة لدولة اسرائيل. برز موقفان تجاه هذه القضية، فقد كان هناك من يرى ان وجود الملك حسين يمثل مشكلة لأن وجود الضفة الغربية بصورتها تلك كان يشكل كارثة على اسرائيل وان الملك حسين يشكل عقبة في طريق التغيير. اما الرأي الآخر، فقد كان مخالفا تماما، ذلك ان أصحاب هذا الرأي كانوا يعتقدون ان الوضع المناسب هو ان يعمل الملك حسين على تعزيز الوضع الراهن حينها، وكانوا يتطلعون إلى تعايش معه، فيما وُصف موقف قوات الدفاع الإسرائيلية بأنه وسط بين الموقفين.
لم يكن مستغربا ارتباك الملك حسين تجاه الموقف الإسرائيلي في ظل تلك المواقف المتباينة. ويمكن القول ان عدم الثقة في اسرائيل دفع الملك الحسين باتجاه الولايات المتحدة، علماً بأن إدارة الرئيس جونسون كانت قد وبخت إسرائيل بحدة بسبب هجوم السموع وصوتت في مجلس الأمن لصالح قرار يدين الهجوم. وتلقى الملك حسين مساندة قوية من فيندلي بيرنز، السفير الأميركي في عمان، ومن جاك اوكونيل، مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في عمان خلال الفترة 1967ـ1971. وكان بيرنز يشك في ان مصر وسورية وإسرائيل لم تكن تشعر بقلق إزاء اندلاع حرب عربية ـ إسرائيلية قصيرة تنتهي بانهيار الأردن. كانت تربط الملك حسين علاقة وثيقة مع جاك اوكونيل أكثر من أي مسؤول أميركي آخر قبله أو بعده، وكانت علاقتهما قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المطلقة. حصل اوكونيل على الماجستير في القانون الإسلامي من جامعة البنجاب، وعاد بعد ذلك إلى جامعة جورجتاون ليحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي. وخلال أزمة عام 1958 اُرسل اوكونيل لتعزيز فريق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الأردن، وكانت تلك هي الفترة التي توثقت علاقته خلالها مع الملك حسين.
ونتيجة للثقة والاحترام بين الملك حسين وأوكونيل استمرت علاقة العمل بينهما في انسجام وفعالية. اوكونيل من جانبه قدم مساعدات هائلة للملك حسين ومملكته، واستمرت العلاقة بينهما حتى عقب تقاعد اوكونيل من العمل في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1971 ليلتحق بعد ذلك بالعمل في شركة للمحاماة في واشنطن، وأصبح فيما بعد محامي الأسرة الهاشمية ومستشارا ومحاميا للحكومة الاردنية. اقتنع الرئيس الأميركي ليندون جونسون من جانب مستشاريه بالحاجة إلى دعم الأردن. ففي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 بعث جونسون خطابا خاصا إلى الملك حسين استهله بـ«كلمات التعاطف لا تساوي كثيرا عندما تزهق أرواح من دون مبرر». تضمن خطاب جونسون إلى الملك حسين نقطتين أولاهما طمأنته للملك حسين بأن الإدارة الأميركية لا تزال لها مصلحة في أمن وسلامة الأردن وصالح شعبه. ثانيا، عقب علمه من بيرنز بمخاوف الملك حسين تجاه اسرائيل، أراد جونسون طمأنة العاهل الأردني بأن سياسات اسرائيل لم تتغير وأن اسرائيل لا تعتزم احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن.
فمعارضة الولايات المتحدة لاستخدام القوة بغرض تعديل الحدود في الشرق الأدنى كانت واضحة تماما لدى اسرائيل بصورة مباشرة وفي التصريحات الرسمية، وكان الرئيس جونسون على قناعة بأنها مفهومة تماما لدى الجانب الإسرائيلي. كان خطاب جونسون مهما فيما يتعلق بوعده بمعارضة أي محاولة من جانب اسرائيل لتغيير الحدود على حساب الأردن، لكنه لم يبدد مخاوف الملك حسين، الذي وجه الدعوة إلى كل من اوكونيل وبيرنز في 10 ديسمبر من ذلك العام. ويقول بيرنز انه في تلك المناسبة رأى الملك حسين لأول مرة عابسا وتبدو عليه آثار الضغوط واضحة. وقال أيضا انه كان واضحا ان الملك حسين كان يحاول ما بوسعه للسيطرة على مشاعره من الانفجار علنا.
قال الملك حسين لضيفيه إنه على الرغم من ان حدة المظاهرات قد تراجعت، فإن ضغوطا كانت تعتمل بصورة متزايدة، على حد قوله. وقال أيضا ان الشقة المتزايدة بين الضفة الغربية والشرقية قد دمرت أحلامه، وقال أيضا لضيفيه أيضا ان الشيء الوحيد الذين كان يربط بينه والجيش هو الولاء التقليدي، إلا ان هذا الولاء، كما قال، بات في حالة تراجع مؤكدا ان «هناك حالة أقرب إلى اليأس في أوساط الجيش». شكا الملك حسين أيضا من انه محاصر بالأعداء من كل الجهات، خارج الأردن وداخلها. فسورية كانت تنادي علنا بإطاحته وتسهّل تسلل الإرهابيين إلى سورية وتزودهم بالسلاح لتحقيق هذا الهدف، واختتم الملك حسين حديثه مؤكدا على ضرورة اتخاذ واشنطن قرارا بشأن طلبه للمساعدة.
فقد كانت تربطه وواشنطن على مدى عقد من الزمن علاقة شراكة، وكانت واشنطن في تلك الظروف الحرجة الصديق الوحيد الذي يمكنه اللجوء إليه، وكانت الاستجابة المناسبة، في نظره، ستمكنه، كما قال، من تبرير سياسته السابقة لجيشه ولشعبه ولمنظمة التحرير الفلسطينية وللجميع. وقال في ختام حديثه مع أوكونيل وبيرنز ان التأخير المتكرر من جانب الولايات المتحدة في هذا الشأن لم يترك له خيارا سوى الموافقة على قرار مجلس الدفاع العربي في القاهرة بإرسال قوات سعودية وعراقية إلى الأردن. إذا رفضت الولايات المتحدة طلب الملك حسين المساعدة، فإن هناك ثلاثة خيارات مفتوحة أمامه، حسب قوله. فإما الاستعداد لكارثة وشيكة، أو مواجهة كل أعدائه أو إعلان الضفة الغربية منطقة عسكرية ومناشدة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية إرسال قوات لحمايتها. وبدا له الخيار الثالث هو الوحيد الذي سيمكّنه من تحصين الضفة الشرقية وتوفير فرصة أخيرة له لخدمة قضيته.
* غداً: عندما كشف الملك حسين للأميركيين اتصالاته السرية مع الإسرائيليين