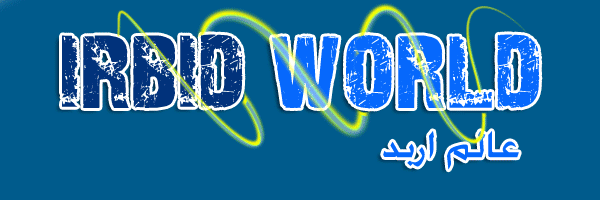هل نحن شعب قليل الأخلاق؟
د. معتز بالله عبد الفتاح
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الوفد، 3 يوليو 2007
هذا سؤال شديد العمومية، والعام عادة ما يستدعي إجابات سريعة سطحية وعادة ما تكون مريحة لكنها مضللة. وأنا سأحاول أن أتجنب مثل هذه النوعية من الإجابات.
الأًصل في الأمور أن الأخلاق هي مجموعة من المباديء والقيم التي يلتزم بها صاحبها بغض النظر عن العائد المادي أو المعنوي المرتبط بها. بل إن قمة التزام الإنسان بالأخلاق يتجلى في أن يلتزم المبدأ حتى وإن تعارض مع المصلحة. وأهم هذه الأخلاق هي الصدق، والوفاء بالوعد، والحرص على الصالح العام، والاتقان في العمل وغيرها. فيتقن ذو الخلق عمله، سواء كان صاحب العمل حاضرا أم غائبا.
وللفلاسفة اسهامات جمة في تحديد مصادر الإلزام الخلقي. وقد أجملوها في مصادر أربعة أساسية. أولا العقل، فعقل الإنسان يجعله يفكر في أنه من مصلحته المباشرة أن يلتزم بالمباديء التي لو خالفها، فسيخالفها الآخرون حتى لا يقع فريسة لبطش من هو أقوى منه. وبالتالي أنا لا أركن سيارتي أمام مدخل البيت الذي بجواري لأنني لو فعلت ذلك فقد أعطيت فرصة لغيري أن يركن سيارته أمام مدخل بيتي. وهكذا لو رفعت صوت الموسيقى من بيتي، فهذه رخصة للآخرين بأن يفعلوا المثل، ولما ارتاح مريض قط. ورائد هذه المدرسة بامتياز في الفكر الغربي كانط وقد سبقه في الفكر العربي ابن رشد وابن سينا.
وهناك مدرسة أخرى ترى أن المصدر الرئيسي للإلزام الخلقي هو المجتمع. فحينما يتراضى مجتمع ما على مجموعة من القيم والمباديء فإنها تصبح أخلاقه وبمثابة الهواء الذي يتنفسه، فلماذا لا أذهب إلى الجامعة بلباس النوم الرجالي رغما عن أنه يستر كامل العورة؟ لأن المجتمع تراضي على أن ملابس النوم للمنزل وليست للعمل. وهكذا، فحينما يسري في مجتمع ما ثقافة ختان الإناث مثلا فإن المجتمع يجعل من هذه العادة خلقا من يحيد عنه فقد أخطأ.
ويرى أنصار هذه المدرسة أن قوة المجتمع أقوى من قوة العقل كمصدر للإلزام الخلقي إلا إذا كانت هناك قوة تملك أن تحول العقل وما يمليه إلى قوانين مكتوبة ونافذة في المجتمع. وعليه فإن قال المجتمع بعادة ختان الإناث فإن العقل، مترجما في قوانين الدولة وحسن إدارتها لأدواتها، يقف للمجتمع رادعا ومقوما. ومن هنا جاءت مقولة "الحاكم المستنير". فاستنارته لا تفهم إلا في ضوء أنه لا يعتبر نفسه أسير المجتمع الذي يحكمه، وإنما هو مصلح له مستخدما سلاح العقل وأدوات الإكراه المشروع التي تملكها الدولة. وهو ما جعل فريدريك الثاني في روسيا، وجوروج واشنطن في الولايات المتحدة، ومحمد بن طولون ومحمد علي في مصر أقوى من المجتمعات التي عاشوا فيه وكانوا إضافة لها حين غيروها.
بيد أن يحي حقي أشار في روايته العبقرية "قنديل أم هاشم" لقصة الدكتور إسماعيل الذي ذهب إلى الغرب ليتعلم فنون طب العيون وعادة إلى بيئته التي اعتادت على علاج أمراض العيون بزيت القنديل، قنديل أم هاشم، تبركا وأملا في الشفاء. وهنا كان الصراع بين مصدرين من مصادر الإلزم الخلقي: العقل ممثلا في العلم، والمجتمع متمثلا في الخرافة. وقد اصطدم العلم بالخرافة، وكاد الدكتور إسماعيل يفقد حياته ظنا من العامة أنه خرج عن الدين لرفضه استخدام زيت القنديل. لكن العالم الحق حكيم يعرف أن من واجبات العلم أن يستوعب الخرافة ليقضي عليها. وقد فعلها بطل "قنديل أم هاشم" بأن وضع العلاج الطبي السليم في زجاجات تشبه الزجاجات التي كان يضع فيها المخرفون زيت القنديل وأوهم الناس، أو هكذا فعل، أنه يعالجهم بزيت القنديل. وحينما اطمئن الناس له، وللعلم الذي أتى به وللعقل الذي يمثله، كان عليه أن يصارحهم بأن علاجه الموضوع في زجاجة الزيت ما هو إلا نتاج العلم والطب والعقل، وهكذا فإن للعلم بيئته التي تحترم العقل ابتداء، فمحاولة استخدام العلم في علاج مشاكل مجتمع لا يحترم العلم، هي محاولة غير علمية بل وغير عقلانية في حد ذاتها.
إذن فالعقل كمصدر للإلزام الخلقي ينبغي أن يقود المجتمع، لكنه لن يفعل إلا إذا حكم وساد وسيطر على أجهزة الدولة والمجتمع معا حتى يواجه قرونا من الخرافة والغيبيات اللاإيمانية.
وقد لاحظت خللا بنفسي مع طلابي في الجامعة حين أرى فيهم اتكالية ابتدعوها ونسبوها ظلما للإسلام. وقد كانت قضية "القوة التدميرية للحسد" مناطا للنقاش مع بعضهم. فتساءلت: هل من الممكن أن أنظر إلى مبنى شاهق نظرة حسد فيتحول إلى كومة من التراب؟ وهل يمكن أن نرسل إلى إسرائيل 100 حاسدة فيدمروها بنظرات العين وكلمات اللسان؟ ولو كان هذا الاختراع مقبولا، فلماذا لم يكتشفه غيرنا من أبناء الحضارات الأخرى؟ الحسد موجود ونؤمن به كمرض من أمراض القلوب، كما نص القرآن الكريم، أما إذا لم يتبعه صاحبه بكيد وفعل يحول الشعور الذاتي إلى طاقة تدمر الآخرين فلا قدرة له على التدمير أو النيل منهم، وإنما يظل شعورا يأكل صاحبه، حتى وإن ساد في ثقافة المجتمع ما يشير إلى غير ذلك. فيضع صاحب السيارة الجديدة خرزة زرقاء أو صندل قديم كي "يأخذ العين".
وهناك مصدر ثالث للإلزام الخلقي وهو ما يسميه البعض بالحاسة الخلقية أو الضمير. وهو أقرب إلى آية من آيات الله في خلقه، فيجعل لديهم شعورا بعدم الارتياح لفعل ما. كما جاء في الحديث الشريف: "الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس." وهو ما جعل شيخنا الشعراوي يقول في تفسيره للحديث الشريف "الحلال بين والحرام بين" أن القطة إذا أعطيتها قطعة لحم فإنها تقف بجوارك لتأكلها في شموخ صاحب الحق، أما إذا سرقت منك هذه القطعة من اللحم فإنها تجري مسرعة لتختبيء شعورا منها بأنها ارتكبت فعلا لا أخلاقيا. وهذا ما يقوله أنصار هذه المدرسة مثل باتلر وشافتسبراي والكثير من الصوفية بأن الأصل في الأمور "النفس المطمئنة."
أما المصدر الرابع من مصادر الإلزام الخلقي فهو الدين، أي دين. فالدين يرسم لأتباعه خريطة من الفروض والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات ويجعل في المحرمات ما هو من الصغائر وما هو من الكبائر، ويجعل من الفروض ما هو ضروري على كل فرد من أفراد المجتمع (فرض عين مثل الصلاة) أو فرض كفاية يقوم به البعض دون البعض الآخر (مثل التخصص في مجال معين من مجالات العلم).
والدين، سواء كان أرضيا أو سماويا، له تأثير كبير على المؤمنين به. ويكفي أن ننظر إلى المعاناة الشديدة التي يعانيها الحاج سفرا وسعيا وطوافا ومبيتا ابتغاء مرضاة ربه الأعلى الذي وعده أنه سوف يرضى. ويروى التاريخ تفاصيل تحول العديد من الشخصيات العظيمة من الكفر إلى الإيمان. فما الذي دفع عمر بن الخطاب أن يتحول من معاقر للخمر يحبها ويدمنها إلى رجل "كأنه يرى الله بعينيه" كما وصفته إمرأة تقدم لخطبتها فرفضته؟ بيد أن الدين في ذاته احتاج دائما للسلطان القاهر بجواره حتى يردع من لا يبلغ الإيمان منهم مبلغ اليقين. وعليه قال أبو حامد الغزالي: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" أي إن الله يردع بالقانون من لا يقبل أن يردع بالخوف من الله.
والأصل في الأمور أن تتضافر مصادر الإلزام الخلقي حتى تكون الرسائل الاتصالية القادمة من الدولة ومن دور العبادة ومن الأسرة ومن أجهزة الإعلام متسقة تحمل نفس القيم، فتتحول اللوائح والقوانين إلى قيم وعادات يتقبلها الناس ويعيشون عليها وهو ما لمسته مثلا حين زرت اليابان زيارة خاطفة تبين لي فيها أن الثقافة والقانون والدين يقفون جنبا إلى جنب لإعلاء قيم العمل والاتقان واحترام خصوصية الآخرين والحرص على الصالح العام.
أما في مصر، فلقد فقد المجتمع بوصلته على نحو يجعلني أتأمل من وما الذي يحدد للإنسان المصري الخير والشر، الحلال والحرام، المقبول والمرفوض، الصلاح والفساد. هل فقدت مصادر الإلزام الخلقي الأربعة قدرتها على التأثير في حفيد الفراعنة الذي كان يعتقد أجداده أنهم محاسبون على كل ما يفعلون بما في ذلك تلويث النيل وعقوق الوالدين وما ينطق به اللسان؟
كيف لي أن أقنع الناس بالتزام القوانين واللوائح في حين أن القائمين عليها أنفسهم يستخدمونها لتحقيق مآربهم الشخصية؟
كيف لي أن أقدم على فعل الخير وبيئي الصغيرة تحذرني من أن فعل الخير في كثير من الأحيان ما هو إلا مقدمة لخدعة أو عملية نصب يقوم بها شخص ما ضدي؟
كيف لنا أن نعتمد على الدين وحده في بناء الشخصية المصرية من جديد في الوقت الذي نتمسك فيه بالشكليات ولا يبدو لنا ديننا رادعا عن الكثير من الموبقات؟ إننا كمصرين ندفع مليارات الجنيهات في تكرار الحج والعمرة ولا نعيد توجيه أولوياتنا لبناء المدارس والجامعات والتي هي لا شك فريضة أكثر من نافلة تكرار الحج والعمرة.
لقد أكثرت في الحديث النظري، وسأختم بواقعتين أثارتا عندي كل ما قلته سلفا.
الواقعة الأولى ترتبط بأسرة أمريكية من أصل مصري، التقينا على نيل القاهرة حيث كان يقوم البعض من الأسر المحيطة بصيد الأسماك من النهر الخالد، وكان عائد الصيد أسماكا متناهية في الصغر. فعلقت الصديقة بأنه من غير المنطقي أن يحتفظ الشخص بسمكة لا تزيد عن عقلة الأصبع وأن عليه أن يرمي السمكة في النهر حتى تكبر وساعتها ستكون الاستفادة أكبر لمن يصيدها بعد شهرين أو أكثر (وكما هو واضح هي تتلمس العقل كمصدر من مصادر الإلزام الخلقي). وروت لنا عن أن حفيدها الذي ولد ويعيش في أمريكا قد نجح لأول مرة في حياته في أن يصطاد سمكة كبيرة نسبيا. وحينما سألوه تليفونيا عن طعمها فكانت إجابته أنه ألقاها في البحيرة مرة أخرى لأنها كانت أقل ببوصة عن الطول المسموح به للسمكة كما هو مكتوب على لوائح الصيد في البحيرة (هو هنا التزم بمعايير المجتمع في الإلزام الخلقي). وكان تعليق صديقتنا أنه كان من الممكن له أن يحتفظ بها لأن بوصة واحدة ما كانت لتضير أحدا في شيء، ولكنها تراجعت وقالت لكن الأفضل أنه فعل ما فعل حتى يتربى داخله الوازع الشخصي لاحترام القانون واحترام حقوق الآخرين (هنا هي تلتزم بالحاسة الخلقية أو الضمير كمصدر من مصادر الإلزام الخلقي). وكان تعليقنا أن أسرة صديقي خسرت سمكة، وكسبت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنا صالحا (فهنا تضافرت ثلاثة من مصادر الإلزام الخلقي في إنتاج موقف أخلاقي بامتياز).
ولم يكن الأمر بعيدا عن ابني الذي يشجع النادي الأهلي. وقد وجدته سعيدا للغاية لأن الأهلى فاز على الهلال السوداني ويتحاكى بالأداء الرائع للاعبه فيلافيو الذي نجح في أن يخدع الحكم حتى أنه وصفه بأنه (cheating) أي مخادع أو غشاش. لكن المهم من وجهة نظر إبني أنه كان من المهارة بحيث إنه ارتكب خطأ ترتب عليه هدف دون أن يدري الحكم، والمهم أن الأهلى فاز (هذا موقف يجعل السعادة مساوية للذة أو المصلحة الشخصية وهذا ليس موقفا أخلاقيا بالمرة). وقد نزل كلام ابني على نفسي كالصاعقة، وقلت لا، ليس في البيت. حتى وإن أصاب أهل مصر العوار، وفقدوا البوصلة، بوصلة الأخلاق، فأنا مسؤول عما يقع في دائرة تأثيري، حتى وإن لم أكن أملك الكثير لأغير ما يقع في حدود دائرة اهتمامي.
فاستدعيته وأخته كي نضع الأمور في نصابها. فحتى وإن فاز الأهلي، وهو ما نريده لفريق مصري، فقد أخطأ اللاعب. فلابد أن يظل الخطأ خطأ حتى لو فعله البعض لمصلحتنا، ولابد أن يظل الصواب صوابا حتى لو لم نفعله (أنا هنا أزرع فيه الحاسة الخلقية). لأن من يخطأ ولا يعاقب، فنحن بهذا نهدم قيمة من قيم الأخلاق. ومن يجيد ولا يكافأ، فنحن بهذا نهدم قيمة من قيم الأخلاق. ورويت له بعض الآيات التي تحضنا على أن نكون عادلين حتى لو كان ضد مصلحتنا أو ضد مصلحة ذوي القربي (أزرع فيه الوازع الديني) وأعتقد أنه قد تعلم أن العدل أهم من فوز الفريق هذا أو ذاك، وإلا خسر هو مباشرة بأن يتقدم عليه في مدرسته من هو أكثر منه مهارة في الغش والخداع (وهنا أنا أزرع فيه العقل كمصدر من مصادر الإلزام الخلقي). وما قبل ابني أن يكون فريسة للمخادعين أو أن يروج لهم. وربما خسر النادي الأهلي مشجعا متعصبا، لكن ربما كسبت مصر مواطنا يلتزم الأخلاق.
آسف للإطالة، ولكنها بعض خواطر قد تفيد شخصا ما في مكان ما لإعادة وضع الأمور في نصابها، والله المستعان.